مقامات أمريكية | عن هويات الأكثرية والأقليات
حل مشكلة ما لا يحصل بتجاهلها، لكن بالاعتراف بها، مما يعني التعامل معها كما يفكر بها أصحابها، وليس كما نحب أن نفكر فيها ونتعامل معها
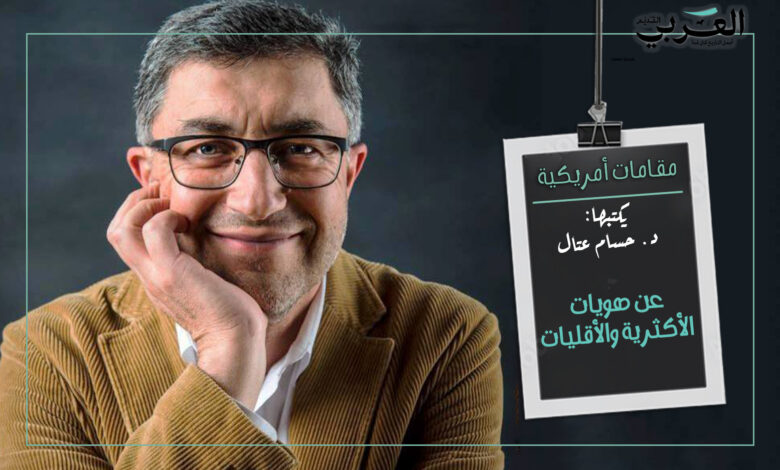
د. حسام عتال
عندما هاجرت لأمريكا منذ ٣٤ سنة، فوجئت بطريقة تقديم الإعلام هنا للأخبار:
” شرطي أبيض يضرب رجلاً أسود حتى فقدان الوعي.”
“مخبز يملكه مسيحي أصولي يرفض صنع قالب كاتو لعرس امرأتين سحاقيتين.”
“عصابة مخدرات پورتوريكوية تقتل أربع عناصر من عصابة سوداء.”
ما هذا الهراء؟ كشخص أتى من سوريا حيث ذِكرُ لون أو عرق أو دين الشخص الآخر يعد أمراً ممنوعاً ومذموماً، وَجَدتُ طريقة عرض الأخبار بهذه الصراحة المباشرة مشيناً، بل تحريضياً. كنت أفكر: ألا يخشى هؤلاء تأجيج النعرات العنصرية أو الدينية بين مجموعات الناس المختلفة، كيف لهم أن يكتبوا بهذه الطريقة العلنية؟
وكنت أردد، بفخر، التي كان يرددها كل سوري: نحن السوريين لا نهتم بدين الشخص أو عرقه أو إثنيته، حتى جارنا لا ندري إن كان مسيحياً أو مسلماً، نحن ننتمي لوطن واحد بالتساوي وليس هناك من فروق بيننا، أو غير ذلك من الكليشيهات.
مع الوقت بدأت أدرك أن تسمية أحوال البشر وأطوارهم، كما هي في الواقع، ربما هي ليس أمراً سيئاً بالضرورة. وأن الاعتراف بهويات الناس، كما يفهمونها، وكما يمارسونها، لا يسبب دوماً الضرر الذي كنت قد عُلِّمتُ أن أخشاه.
ثم انقلبت الآية: فعندما بدأت بالعمل، بعد تخرجي، لاحظت المرونة (في الواقع اللطافة الزائدة) التي يعاملني بها طاقم المشفى من عمال وزملاء وإداريين. وكان هناك في القسم الذي كنت أعمل به طبيب زميل أسود من الصومال، فسألته إن كان قد لاحظ نفس الأمر. ضحك وأجابني: “ماذا تظن… أنا نجم هذا القسم، يعاملونني وكأني ملك في هذا المكان.” ثم أردف: “أليس من الرائع أن ينتمي المرء لأقلية في هذا البلد.”

الاعتراف بهويات الناس، كما يفهمونها، وكما يمارسونها، لا يسبب دوماً الضرر (بعدسة كاتب المقال)
أقلية؟ أقلية؟ قلّبت الكلمة في ذهني… بدأت تعطي انطباعاً مختلفاً الآن وأنا على الطرف الآخر من الحبل (كما يقال في أمريكا).
ثم كبر أولادي ودخلوا المدارس، وذات يوم قالت زوجتي بعد عودتها من اجتماع مع المدرسين: “كم هم رائعون في المدرسة، أولادنا مدللون لآخر حد!”.
- مدللون.. ماذا تقصدين؟
- لانهم يعاملونهم بطريقة مختلفة عن بقية الطلاب.
- والسبب؟
- لأنهم عرب ومسلمين.
- وهذا جيد؟
- أعتقد ذلك.
- لا يعجبني ذلك أبداً، أفضل أن يعاملوهم أسوة ببقية الطلاب.
- إذا أذهب وتكلم مع المدرسين والإدارة بنفسك.
وهذا ما حصل… في لقاءنا معهم أعربت عن رأيي، وفوحئت بتمسك الإدارة والأساتذة برأيهم. قالوا أن اختلاف أولادي عن غيرهم أمر واقع وحقيقي، وأن تجاهله سيكون له عواقب أسوأ من التعامل معه بصراحة، ثم دعوني لإلقاء محاضرة للمدرسين والإدارة وأخرى للطلاب لتعريفهم بالثقافة العربية والإسلامية. قبلت على مضض، لكني فوجئت بعد المحاضرات بعمق التفاعل، وكمية الاسئلة، ونوعيتها، والرغبة الصادقة في التعرف والتعلم عني وعن أولادي. دون شك كان هناك بعض الاسئلة النمطية عن وضع المرأة وعن الإرهاب والعنف… الخ، ولكنها كانت فرصة جيدة لنقاش مثمر. أصبحت لهذه المحاضرات شعبية وصرت ألقيها في مدارس أخرى ونواد ثقافية وكنائس وأماكن عمل.
وهكذا تغير موقفي الذي ربيت عليه من الأمر، فأصبحت أدرك أن حل مشكلة ما لا يحصل بتجاهلها، لكن بالاعتراف بها، مما يعني التعامل معها كما يفكر بها أصحابها، وليس كما نحب أن نفكر فيها ونتعامل معها بمثالية لا واقعية.
فإن كان هناك تمييز بين الأبيض والأسود، ينعكس في سلوك الشرطة، فما المانع من ذكر ذلك؟ وكيف يمكن إصلاح هذا الخطأ إن لم نتعرف عليه كما هو أساساً؟
وإذا كان صاحب المخبز يتجاوز حدود القانون بامتناعه عن تقديم الخدمة للسحاقيات، كيف يمكننا مناقشة ثم معالجة هذا الأمر مالم نعلنه على الملأ؟
وإن كان الناس ينظرون لأولادي بأنهم مختلفين، فما الضير في نقاش ذلك علناً؟
ومن الصحيح أن تسمية المشاكل باسمها الواقعي قد يسبب اضطراباً اجتماعياً، وحتى بعض العنف، كما حدث مع حادثة رودني كنغ في لوس أنجلس، أو في حالة جورج فلويد في مينياپوليس. لكن المجتمع القوي المتماسك، الذي يبغي مواجهة مشاكله وحلها بفعالية، يستطيع تجاوز هذه العقبات والخروج منها أقوى عزيمة، وأكثر حكمة، وأقرب للعدل والمساواة، ولو بعد حين.
يحضرني ذلك عندما أقرأ كثيراً من الدعوات على صفحات السوشيال ميديا التي تُدين استخدام عبارة “الأقليات” أو الإشارة إلى مختلف مكونات الشعب السوري الدينية أو الطائفية أو العرقية، مدعية أننا جميعاً سوريون متساوون، وأنه علينا نبذ هذه الأوصاف التي تفرق بيننا. لكننا إن كنا تعلمنا أي شئ من السنوات الماضية فهي أننا طائفيون وعنصريون بامتياز. فعندما يَحِدّ الحَدّ يتقوقع كل منا ضمن قبيلته أو جماعته ويحمل سرديتها فوق كتفيه (إلا ما رحم ربي)، فنهتم بعائلتنا أولاً ثم حارتنا، ثم قبيلتنا، قريتنا أو مدينتنا، و أخيراً بلدنا ووطننا. هذه حقائق رأيناها مرة بعد مرة، والاستثناءات منها لا تبرهن شيئاً سوى في التأكيد على القاعدة.
في الواقع أن الدعوات للإندماج المطلق ونسيان كل صفات أو هوية للإنسان لا تُعرف ولا يُسمع بها إلا في الأنظمة الدكتاتورية الشمولية، في حين تتخذ المجتمعات الديمقراطية المنفتحة خطاً واقعباً في التعامل مع هذه الاختلافات، بالاعتراف أولاً ومحاولة التوفيق ثانياً. في المجتمعات المتقدمة (أو الدول الناجحة إن شئتم) إنه التعاون والتعارف والاختلاط هو الذي يقود عجلة المجتمع، وهذا يأتي مع شد وجذب، واختلاف، وصلح، وخصام، وسجال، وكثير من المساومة، وأحياناً مع بعض العنف المحدود. هذا في المحصلة أفضل من تجاهل مقنع للواقع الذي يعيش به الناس من ترابط وانتماء وهوية.
ضمن هذا الإطار عندما نلقي نظرة، ولو سريعة، على المشهد في سوريا نرى صورة وسريالية (هل أتت صفة السوريالية من اسم سوريا؟ّ)، في نفس الوقت الذي نُدينُ به استعمال كلمات مثل أكثرية أو أقلية:
نرى رجل دين (شيخ) يدعونا لتطبيق نظام علماني، وهو يرفض قطعاً تدخل الحكومة المؤقتة بشؤون أهالي بلدته.
ونرى رجل دين آخر (مطران) يدعم للحكم الوطني وهم يلتقي بانفراد مع وزير خارجية دولة أجنبية.
ونرى “ممثلين” لطائفة يدعون لحماية دولية، فيما هم أنفسهم كانوا منذ أسابيع يرفضون عودة ملايين المهجرين إلى بيوتهم.
ونرى الحكومة المؤقتة تدعو للتلاحم والانسجام وراءها، لكن أفرادها هم من لون واحد ومذهب واحد، ولهم ذقون طولها واحد (عدا القلة من النساء اللواتي كلهن محجبات).
كيف يمكننا التعامل مع هذا الوضع (أو الخروج منه إن شئتم) إن لم نصفه بما هو عليه، وإن لم نسمِه بما هو ظاهر عليه، وإن لم نقبل بأن أفراده وجماعاته تفكر وتتصرف بطريقة معينة؟
نعم إنها أكثرية وأقليات، أديان وطوائف، عرقيات وإثنيات، مرابطين، ومهجرين، ونازحين، رجال، ونساء، وشيوخ، وأطفال. إنها سوريا كما نعرفها، فلنتعامل معها كما هي وليس كما نحبها أن تكون في أحلامنا المثالية.
