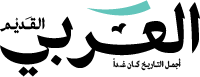دلالات وقضايا | الشَّاعر الوزير وحكايات أخرى
كثير من الشُّعراء والكتَّاب يمتلكون هذا الاستعداد الفطريَّ للتَّحوُّل والتَّقلُّب والتَّبدُّل؛ فَمَهْجُوُّ الأمس عندهم هو ممدوحُ اليوم

د. مهنا بلال الرشيد– العربي القديم
تابعتُ منذ بداية جلسات الحوار الوطنيِّ في الجمهوريَّة العربيَّة السُّوريَّة مطلع العام الجاري 2025 حتَّى هذا اليوم الواقع في العشرين من نيسان-أبريل من العام ذاته مجموعة كبيرة من برامج البودكاست والحوارات مع بعض الشَّخصَّات المهتمَّة بالشَّأن السُّوري أو المنتقاة لتأدية بعض الأدوار؛ انطلاقًا من معيار فصاحة اللِّسان أو رخامة الصَّوت في الخطابة، ووجدتُ لهذه الحال كثيرًا من أمثالها في كلٍّ من التُّراث العربيِّ والأدب العالميِّ أيضًا. وقد خشي كثير من السَّاسة وعلى الدَّوام بعض المفوَّهين، وقرَّبوهم منهم لا حبًّا بهم وإنَّما تجنُّبًا لشرور ألسنتهم، أو ليكون بعضهم أبواقًا لهم بدلًا من أن يكونوا ضدَّهم، وذلك لأنَّ كثيرًا من الشُّعراء والكتَّاب يمتلكون هذا الاستعداد الفطريَّ للتَّحوُّل والتَّقلُّب والتَّبدُّل؛ فَمَهْجُوُّ الأمس عندهم هو ممدوحُ اليوم إن قرَّب هذا أو أبعد ذاك. وقد ساءت هذه التَّحوُّلات والتَّبدُّلات الفيلسوف اليونانيَّ أفلاطون (427-347 ق.م)؛ فنفى الشُّعراء عن مركز مدينته الفاضلة، ذاك المركز الَّذي يشغله الحاكم ومستشاروه من الفلاسفة والمفكِّرين والحكماء، ويحيط بهم رجال الأمن والعسكر والشُّرطة، وبجوارهم يسكن أمهر الحرفيِّين وأحذق الصُّنَّاع وكبار التُّجَّار، وتنتشر طبقات المجتمع الأخرى في أفلاك المدينة ونواحيها الأبعد عن المركز، ويضع أفلاطون الشُّعراء على أطرافها بعيدًا عن المركز أو دائرة صنع القرار فيها؛ لأنَّه يفضِّل حماية المدينة ولغة التَّواصل بين النَّاس من تلاعب الشُّعراء فيها؛ لأنَّها وسيلة الفلاسفة لقول الحقِّ والحقيقة؛ لذلك يجب حمايتها من الحذلقة اللَّفظيَّة، وقد وافق سقراطُ (470-399 ق.م) تلميذه أفلاطونَ في وجهة نظره هذه تجاه الشُّعراء، وأكَّد الشَّاعر الأمريكيُّ المعاصر (بِن ليرنر Ben Lerner) (1979- .م) هذا الرَّأي، ووجد أنَّ المجازات والصُّور والأخيلة في لغة الشِّعر لا يمكنها نقلَ حقيقة العالم.
مأساة الوزير الشَّاعر…
تلخِّص مأساة محمَّد بن عبد الملك الزَّيَّات (789-847.م) قصَّة حياة الوزير الشَّاعر، الَّذي ارتفع شأنه بسبب فصاحة لسانه، وقضى نحبه بسبب سوء تقديره أو بعض مواقفه السِّياسيَّة. وتروي الأخبار أنَّ الكاتب أحمد بن عمَّار البصريِّ كان وزيرًا عند المعتصم (796-842.م) عندما ورده كتاب من أحد عُمَّاله؛ فجاءت لفظة (الكلأ) في الكتاب؛ فسأل المعتصم وزيرَه عن معناها؛ فقال الوزير: لا أعلم، وتوافقت هذه الحادثة مع قدوم ابن الزَّيَّات إلى المجلس؛ فسأله المعتصم: ما الكلأ؟ فقال ابن الزَّيَّات: الكلأ هو العشب على الإطلاق، فإن كان رطبًا فهو الخلا، فإذا يبس فهو الحشيش، وراح يُقسِّم أنواع النَّبات حتَّى أُعجب المعتصم به؛ فاستوزره وأطلق يده. وأقرَّ الواثق (816-847.م) وزيره ابنَ الزَّيَّات على ما كان عليه أيَّام المعتصم؛ لأنَّه لم يجد بين الكُتَّاب ما ييسِّر أمر بيعته بعد موت المعتصم؛ فكتب ابن الزَّيَّات في شأن البيعة، ورضي الواثق كتابته، وقال بعد غضبه القديم عليه، وحِلفتِه ألَّا يستوزره بعد المعتصم: عن اليمين فِدية ومال وعِوض، وليس عن ابن الزَّيَّات عوض. ثمَّ عمل ابن الزَّيَّات على تولية محمَّد بن الواثق من بعده؛ لكنَّ الخلافة آلت إلى المتوكِّل (822-861.م)، الَّذي غضب على ابن الزَّيَّات نتيجة موقفه هذا؛ فقرَّر قتله بالطَّريقة، الَّتي صفَّى بها ابن الزَّيَّات خصومه، فجعل له تنُّورًا دائريًّا، يحوي مسامير حادَّة ومدبَّبة؛ وضعه فيه، وكلَّما قال ابن الزَّيَّات: ارحمني! أجابه كما كان ابن الزَّيَّات يُجيب خصومه، وقال: (الرَّحمة خَوَرُ الطَّبيعة)، وظلَّ ابن الزَّيَّات يتقلَّب في تنُّوره حتَّى مات، فأحرقه المتوكِّل بالتَّنُّور، وحطَّم التَّنُّور بعد ذلك، وصادر أموال ابن الزَّيَّات وحواصله في ضِياعه، وقد بلغت ما يقرب من تسعين ألف دينار، وقد وقفنا على بيتين من جميل شعر ابن الزَّيَّات يدعو فيها العاقل إلى تقدير الأحوال واتِّخاذ المواقف تماشيًا مع مقتضى الحال؛ فقال:
يا من يُمازحني في الهزلِ بالغضبِ فرِّقْ- فديتُكَ- بين الجدِّ واللَّعبِ!
إذا اصطلحنا مُنحنا بالصُّدود فما تنفكُّ من غضبٍ يفضي إلى غضب
وقد قال المثل العربيُّ قبل ابن الزَّيَّات: (لسانك حصانك…إن صنته صانك، وإن خنته خانك)، ومثل هذا قال المثل الشَّعبيُّ: (أسمع كلامك أصدِّقك؛ أشوف أفعالك أستعجب!).
الأعشى يتغنَّى بجود المحلَّق وطبق الكرامة!
أحيانًا لا ترتبط دلالة لفظة الخَطَّابة بالخطيب وخَطابة المنابر بقدر ارتباطها بالخطبة أو طلب المرأة للزَّواج، فقد قام الأعشى (570-629.م) صنَّاجة العرب بدور الخَطَّابة أو بما يشبهه حين قدم إلى مكَّة المكرَّمة، وتسامع النَّاس به، وكان للمحلَّق امرأة عاقلة، تعرف-بشكل أو بآخر-أنَّ بَطْنَ الشَّاعر طريق إلى قلبه في كثير من الأحيان، أو تفهمُ جيِّدًا أنَّك إذا أطعمتَ الفمَ استحت منك العيون؛ فقالت زوجة المحلَّق لزوجها: إنَّ الأعشى قدم إلى مكَّة، وهو رجل مفوَّه مجدود الشِّعر، ما مدح أحدًا إلَّا رفعه، وما هجا أحدًا إلَّا وضعه، وأنت رجلٌ-كما علمت-فقير خامل الذِّكر، ذو بنات، وعندنا لُقحة نعيش بها، فلو سبقتَ النَّاس إليه، فدعوتَه إلى الضِّيافة، ونحرت له، واحتلتَ لك فيما تشتري به شرابًا يتعاطاه؛ لرجوتُ لك حسنَ العاقبة، فسبق إليه المحلَّق؛ فأنزله، ونحر له، ووجد امرأته قد خبزت خبزًا، وأخرجت نحيًا فيه سمن، وجاءت بوطب لبن، فلمَّا أكل الأعشى وأصحابه-وكان في عصبة أو عصابة قيسيَّة-قُدِّم إليه الشَّراب، واُشتوي له من كبد النَّاقة، وأُطعم من أطايبها، فلمَّا جرى فيه الشَّراب، وأخذت منه الكأس مأخذها، سأل الأعشى المحلَّقَ عن حاله وعياله؛ فعُرِف البؤس في كلامه، وذكر بناتَه؛ فقال الأعشى: كُفيتَ أمرهنَّ، وأصبح في عُكاظ يُنشد قصيدته المشهورة:
نفى الذَّمَّ عن آلِ المحلَّقِ جفنةٌ وما بيَ من سُقمٍ وما بي!َ مَعْشَقُ
ورأى المحلَّقُ اجتماعَ النَّاسِ؛ فوقفَ ينصت حتَّى سمعَ قول الأعشى:
نفى الذَّمَّ عن آل المحلَّقِ جفنةٌ كجابية الشَّيخ العراقيِّ تفهَّقُ
ترى القوم فيها شارعين وبينهم مع القومٍ وِلدان من النَّسلِ دَرْدَقُ
لَعمري لقد لاحت عيونٌ كثيرةٌ إلى ضوءِ نارٍ باليَفاع تُحرَّقُ
تُشَبُّ لِمَقْرورَينِ يصطليانها وبات على النَّارِ النَّدى والمحلَّقُ
ترى الجودَ يجري ظاهرًا فوق وجهه كما زانَ متنَ الهندوانيِّ رَونقُ
فما أتمَّ الأعشى هذه القصيدة إلَّا والنَّاس ينسلون إلى المحلَّق يهنِّئونه، والأشراف من كلِّ قبيلة يتسابقون إليه جريًا، يخطبون بناته لمكان شعر الأعشى، ولم تُمسِ منهنَّ واحدة إلَّا في عصمة رجلٍ أفضل من أبيها ألف ضعف! ولهذا ومثله قال نقُّاد الشِّعر العربيِّ القديم: أشعر النَّاس هو الأعشى إذا شرب أو إذا طرب؛ ولذلك سُمِّي صنَّاجة العرب، وقالوا أيضًا: أشعر النَّاس زهير إذا رغب؛ فما بالك بشعر الشَّاعر المعاصر إذا رغب بالملك أو الوزارة، وموقفه إن أكل من طبق هذا، أو شرب من كأس ذاك؟!
العباءات والعطايا والحُلل
تفعل الهِبات والعطايا والعباءات والحُلل فعلَها بكثير من الشُّعراء؛ فتؤجِّج عواطفهم، وتثير انفعالاتهم إلى حدٍّ يفقدون فيه اتِّزانهم؛ لنسترجع موقف أفلاطون من الشُّعراء؛ لأنَّه-وفي السِّياسة-آفة الرَّأي الانفعال والهوى. وقد سأل عمر بن الخطَّاب-رضي الله عنه- (586-644.م) كعبَ بن زهير يومًا (ت: 646.م): ما فعلتِ الحللُ الَّتي كساها هرمُ بن سنان (ت: 608.م) أباك؟ قال كعب: أبلاها الدَّهر؛ فقال عمر: لكنَّ الحلل الَّتي كساها أبوك هرمًا لا يبليها الدَّهر؛ وهذا يدلُّ على خلود الشِّعر وأهمِّيَّة الكلمة والزِّيارة وحضور الوليمة؛ لا سيَّما الكلمة والزِّيارة الَّتي تُعدُّ موقفًا؛ فإنَّها تخلد إلى ما بعد الوليمة بزمن بعيد وإلى ما بعد عُمر الحلَّة أو العباءة بدهر طويل؛ ولهذا ولمثله يؤخذ على القاضي قبول الهديَّة، ويؤخذ على الوزير قبول الدَّعوة إلى الوليمة، وإن كانت وليمة الأشراف؛ فما بالك بحضور ولائم التَّشبيح المجموعة من سُحت الأموال؟!
أميل في نهاية هذا المقال إلى موقف أفلاطون من الشُّعراء؛ لأنَّ اتِّزان السِّياسة وانفعالات العواطف الشِّعريَّة ضدَّان لا يجتمعان، وقد يكون كعب بن زهير ورث موهبته الشِّعريَّة عن أبيه زهير بن أبي سلمى (520-609.م)، وبرغم أهمِّيَّة الموهبة الشِّعريَّة وحسناتها فإنَّ ما يرافقها من خيالات مجنَّحة وتقلُّبات الانفعال تدفع إلى تنحية الشُّعراء والكُتَّاب عن مجال السِّياسة بكلِّ رفق ولين، ودون اللُّجوء إلى الطِّريقة الَّتي نُحِّي فيها محمَّد بن عبد الملك الزَّيَّات، وقد يصلح الشَّاعر أو الكاتب لاستشارته في قضيَّة أدبيَّة أو قصيدة شعريَّة، وربَّما يأخذ السَّاسة بعكس المشورة ذاتها، ومن يصلح للشِّعر والخطابة وتبدُّلات الأخيلة وتحوُّلت الانفعالات قد لا يصلح لاتِّخاذ المواقف السَّديدة في اللَّحظات الحاسمة؛ وتروي الأخبار أنَّ كعب بن زهير قال بعدما سمع بخبر إسلام أخيه بُجير:
ألا أبلغ عنِّي بُجيرًا رسالة على أيِّ شيء دينُ غيرك دلَّكا
على خُلُقٍ لم تُلفِ أُمًّا ولا أبًا عليه ولم تُدرك عليه أخًا لكا
سقاك أبو بكر بكأس رويَّة وأنهلك المأمور منها وعلَّكا
ثمَّ عاد كعب بن زهير إلى الرَّسول الكريم محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم معتذرًا، وظلُّ يعتذر أمام الرَّسول الكريم، وينشد، ويلحُّ في الاعتذار حتَّى خلع عليه الرَّسول الكريم بردته؛ ثمَّ صار خَلْعُ البردة وإلباسها لهذا أو ذاك نهجًا ينتزع من خلاله بعض المشابه بهم العفوَ، أو يسرقون بعض المواقف، الَّتي لا تُنتزع بطريقة أخرى، وقد قال كعب بن زهير في بردته:
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيَّمٌ إثرها لم يُفدَ مكبولُ
أُنبئتُ أنَّ رسولَ الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول
وقد أتيتُ رسول الله معتذرًا والعذر عن رسول الله مقبول
مهلًا هداك الَّذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل
لا تأخذنِّي بأقوال الوشاة ولم أُذنب وقد كثرت فيَّ الأقاويل
إنَّ الرَّسول لسيف يستضاء به مهنَّدٌ من سيوف الله مسلول
فعفا الرَّسول الكريم عن كعب بن زهير بعد قصيدته هذه، وكساه بردته، وتوفِّي كعب-رضي الله عنه-سنة 24 أو 26 للهجرة، ثمَّ اشترى معاوية بن أبي سفيان-رضي الله عنه-البردةَ من ورثة كعب بعشرين ألف درهم، وظلَّ الخلفاء يتوارثون البردة من بعده، ثمُّ وُظِّفَ خلعُ البردة في كثير من المواقف المتناقضة على منبر مسجد بني أميَّة الكبير في دمشق وعلى أطرافها من المدن الأخرى.