نوافذ الإثنين | ذاكرة المكان
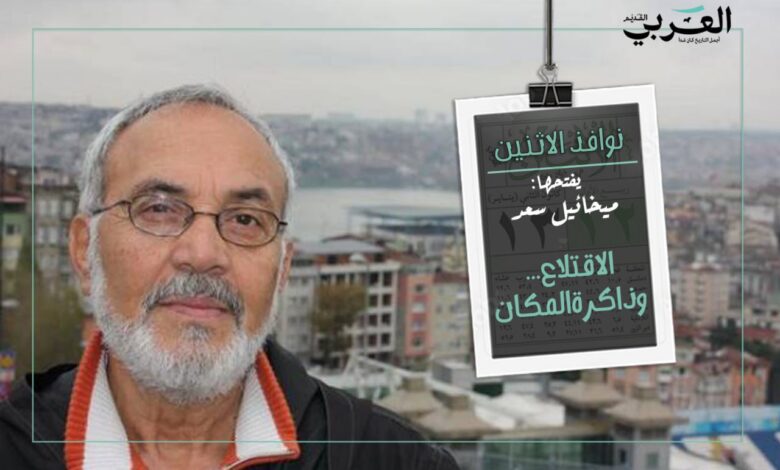
ميخائيل سعد
أن تُقتلع من ”مكانك“، يعني أن تعيش ما تبقى من عمرك على أرض ”رخوة“، هذا ما يشعر به المهاجر أو المهجّر، سواء كان اقتلاعه من أرضه رغما عنه، أو بموافقة ضمنية منه، ومهما كانت الأسباب فلن يستطيع، بعد ذلك، أن يقف مرة أخرى على أرض ثابتة.
يلعب المكان دوراً حاسماً في تحديد هويتنا وثقافتنا. يمكن أن يكون المكان المحيط بنا، سواء كان منزلنا أو مجتمعنا أو بلدنا، عاملاً مؤثراً في تشكيل هويتنا الفردية والجماعية، لذلك فإن عملية ”الاقتلاع“ من المكان تشكل تهشيما لهوية وثقافة الفرد أو الجماعة، ما يجعل الأرض الجديدة ”رخوة“ تحت الأقدام، ليس فقط في المكان الجديد وإنما في المكان القديم ذاته، عندما محاولة العودة إليه.
لن أذهب بعيدا في الكلام النظري عن أثر المكان، أو ذاكرة المكان، في حياة البشر، وإنما سأسرد بعض الوقائع التي عشتها شخصيا، أو عرفتها كي أقدم صورة واقعية عن الآثار الخطيرة على حياة الأشخاص الذين اضطروا للتخلي عن ”أمكنتهم“، سواء كانت هذه الأمكنة هي البيوت أو المدن أو الأوطان بما فيها من بيئة طبيعية أو نمط عمارة أو لغة أو عادات يومية، بل وحتـى أنواع الطعام والملبس والسلوك اليومي.
الاقتلاع الأول
كان أول اقتلاع لي من المكان عندما كان عمري أربع سنوات (١٩٥٣)، فقد نقلنا والدي، الشرطي الحديث في عمله، من القرية إلى المدينة. فكان عليّ أن أعيش حياتين معا؛ واحدة ”فلاحية“ داخل البيت، وثانية ”مدينية“ خارج البيت، فعرفت مبكراً معنى “الاقتلاع“. في أحد الأيام كنا تسكن في حيّ ”المزة“ الدمشقي، قال لي أبي: اذهب واشتري لنا كيلو لبن، فأخذت الصحن الفارغ وبعض القروش ودخلت إلى أول دكان صادفته فكان دكان خياط، وطلبت منه كيلو لبن، فضحك صاحب المحل ودلني إلى السمان المقابل، وهكذا عرفت أن هناك أنواعا متخصصة من الدكاكين في المدينة، بينما كان في القرية يوجد دكان واحد لكل الأشياء.
في مدينة بيروت عام ١٩٦٥، كنت قد وصلت المدينة باحثاً عن عمل ”صيفي“، عندما قطعت الشارع دون انتظار إشارة شرطي المرور، الذي لم أكن أعرف طبيعة عمله في ذلك الزمن، فصرخ بي قائلا وأنا ابن الخامسة عشر: من أي حرش جاي ولاه؟ وكان معه حق، فأنا قادم من حمص إلى بيروت، في ذلك الزمن، كمن جاء مباشرة من غابة إلى أحدث المدن العربية.
ذاكرة ابني المكانية
في عام ١٩٩٧، أرسلت ابني عمرو إلى سورية، وكان عمره ١١ عاما، كي يتعرف على وطن أهله وعائلاتهم، وعاد بعد أن أمضى شهرا هناك، وقد استقبله أقربائي وكأنه أمير، سألته: كيف وجدت سورية يا عمرو؟
قال: جميلة جداً يا بابا، والأقرباء أحبوني جداً.
قلت له: ما رأيك أن نعود للعيش في سورية؟
قال، بعد أن فكر عدة ثواني: لا يا بابا، أنا بلدي هنا في مونتريال، يمكن أن نزور سورية بين وقت وآخر، ولكن لن أعيش هناك. كان ما قاله ابني الصغير هو درسي الأول الذي جعلني أعيد النظر في خططي المستقبلية الوهمية حول العودة إلى سورية، فذاكرة المكان عند ابني هي التي يجب احترامها، وخاصة عندما نقول: إننا هاجرنا من أجل أولادنا!
عاش أحد المهاجرين السوريين حوالي عشر سنوات، في مونتريال، وهو يجمع المال، مقتراً على نفسه وعائلته، كي يعود إلى سورية، وحدث هذا فعلا، فقد أرغم زوجته وأولاده على العودة، فباع أثاث بيت وسيارته، وذهب إلى سورية، وكان أكثر أحد المتحمسين للعيش هناك، وأكثر المدافعين عن نظام الأسد في التسعينيات. بعد ثلاثة أشهر عاد وعائلته باحثاً عن سكن وعفش بيت، وسيارة، سألته بعد أن استقر في بيته الجديد: لماذا عدت إلى كندا، وأنت الذي كان يقاتل ليل نهار من أجل العيش في سورية؟
قال: وجدت الحياة مرعبة، فجدران الاسمنت تكتسح المدينة الكئيبة، وليس هناك قانون للسير، ولا مياه صالحة للشرب، ولا مياه ساخنة للحمام، فلماذا أبقى هناك وعندي بديل ككندا!
تذكرت هنا، بعد قول هذا الرجل الذي كان متحمسا للعودة إلى وطنه الأول، ما كتبه أحد المهاجرين من أصل أوروبي: إن أرض المهاجر تصبح ”رخوة“ أينما ”يدعس“ بعد اقتلاعه أول مرة من تربته، حتى لو عاد إلى مكانه الأول، فقد حدث الزلزال ولن تستطيع إعادة الأرض إلى ما كانت عليه قبل ذلك.
ماذا عن ذاكرة المكان إذا؟
قد تكون ذاكرة المكان مفيدة جدا في إغناء حياة المهاجر أو اللاجئ إذا استطعنا أن نستفيد من خبرات وثقافة المكان الذي كنا نعيش فيه، فتكون الذاكرة هنا عاملا إيجابا في تسهيل عملية التأقلم في المجتمع الجديد، الذي سيكون ذاكرة أولادنا، وجزءا من ذاكرتنا، أما أن تتحول ذاكرة المكان الأول إلى صنم للعبادة والتقوقع والعيش في ”غيتو“ ذاكرة المكان الأول، فهنا الخطورة التي تهدد حياتنا وحياة أولادنا خاصة، وتفصلهم عن مجتمعهم وثقافته، وتعيق عملية التأقلم أمامهم، بل وتصيبهم بشرخ في شخصيتهم، سيكون من الصعوبة بمكان شفاؤهم منها.
قبل أن أنهي هذا المقال لا بدّ لي من الإشارة إلى تجربة العيش في مكانين مختلفين في الوقت نفسه. لقد عدت إلى مونتريال، بعد قضاء عدة أشهر في مدينة ماردين التركية، وكنت سعيدا فيها لأنني وجدت في المدينة بعض عناصر ذاكرة المكان السوري، ولكن ذلك لم يحجب عني ذاكرتي الكندية التي لا أزال أغنيها بخبرات وثقافات جديدة. عدت إلى كندا وبي حنين إلى بعض جوانب ذكرياتي في مدينة ماردين، دون أن يكون هناك تعارض بين الذاكرتين بل تكامل وغنى.
إجمالاً، المكان يعمل كإطار في الذي نعيش فيه ونتفاعل معه، ويشكل هويتنا وثقافتنا من خلال التأثير على قيمنا وتصوراتنا وتجاربنا.
مونتريال في ٥/٢/٢٠٢٤
