نوافذ الإثنين | خبز التنور والذاكرة اللعوب!
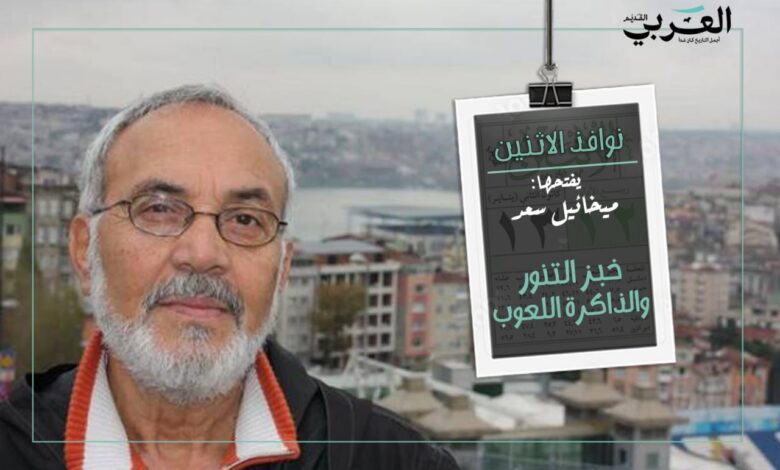
ميخائيل سعد
كان الدرس في جامعة ماردين عن تاريخ المماليك، ومعركتهم الأشهر في التاريخ الإسلامي؛ الانتصار المملوكي على المغول في معركة عين جالوت عام 1260، بقيادة السلطان قطز. كانت ذاكرتنا الجمعية التي تعيش هزائمنا اليومية، آخرها ”الإبادة الغزاوية“، تنشط في استرجاع انتصاراتنا التاريخية لتحقيق نوع من التوازن، تجعلنا نقاوم الاندثار كشعوب.
في هذه اللحظة المحبطة من ذاكرة/ صور الأجساد الفلسطينية المنثورة في العراء الغزاوي بفعل الإبادة الإسرائيلية، دخلت إلى الصف الزميلة السورية خلود، حاملة، بالإضافة إلى محفظتها ”النسائية“ الكبيرة، المليئة بصور ذكرياتها السورية، كيسا من النايلون الأبيض المنتفخ، سلّمت ووقفت أمام الطلاب، فتوقفت ”الدكتورة نرجس“ عن الكلام المباح، تاركة الفضاء، خاليا، من أحلام انتصار المماليك على المغول، للرائحة المنبعثة من الكيس البلاستيكي الذي فتحته الزميلة خلود، فانتشر عطر رائحة ”خبز التنور“ محتلا الفراغ المملوكي المتراجع أمام الحنين، إلى ذاكرة حديثة نسبيا رغم تاريخيتها، قائلة: هذا خبر التنور الطازج، هدية إلى الزميل المُعمِر ميخائيل، فقد سمعته يقول إنه يشتاق إلى هذا الخبز منذ خمسين عاما، وبما
أنني أسكن في مدينة أورفا، قرب ”تنور سوري الصنع بعد اللجوـء“، فقد قررت إرواء عطش الرغبة التاريخية لزميلنا الحمصي، الذي يحمل علـي كتفيه ذكريات 75 سنة من التاريخ.
طقوس مسيحية شرقية في وسط إسلامي
كانت الرائحة، بالنسبة لي على الأقل، مُسكرة دون خمر، ووجدت صعوبة عاطفية بالاحتفاظ بأرغفة الخبر الاثني عشر لوحدي فقط، هذا العدد الذي ذكرني بتلاميذ المسيح الاثني عشر وهم يتناولون العشاء الأخير حول الطاولة، مع السيد المسيح، (بالمناسبة صورة المسيح في العشاء الأخير صورة أوروبية، لأنه لم يكن هناك طاولات عالية للطعام في ذلك الزمن، في فلسطين، حتـى عند المحتلين الرومان، وكان الناس يجلسون على الأرض حول طاولات منخفضة)، فقدمت للدكتورة المحاضِرة ثلاثة أرغفة هدية مني، بعد أن أقسمت لها أنهم ليسوا ”رشوة“، فقامت بدورها بتقسيمها وتوزيعها على طلاب الصف، وقد ذكرني تصرفها هذا بطقس آخر يمارسه المسيحيون الشرقيون، حيث يقوم الكاهن بتوزيع الخبز المقدس على المؤمنين، في نهاية قداس الأحد في الكنيسة، ما يدل على ثقافة مستمرة من أيام المسيح، حتى وقتنا الحاضر، في مجتمعاتنا، على الرغم من اختلاف أديانها.
حاولنا العودة إلى درس التاريخ، ولكن خبز التنور ورائحته ملأت الفضاء، ولم يعد بالإمكان الاستمرار في تذكر أمجاد المماليك، فقد طغت الذكريات الحديثة المُعاشة للسوريين، من مأكل وملبس ومسكن وعيش والحنين إليها، على ذكرى المماليك والمغول القديمة، إلى أن انتهت حصة الدرس.
العيش في مكانين في الوقت نفسه
وبما أنني أعيش في مكانين مختلفين في الوقت نفسه تقريبا، واقعيا وافتراضيا، فإنني أسمح لنفسي الانتقال إلى سرد ذكريات مونتريالية-سورية، ولكن قبل ذلك أريد توضيح فكرة العيش في مكانين مختلفين في الوقت نفسه، بشكل موجز. أثناء وجودي في ماردين أعيش حياة حقيقة، في الجامعة والشارع والبيت والمقهى، مع الطلاب والأصدقاء والصديقات، مع الجيران والباعة وفي المطاعم والمواقع التاريخية، وكل النشاطات الإنسانية المتاحة. وفي الوقت نفسه أعيش افتراضيا في مونتريال، وهو مكان يبعد تقريبا حوالي ثمانية آلاف كيلو متر عن ماردين، أعيش فيه بالوقت نفسه الذي أعيش فيه في ماردين؛ من خلال التواصل بالفيديو وشبكات التواصل الاجتماعي مع زوجتي وأولادي وأحفادي وأصدقائي، أدفع فواتيري الكندية من ماردين، وأشتري من حسابي الكندي من السوق التركي، أسمع الاخبار الكندية بالعربي، من محطة راديو عربي، أو راديو كندي فرنسي، بمعني أنني أعيش في الوقت نفسه في ماردين ومونتريال، وهذا يسمح لي بالانتقال من قاعة درس في جامعة ماردين إلى المقهى الذي توجد فيه ”زاوية المعمرين“، متابعا حديث دروس ماردين نفسها، مع الأصدقاء الذين تجاوزوا السبعين من العمر، في كندا، والعكس صحيح أيضا، فماذا أجد عندهم؟
ذاكرة المهاجرين والمهجّرين
كما يتذكر السوري في ماردين بيته في سورية، وخبزه ولحمة مطبخه ورائحة خضرواته، كذلك يفعل كل مهاجر سوري، أو لاجئ في كل مكان في العالم، وإذا كانت غربته في تركيا أو لبنان أو مصر أو الأردن، ليست قاسية في، بدايتها، لتشابهه الثقافات، فإن السوري المقيم في الغرب يشعر بقساوتها منذ اللحظات الأولى، ولتخفيف الشعور القاسي بانفصاله عن وطنه السوري، يقوم باستدعاء كل ذكرياته السورية، ميكلا لها المديح، حتى لو كانت مهينة أحيانا، وقوفه لمدة ساعات على ”حواجز“ المخابرات، أو أمام الأفران، أو حتى تلقي صفعة على وجهه من عنصر أمن، هذا عداك عن الذكريات الجميلة. حول طاولتنا، في المقهى المونتريالي، يتحلق عدد من المتقاعدين، وغاليا ما يدور الحديث عن ذكريات شبابهم في سورية، وحنينهم إلى كل شيء عاشوه في تلك المرحلة. يتغزلون برائحة الفواكه وطعم الخضار وأنواع الثياب الفاخرة، وعندما يصل الحديث إلى اللحوم السورية وطعمها، تكاد ترى لعابهم وهو يسيل من زوايا الشفاه ”المرتخية“، بفعل شيخوخة الجسد، وبالمقابل تكون الشكوى من عناصر الغذاء الكندية غير الطيبة، والخدمات الطبية السيئة. يستمر حال المهاجرين المتقاعدين على هذا الوضع، في أغلب الأحيان، وكلما تقدم بهم العمر كان حنينهم إلى سورية الوطن يزداد، وخاصة أمنياتهم في أن يموتوا هناك، كي تكون قبورهم قرب من يحبون من الأهل والأصدقاء الذين سبقوهم بالرحيل إلى العالم الآخر.
في الأسبوع الماضي، وصل أحد المعمرين إلى المقهى، قادما من زيارة روتينية إلى طبيبه العائلي، يشكو من فوضى الطب، والخدمات السيئة، فقد اضطر للانتظار أكثر من ساعة في عيادة الطبيب، قبل أن يراه. سألته: ماذا كنت ستفعل لو لم تتأخر في العيادة الطبية المجانية؟
قال: كنت سأكون في المقهى.
قلت: ماذا كنت ستفعل لو كان عليك دفع كشفية للطبيب، في كل زيارة، كما كنت تفعل في سورية؟
قال: كنت سأذهب لزيارة الطبيب في الحالات الشديدة الألم فقط.
لم أتابع أسئلتي، كنت فقط أريد أن أقول: إن أحدثنا وجودا في كندا وصل قبل عشرين عاما، ومع ذلك، نادرا ما نكيل المديح لهذا الوطن ونرى جمالياته، الذي قدم لنا كل أسباب الراحة والرخاء النسبي، والعناية الصحية، والعدالة والمواطنة، فلماذا نتذكر سورية أكثر من تذكرنا لحياتنا الحالية في كندا أو الغرب عامة؟
ليس المطلوب أن نبحث عن إجابات قاطعة جازمة، وإنما أن نفكر بذلك، وأن نكون، نحن المهاجرين القدماء، نماذج إيجابية لحديثي العهد بالهجرة، سواء كانت إجبارية أو اختيارية، تسهل أمامهم الطريق إلى التأقلم في أوطانهم الجديدة، وتخفف من عذابات سنوات الهجرة الأولى.
أخيرا، من المعروف أن الإنسان عندما يشيخ تتراجع عنده الذاكرة الحديث، لتنشط عنده الذاكرة القديم، وربما هذا ما يفسر جزئيا الحنين إلى سنوات شبابه وذكريات طفولته، ولكن ماذا عن المهاجرين الشباب في الشتات السوري؟
هل هو حقا الحنين إلى الوطن المفقود، أم الحنين إلى نمط حياة الاستبداد السياسي والاجتماعي والديني؟
أم هو الحنين إلى رائحة البندورة والخس واللحمة وخبز التنور؟
مونتريال: ١٨/٢/٢٠٢٤

لقد اشتممت رائحة خبز التنور وأنا اقرأ النقال… شكرا اعدتني خمسين سنة إلى الوراؤ