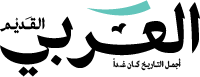مسلسل (ليالي روكسي) دمشق التي لا تشبه زمنها… والريادة السينمائية التي تحولت ألعوبة
نموذج للعمل الفني الذي يخون المرحلة التي يقاربها، ويفشل في ملامسة أجوائها، وفي الدخول إلى نسيج علاقاتها وتقدير إنجاز شخصياتها
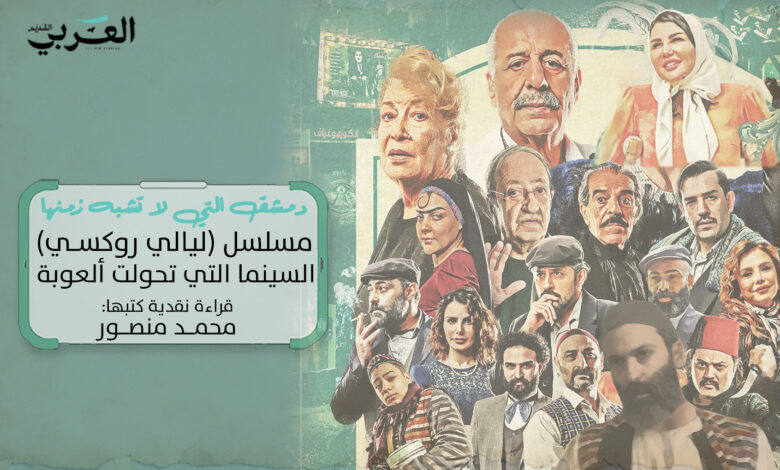
محمد منصور – العربي القديم
لا يكفي القول إن “هذا العمل يعتمد على واقعة تاريخية، لكنه يبتعد ويقترب من الوثيقة حسب المقتضى الدرامي” كي يبرر مسلسل (ليالي روكسي) الذي كتبه شادي كيوان ومعن سقباني وبشرى عباس وأخرجه محمد عبد العزيز، هذا العبث المخزي بتاريخ دمشق، وتاريخ الحياة الفنية فيها، وقيم الحياة الاجتماعية المعروفة والموثقة في مئات الكتب التي ألفها أبناء المدينة، فالاعتماد على واقعة تاريخية، وتسمية الأشياء والأشخاص بمسمياتها، يفرض عليك احترام هذا التاريخ، والعمل على صياغة وثيقة درامية تلفزيونية تستلهم روحه واجواءه، لا العبث به، وإظهار جهلك السافر ببيئته وطقوسه، ولغة أهله.
الواقعة التاريخية والمخرج المُختلق
الواقعة التاريخية التي يعنى بها المسلسل، هي سعي مجموعة من الهواة إلى إنتاج أول فيلم روائي سوري صامت، وهو الفيلم الذي ظهر عام 1928 باسم المتهم البريء، وبعد عام واحد من ظهور أول فيلم مصري وهو فيلم (ليلى) الذي أنتجته عزيزة أمير، وأخرجه كل من ستيفان روستي ووداد عرفي وعزيزة أمير.. أما فيلم (المتهم البريء) فكان من إنتاج أيوب البدري الذي لعب بطولة الفيلم وشارك في الكتابة والإخراج، كما شاركت منتجة الفيلم المصري عزيزة أميرة في الإخراج أيضا… وأولى مظاهر الخلل في معالجة مسلسل ليالي روكسي لهذه الواقعة، هي تقديم شخصية المخرج بصيغتها المعروفة التي تكرست في العقود اللاحقة من عمر السينما مع بدء انتشار السينما الناطقة ودوران عجلة الإنتاج، أي المخرج الممسك بزمام العمل، وصاحب القرار الأول والأخير أثناء التصوير ودوران الكاميرا، والذي يدقق في التفاصيل وأداء الممثل وتعابيره، ويستخدم تعابير تقنية لتمثيل ذلك… إن كل هذا ينم عن جهل بواقع العمل الفني، وعن قصور وفشل في محاكاة الفترة الزمنية ومفرداتها من أجل تقديم عمل فني يستلهم روح المرحلة ويكون أمينا لها، لا عابثا ومتولدناً بمناخها بحجة “المقتضى الدرامي” فأي مقتضى هذا الذي يفرط بالاقتراب من المرحلة وخصوصا أنه يستخدم أسماء الشخصيات التاريخية الحقيقية والوقائع المعروفة التي تلزمك بان تصورها بمفردات زمانها وبيئتها، ما دمت قد حددتها بالاسم!
إن كل الوثائق عن تاريخ بدايات السينما، في سورية ومصر ولبنان، تشير أن عملية الإخراج كانت تتم بشكل شبه جماعي وتشاركي، وخصوصا حين يكون يشارك منتجو العمل في التمثيل كما كان يحدث في معظم التجارب الأولى… ناهيك عن أن شخصية المخرج كانت أقرب إلى شخصية التقني الذي كان يسعى لحل المشاكل التقنية من تصوير وإضاءة وحركة كاميرا، وهذه كانت معضلة كبرى في ظل محدودية الإمكانات والاعتماد على الموهبة والشغف لا الدراسة الأكاديمية التي احتاجت لعقود عديدة حتى تتبلور في العالم. وفي الوثائق الفنية والكتب التي أرخت لتاريخ السينما، فالفيلم مسجل باسم أيوب البدري مخرجاً وليس رشيد جلال، الذي كان مصورا وشريكا في الإنتاج، وربما قام بحكم معرفته التقنية بالتصوير بممارسة بعض مهام المخرج كإدارة الممثل ورسم خطة التصوير، وهذا أمر طبيعي، لكنه أبدا لم يكن الآمر الناهي في الفيلم، ولم يكن يملك أن يجبر بطل ومنتج الفيلم أيوب البدري أن يقبل بطلة فيلم… وكتاب رشيد جلال (قصة السينما في سورية) الذي ألفه ونشره المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب بدمشق عام 1963 موجود، ورغم أنه يفرد فيه مجالا للحديث عن تجربته في (المتهم البريء) إلا أنه لا يذكر شيئا من هذا أبداً!
كما أن شخصية المخرج الذي يقيم علاقة غرامية مع بطلة أفلامه وهي تبادله المشاعر لأنها تطمع بأن يعطيها فرصا في أفلامه القادمة أو لأنها معجبة بإحساسه ووسامته، لم تكن تشبه أجواء العمل السينمائي الهاوي في تلك الفترة، وهي إختلاق وتزوير لا وجود له، لسبب بسيط أن المخرج لم يكن ينتمي لمنظومة إنتاج سينمائي كي يعد أحداً بفرص، أو كي يغري ممثلة ناشئة بحبه… فشركة حرمون التي أسسها البدري وجلال مع أحمد تلو والمرادي، وأسموها على اسم جبل الشيخ التاريخي (حرمون فيلم) أفلست بعد أول إنتاج، ناهيك أنه بين عامي 1928 و 1963 وهو تاريخ إنشاء المؤسسة العامة للسينما في سوريا، لم ينتج على مدى نحو نصف قرن سوى سبعة أفلام… فأين هو المخرج أو المنتج الذي يمكن أن تطمح ممثلة ناشئة ساذجة بأن يعطيها فرصا في أفلامه القادمة في ظل غياب الصناعة وبؤس التمويل وافتقار الأدوات؟!

معظم نساء المسلسل يلاحقن الرجال للزواج بهم…. تيمة تتكرر في المسلسل لتسيء لنموذج المرأة (العربي القديم)
استباحة القيم الاجتماعية
على الصعيد الاجتماعي ثمة سعي لدى صناع المسلسل لإقحام انفتاح اجتماعي على المرحلة، لم يكن موجود فيها، وهذا أمر طبعا يرقى إلى مرتبة التزوير، سواء كان هدفك تنويري أو تثويري تقدمي… فالتاريخ لا يكتب بالنوايا والأمنيات بل بالوقائع والاستناد إلى الوثائق وشهادات أبناء المرحلة التي عاشوا فيها، وهي متوفرة بطبيعة الحال بحكم أن دمشق من أكثر مدن الشرق التي كتب عنها وألفت حول الحياة فيها في كل المراحل والعهود الكتب. لكن صناع العمل القاصرين عن بلوغ معنى أن تقدم مسلسلاً محترماً عن مرحلة تاريخية واضحة المعالم، قُمتَ بذكر أسماء أبطالها الحقيقيين وانتماءاتهم ومهنهم الأصلية، يظنون أن المراحل التاريخية مجرد حكاية تروى بلا ضوابط، ومواقف تفبرك دون مرجعية ومعايير… وهم يعتقدون أن تقديم عمل حول جانب من التاريخ الفني والاجتماعي السوري يبيح لهم أن يحشروا ما يشاؤوا من أفكار وتوجهات بخلاف روح المرحلة… ولهذا نجد في الجانب الاجتماعي أحداثا ووقائع تتنافى مع العرف الاجتماعي السائد في المرحلة، وخصوصا في علاقات الغرام المشوهة والتافهة، التي تقوم على نساء يبتذلن أنفسهن وكرامتهن وهن يلهثن وراء رجال غارقين في الخجل أو التردد أو العزوف عن الزواج… هناك أربعة نماذج لرجال يتحرش بهن النساء ويطلبن منهم أن يتزوجوا بهن علناً وبشكل مباشر. فهل هذه أجواء البيئة الاجتماعية المحافظة في دمشق قبل قرن من الزمان؟! وهل انتفت قيم الحياء الاجتماعي وحل محلها هذا الانقلاب القيمي العابث بمنطق الأشياء وطبيعة المرحلة التاريخية وقيم المجتمع المحافظ فيها؟!
إلا أن كل هذا الحضور المسترجل للنساء والمتهافت للرجال المرتبكين، والذي أراد المخرج أن يجعل منه نقاط ارتكاز كوميدي لمعالجة فشل في صياغتها، لا يقارن بالارتكابات الأخرى التي يقدم عليها ولعل أقذعها، قيام الطبيب الصهر بتوليد حماته، وتصويره وهو يحشر رأسه بين ساقيها تحت غطاء السرير كما تفعل الداية، مخاطبا إياها: ” أي حماتي… اكبسي… إيه” وهو أمر لا يمكن أن يحدث على الإطلاق في عشرينيات القرن العشرين، ولا يمكن أن يتجرأ الصهر على طرحه مجرد طرح أمام العم وعميد الأسرة، الذي هو مختار الحارة ومن وجهائها، وخصوصا أن الولادة كانت طبيعية ولم تستدع تدخلا طارئاً، ناهيك عن وجود خيارات لا حصر لها لقابلات (دايات) نساء وخبيرات. وحده الجاهل بدمشق وبيئتها وطبيعتها، وببيئة سورية المحافظة عموما في تلك الفترة، يمكن أن يتجرأ على هذا العبث الذي لا ينزل لا بميزان ولا بقبان وليس له أي مبرر درامي، وخصوصا في ظل انتشار الدايات النساء اللواتي ظللن يمارسن عملهن في المدينة حتى سبعينات وثمانينات القرن العشرين.
شخصيات تاريخية منتحلة
ثمة الكثير من الأخطاء التاريخية التي يحاسب عليها صناع العمل، لأنهم يذكرون أسماء شخصيات تاريخية معروفة، وهذا يلزمهم بأن يقدموها بأمانة، بخلاف الشخصية المختلقة أو غير الموثقة التي يمكن أن تضاف للعمل، والذي يمكن للكتاب أن يتصرفوا بها كونها ليس لها مرجع تاريخي. ومن الأخطاء الفادحة التي يرتكبها مخرج العمل في تقديم الرائد المسرحي عبد الوهاب أبو السعود في المسلسل، أنه أعطى الدور للفنان دريد لحام الذي تجاوز التسعين من العمر، في حين أن عبد الوهاب أبو السعود توفي وهو دون الخامسة والخمسين من العمر، وحين مر شارلي شابلن بدمشق عام 1932، وصور لنا العمل أن عبد الوهاب أبو السعود ذهب لمقابلته في فندق أمية برفقة الممثلة طيرة الحكيم وبطلة المسلسل توتة، كان أبو السعود شابا في الخامسة والثلاثين من العمر، وليس عجوزا تسعينياً لا يعينه نَفَسه المتقطع على إكمال الجمل الحوارية بقوة، فيلجأ لتقطيعها تقطيعا اضطرارياً.
وثمة فارق كبير بين شاب في الثلاثينات من العمر، يقدم دروسا لفن التمثيل كما كان يفعل أبو السعود في مكتب عنبر وفي مدرسة الملك الظاهر تاريخياً، وبين الأستاذ دريد التسعيني الذي يحدثنا عن ستانسلافسكي ومدرسته في التمثيل التي لم تكن معروفة في عشرينيات القرن العشرين في المنطقة العربية، ويجهد في الموازنة بين حسه الكوميدي وبين صرامة الأستاذ الكهل العجوز الذي يبهر التلميذة البلهاء المنبهرة مسبقاً بكل شيء في الفن، دون أن يبلغ أي مقاربة لشخصية الرائد المسرحي عبد الوهاب أبو السعود الذي ينطبق على أدائه لها، وصف انتحال الشخصية لا التقمص، وتقديمها بغير صفاتها ومرحلتها العمرية تماماً، رغم أنها شخصية موثقة بتاريخ حياتها، سبق للكاتب الدمشقي عادل أبو شنب أن ألف كتابا كاملا عنها مزودا بوثائق وصور، صدر عام 1963 في أكثر من 120 صفحة من القطع الوسط.

مخرج المسلسل محمد عبد العزيز مع دريد لحام الذي تجاوز التسعين، بينما الشخصية التاريخية التي يجسدها هي لرائد مسرحي شاب في الثلاثينات (العربي القديم)
أما شخصية (إستيرا حنائيل الحكيم) أو (طيرة الحكيم) الممثلة والمطربة التي سافرت مع أبي خليل القباني إلى شيكاغو عام 1893 وكان عمرها 17 عاماً، فهي تقدم هنا على أنها ممثلة معتزلة تعيش على أطلال ذكرياتها مع أبي خليل مع أن نشاط الفرقة توقف في مطلع القرن، وسافرت طيرة بعده إلى العراق وإلى مصر وكان لها نشاط فني وغنائي واسع… وفرضية أن أبا خليل القباني غنى لها (يا طيرة طيري يا حمامة) هي فرضية لا أساس لها، وكلمات الأغنية نفسها تدحضها: (انزلي بدمر والهامة، وهاتي لي من حبي علامة، ساعة وخاتم ألماس) ذلك أن الطيرة المقصودة هي طائر الحمام الذي جعله القباني مرسالا للمحبوب الذي يعيش بين دمر والهامة… ولا يوجد أي أثر للمزج بين طائر الحمام والطيرة في الأغنية، أو أي تغزل بها لو كانت حقاً هي المقصودة.
إشارات ثقافية من خارج السياق
ومثلما يذكر دريد لحام – لا أبا السعود- ستانسلافسكي ومبادئه في التمثيل، يُذكر تشيخوف في المسلسل، وتقوم بطلة المسلسل التي هي ابنة قصاصة شعر جاهلة، ولكنها مهووسة للفن، بتمثيل مشهد من مسرحية (الدب) لتشيخوف أمام بنات الحارة. علما أن مسرحيات تشيخوف ذات الطبيعة الخاصة، لم تكن معروفة على الإطلاق في عشرينيات القرن العشرين، وحركة ترجمة أدب تشيخوف بدأت في خمسينات القرن العشرين، مع بروز ظاهرة اليسار في الأوساط الثقافية، وانتقالها من السياسة إلى الثقافة، فكيف بـ “توتة” الجاهلة، التي لم تكن حينها قد أخذت بنصيحة أستاذها بالقراءة، أن تكون قد عثرت على ترجمة لمسرحية (الدب) لتشيخوف أو حفظت شيئا منها؟! وهل تصلح هذه المسرحية لتقدم لفتيات لا يعرفن ما هو المسرح أصلا؟!
ثمة الكثير من الرؤى المعاصرة جداً والمقحمة على المرحلة، والمفاهيم الغريبة عنها… حتى طريقة التدريب على التمثيل لم تكن تقوم على المفاهيم الحديثة القائمة على فكرة أنك يجب أن تمثل وكأنك لا تمثل، بل كانت قائمة على الأداء الانفعالي والميلودرامي الذي يحاول أن يدهش الناس، ويستعرض عضلات الممثل كي يؤثر بهم!
كل هذا يجعل العمل من الناحية التاريخية: أخرق، مشوه، جاهل بتقاليد البيئة ومفردات المرحلة، مكتوب بناء على تصورات معاصرة لا تخلو من سماجة وقلة حيلة وسطحية… وهو لا يمثل بالتأكيد مسيرة مخرجه محمد عبد العزيز التي سبق أن حفلت بأعمال هامة تدل على موهبته ودأبه إن في السينما أو في التلفزيون.
كارثة المعالجة الكوميدية: برونتو ولوينتو!
لا يحتاج المرء لكثير عناء كي يكتشف أن المخرج محمد عبد العزيز، أراد أن يبث شيئا من روح الكوميديا في العمل، واعتمد في معالجته العامة للنص على المعالجة الكوميدية للشخصيات وبناء الكاركترات وحلول الكثير من المواقف. ومن المؤسف رغم كل ما بذله من جهد، انه لم يكتشف أن الكوميديا ليست ملعبه، فما بالك بكوميديا شعبية مستوحاة من أجواء مدينة راسخة التقاليد، قبل نحو قرن من الزمان.
إن اللوازم الكوميدية المفرنجة مثل “برونتو” التي يرددها (علا الله) و”لوينتو” و”بكالوز” التي ترددها (كوكب)، تبدو خياراً سيئاً وبلا معنى ويقتل روح الشخصية الشعبية والكوميديا المستوحاة من بيئة محلية ذات ملامح قوية، حتى ليمكن القول أن المخرج عبد العزيز بدا غريب اليد والوجه واللسان عن بلوغ مبتغاه في تقديم هذه الكوميديا أو تلوين دراماه بلمحات منها. فهو ليس ابن بيئة، ولا تجارب كوميدية ناجحة له سابقا، ولا هو تواضع قليلا واستعان بخبير تراثي أو فلوكلوري يرشده لمفاتيحها، وهؤلاء كثر في دمشق. وهكذا جاءت النتيجة بناء كاركترات بشعة، وسمجة وغير قادرة على الإضحاك ولا على رسم الابتسامة، ولا على مقاربة الروح الشعبية الكوميدية… فجاءت الكاركترات التي وافق عليها نموذجا فجاً من نماذج الافتعال الفني، كما نرى في شخصية (كوكب)، التي تستعير رنة قبقاب غوار الطوشة، وتحاول أن تقلد حديث الزكرتاوية والقبضايات بطريقة مموجة ومموطة، ليس فيها أي إحساس درامي أو ملمس فني، ناهيك عن المكياج العام البشع للشخصية الذي لم يخدم بنيتها ولا أسلوب أدائها… والأمر ينطبق على نموذج (زهدي) الشاب الرجولي المظهر الذي يعاني من خلل في وعي الهوية الجنسية فيلبس لباس النساء، دون أن يتشبه بحركاتهن. شخصية لا تضيف أي شيء لا لدراما العمل ولا للكوميديا المفترضة، ويمكن في حال حذفها او تقديمها كشخصية طبيعية، ألا يتأثر العمل في كثير أو قليل، سوى التخفف من عناء السماجة وثقل الدم، التي تلاحق أيضا ابن المخرج (تيم عزيز) أو (علا الله) وهو اسم نادر جداً لم أسمع به إلا في فيلم (الليل) لمحمد ملص، وهو هنا بائع ضنضرما (الآيس كريم) ومراهق عاشق، يؤرقه عدم ظهور شاربه ولحيته، ويحاول أن يهجر مهنته ويصبح زكرتياً. ورغم هذه المفاتيح الكوميدية للشخصية، يبدو الكاركتر المبني قائما على الافتعال والتظارف والأداء الخارجي المنفّر، واللهجة الممطومة، والذراعين المنفوشين عرضاً عبر فتح الإبطين، وكأنه هكذا تبنى شخصيات القبضايات أو هكذا تكون. لقد كان هذا الدور ضربة قاصمة لحضور تيم الذي سحر الناس بعفويته وحيويته وعمق إحساسه في مسلسل أبيه السابق (النار بالنار) بينما هنا بدا بلا إحساس ولا حضور!

رنا ريشة في دور (كوكب) كاركتر سمج بمكياج بشع ونافر، يستعير رنة قبقاب غوار الطوشة (العربي القديم)
وإذا كان أيمن زيدان ينجو بأداء جدي منضبط قائم على الالتزام بمعطيات الشخصية وخطوطها، دون تميز يذكر إنما دون سقوط أيضاً… فإن السمة العامة للأداء في (ليالي روكسي) هي كوارث تمثيلية من العيار الثقيل، فسلاف فواخرجي التي تظن نفسها فراشة الفن، وليلى مراد السينما في عز تألقها، تبدو ثقيلة الظل، مصطنعة، تتحرك في مساحة فضفاضة وكأنها تمثل بفلوسها، وشخصيتها مزيج مركب ومتناقض من فتاة شعبية وامرأة ارستقراطية تستعرض ما لديها من الإكسسوارات والثياب وممثلة فقيرة الموهبة مسرفة في نشوتها وتمسحها بالفن والفنانين… أما رنا ريشة التي أدت دور كوكب فينطبق على أدائها ما قلناه حول بنية الكاريكاتير السمج الذي تؤديه، وهناك كم من الممثلين الجيدين الذين تشهد لهم أدوار هامة سابقة، حضروا هنا في أداء مشكلتها، الكاركترات السمجة غير الموفقة فنياً، التي كانت تحاول الإضحاك وافتعال النكتة أبزرهم جوان خضر في دور (أيوب البدري) وشادي الصفدي في دور (بلبل)… وفاتح سليمان، لم ينج منهم سوى سامي نوفل في دور القبضاي (خيرو) الذي كان قمة في الحضور وعمق ملامسة الشخصية الشعبية حتى ليكاد يكون أفضل ممثل في العمل بحق. أما السيدة منى واصف فكانت تحلق في عالم آخر من نشوة الفن بعيدا عن أجواء المسلسل، وكأنها في برج عاجي من الأداء المعتق بعيدا عما تقدمه زميلاتها والممثلات بسطحيتهن وانفلات أدائهن خارج ضوابط البيئة والمرحلة وضمن هذه التشكيلة العجيبة الغريبة من تنافر الأداء النسائي لدى معظمهن.

سامي نوفل في دور القبضاي خيرو: أفضل ممثل في العمل (العربي القديم)
تشويه تاريخ الفن والمدينة
باختصار مسلسل (ليالي روكسي) هو نموذج للعمل الفني الذي يخون المرحلة التي يقاربها، ويفشل في ملامسة أجوائها، وفي الدخول إلى نسيج علاقاتها وتقدير إنجاز شخصياتها، وبدل أن يقول لنا انظروا كم عانى الفنانون الأوائل الهواة كي يصنعوا سينما تحجز لسوريا مقعدا متقدما في عالم الريادة الزمنية على الأقل، فظهر أول فيلم سوري بعد عام واحد من إنتاج أول فيلم مصري، رغم ما لدى الشقيقة مصر من فارق بالإمكانات في تلك الفترة، يذهب المسلسل بخياره الكوميدي السيء في المعالجة، إلى تصوير قصة صناعة الفيلم، كتجربة هزلية، فارغة، قائمة على المشاحنات الصبيانية، والخلافات التي تبدو أغلبها سخيفة، خالية من الإيمان بمعنى الفن ورسالته، التي تطنب طيرة الحكيم في المحاضرة حولها في مشاهدها، بينما تقول أجواء صناعة (المتهم البريء) إن هذا الكلام في واد وأهل السينما وهواتها الرواد في واد آخر. أما عن دمشق فهي آخر ما فكر صناع العمل على ما يبدو ان يكونون امنين في مقاربتها في عشرينيات القرن العشرين، لأنهم يريدون أن يقدموا دمشق أخرى هي نتاج تخيلاتهم القاصرة، ورغبتهم في إيصال رسائل مزورة عنها.
ومن المؤسف ان يظهر صناع العمل ليقولوا أن (ليالي روكسي) يوثق لتاريخ الفن وصناعة أول فيلم سينمائي في سوريا، والحق أنه أبعد ما يكون عن بلوغ هذا الهدف.