نصوص أدبية || كائــــــنٌ غير مَرْئي
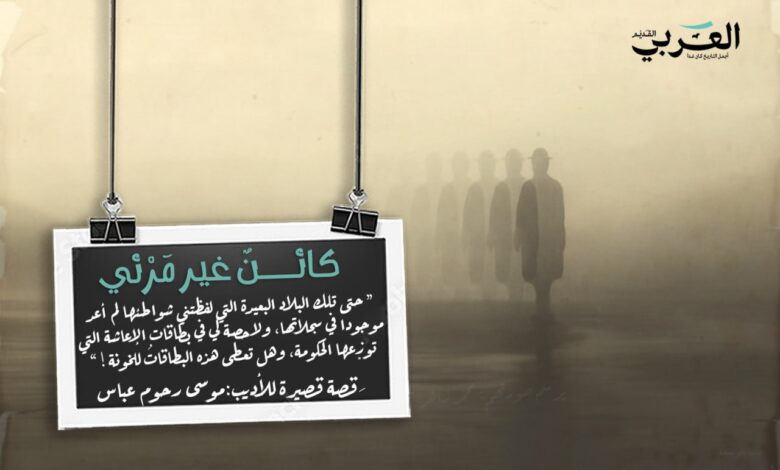
قصة قصيرة: موسى رحوم عباس[i]
في مدرسة قريتي ” كَسْرَةُ مُريبط” مدرسة الحكومة التي كانت غرفة طينيَّة مُصادرة، ثم صارت مبنى حجريًّا، كنتُ أراه قلعة رغم أنَّه مؤلفٌ من ثلاث غرف، لكنَّ الأرض ممتدة حوله حتى تخوم البريَّة وحقول القمح والشَّعيرالبعْليِّ، وأظنُّ أنَّ ملعب كرة القدم الذي خطَّطناه بالحوَّار الأبيض الذي تجلبه النِّسوة للإعلان عن بداية الرَّبيع وطلاء الجدران به؛ لتصبح القرية بيضاء من الداخل، حزينة كئيبة من الخارج، أظنُّه أكثر مساحة من ملعب المانشستريونايتد بعد زيارتي الأخيرة له، نعم، في تلك المدرسة قرأ لنا المعلم رياض عَكَّاري قصة ” قُبَّعة الإخفاء” تلك القُبَّعة التي إذا اعتمرتها؛ غِبتَ عن عيون الآخرين، عندها تصبح كائنًا غير مرئيٍّ، تتسعُ مساحة حريتك؛ لتصبح شاسعة مثل بادية تدمر السُّورية، أو صحراء الرُّبع الخالي، لا أعلم مساحة أيٍّ منهما! كنتُ ولدا صَمُوتًا، أعتقد أنَّ الإنسان عندما يلجم فمه، تتسع رؤيته، ويتحرَّر خياله، بل يسهل عليه الإيمان بالتقمُّص وممارسته، تجرأتُ على الاقتراب من المعلِّم عاشق الكتب والقراءة، وقلتُ بصوتٍ خفيضٍ:
- هل أستطيع أنْ أطلب شيئا؟
- الحمدلله سمعتُ صوتك، هل تحسن الكلام يابنيَّ، كنتُ أظنُّكَ مصابًا بالخرس؟
احمرَّت وجنتاي خجلا، لكنني تابعتُ:
- أرغبُ في استعارة هذه القصَّة!
- بكلِّ سرورٍ، لكنْ لماذا هذه القصَّة بالذَّات؟
- لا أعرف!
أعدتُ القصَّة بعد يوم واحد، وحسب، لقد قرأتُها عشرات المرَّات، حفظتُها عن ظهر قلب، وفي أول مرَّة سافر والدي فيها إلى حلب، حيثُ يبيعون الصُّوف والسَّمن، ويجلبون الصَّابون الحلبيَّ والحبال والحلوى… طلبتُ منه أن يشتري لي قبَّعة، ورسمتُ له شكلها ولونها في ورقة مستلَّة من دفتري، نظر إليها والدي باستغراب، لكنه دسَّها في جيبه، قائلا: خير إن شاء الله، أبشر، ولا يهمك يا غالي وطلب رخيص!
ومن يومها كانت القُبَّعة لا تفارق رأسي، مع شروق الشَّمس اعتمرها؛ فأتحوَّل لكائنٍ غير مرئيٍّ، أتطوَّع بأخذ كرة القدم من غرفة المعلِّمين، وألقي بها بين أقدام زملائي المتعطِّشين لكرة حقيقيَّة من الجلد، وليست كرة القماش التي تصنعها الأمَّهاتُ، أخرج من الغرفة بهدوء، تنتهي المباراة، أعود مُدْمى الرُّكبتين غالبًا، أعرج يمينا أو يسارا، لا يهمُّ، أدخل الغرفة ثانية، أعيد الكرة إلى المكان عينهِ، لا أحدَ يسألني، أو يؤنِّبني، كيف يفعل ذلك وأنا كائنٌ غير مرئيٍّ؟! هذا سحر القُبَّعة، بالتأكيد هو كذلك، حتى عندما سرقنا البطِّيخ والقِثَّاءَ من حقل الحاج علَّاوي، كنتُ المقدَّم من قبل الأولاد جميعا على اقتحام الحقل، وجلب الغنائم، ووضعها أمامهم، ياه ! كم كنتُ سعيدا برؤيتهم يأكلون البطِّيخ بأيديهم الملوثة بالتُّراب، والمياه الحمراء منه تسيل على أعناقهم ومَرافِقهم، عيونهم تلهج بالشكر لي، وهم واثقون أنْ لا أحد يمكن له رؤيتي، وأنا أقطع القِثَّاء والبطِّيخ من شُجيرات الحاج علَّاوي، ذلك الرُّجل البخيل الذي يملأ حقله بالفزَّاعات، حتى لا ينقر طيرٌ حبَّةً، أو دودةً من أرضه!
عندما سجنتُ بعد عشرات السِّنين، أثناء عودتي من الدِّراسة في الخارج ، اصطادني الحاجز الكبير على مدخل دمشق، ورموني مثل كيس من الذُّرة في مؤخِّرة السَّيارة العسكريَّة، أشهر كثيرة وأنا أهذي طوال الليل – كما أخبرني جاري في ” القاووش” أو المهجع كما كانوا يُسَمُّونه، طبيعي أنْ تختلف التَّسميات، نحن بقايا البدو في تلك البلاد نسمِّيه “القاووش” والمتحضِّرون من أبناء المدن والمتعلِّمون يسمُّونه” المَهْجَع” ينهض جاري الذي نتناوبُ أنا وهو على مكان النَّوم نفسه طوال اللَّيل؛ ليسألني كلَّ صباحٍ، يرحم والديك، إيش قصة ” القُبَّعة أو الطَّاقيَّة” التي تذكرها في كوابيسك كلَّ ليلة؟ ولماذا أنتَ نادمٌ كلَّ النَّدم لأنَّك لم تعتمرْها يوم اعتقلتَ عند ذلك الحاجز اللَّعين؟! أصمتُ، ولا أجيب عن سؤاله، أنظرُ إلى الأرض، يفشل في كلَّ مرَّة في انتزاع جوابٍ يشفي غليله أو فضوله، مرَّة رأيت دموعه تسيل على وجنتيه، ربَّما إشفاقًا عليَّ، وربَّما على نفسه، وربَّما علينا معًا!
الآن في أقصى أصقاع الأرض، وصلتُ، لا تسألني كيف وصلتَ، وصلتُ، وخلاص! لم أفكر بالسَّيارات الفارهة أو البيوت الفخمة، ولا حتى النِّساء الجميلات، اشتريت عشرات القُبَّعات، حتى صارت القُبَّعة جزءًا مني، لا أخرج صيفًا أو شتاءً دون أن أعتمر واحدة منها صوفيَّة أو قطنيَّة، تصاميم فريدة فرنسية، وروسية، وإنكليزية، وسويدية… ألوان متعدِّدة الرَّماديُّ والأسود والأزرق وما بينهما، ألتقي بجيراني في المبنى الكبير الذي أقطن في شقَّة صغيرة منه في الطَّابق الثَّالث، يضحكون مع بعضهم، يمزحون بلغات متعددة، يتبادلون التَّحيات الصَّباحيَّة والمسائيَّة، يداعبون كلاب بعضهم، ويقبِّلونها أحيانا، نعم يُقبِّلون تلك الكلاب الصَّغيرة النَّاعمة ذات العيون السَّوداء العميقة، ويبدون إعجابهم بها، أقف خلفهم منتظرًا دوري في المصعد، لا أحد يراني مطلقًا، أنا غير موجود، أنا صِفْر ” مُكعَّب” كما كان يقول معلِّمنا رياض العَكَّاري لأحدهم الذي أصبح لاحقًا رفيقا كبيرا في الحزب، يمتطي سيَّارة سوداء مُسدلة السَّتائر، كلَّما أجرى لنا امتحانا في الحساب أو اللغة العربية، كان يقول بصوته الجهير، (ع. ج) صفر مُكعَّب؛ فتنطلق ضحكاتنا الصَّغيرة، وقد غطَّينا أفواهنا بأيدينا محاولة لكتمها!
نعم، أنا الآن “صفر مُكعَّب” أتسلَّل صباحًا أو مساءً إلى شوارع المدينة النَّظيفة، كائنًا شفَّافًا لا يمكن رؤيته، لا أحدَ يلقي إليه بتحية صباح أو مساء، لا أحد يسأل عن نهر الدُّموع خلفه، عن النَّشيج المكتوم في ليالي الثَّلج والصَّقيع، لا أحد! في القطار يبقى المكان المجاور لي فارغا، يمرُّ النَّاس منه، وكأنهم لا يرونه، في الطائرة يغيِّر الرَّاكب المجاور لي مقعده بعد لحظات من الإقلاع بعد أن يتبادل مع المُضيفة بضع كلمات، المساعدات المالية تدخل حسابي المصرفي دون أن يخبرني أحد، حتى تلك البلاد البعيدة التي لفظتني شواطئها لم أعد موجودا في سجلاتها، ولا حصة لي في بطاقات الإعاشة التي توزِّعها الحكومة، وهل تعطى هذه البطاقاتُ للخونة!
في جلسة العلاج الأخيرة، عرض علي الدكتور توماس مُرافقته إلى مدينة كِيرونا في أقصى الشَّمال خلال عطلة حزيران أو “السِّيمستر” كما يسمُّونه هنا، وذلك للترفيه عنِّي كما يقول، ومشاهدة ” “ Midnattssol وعندما أدرك عدم فهمي للمِدْناتزْسول، ابتسم، وقال هذه شمس منتصف اللَّيل، حيث تستمرُّ الشَّمس بالشُّروق طوال الأربع والعشرين ساعة عند الدَّائرة القطبيَّة الشَّمالية، ضحكتُ مُقهقهًا، وقلتُ : لا، لا، شكرا، فقد رأيتُ في تلك البلاد البعيدة “نجوم الظُّهر” وأنا أتقلَّبُ على “بساط الرِّيح” لم يفهم ما أعنيه، ولم أتطوَّع لشرحه، ثم أخبرتُهُ أنَّني ساقطع العلاج، وستكون هذه جلستي الأخيرة، أبدى استغرابه وأسفه لذلك، ولكنَّه سألني بأدب شديد عن السَّبب، تردَّدتُ في الإجابة، ولأنِّي أعلمُ أنَّهم لن يتركوني وشأني، وسأضطَّرُ لاحقا لاستقبال اللجان والمتخصِّصين في كلِّ مرَّة، لذلك قلتُ له، لن أحتاج بعد اليوم أيَّة مراجعة أو جلسة؛ لأنني أعرف العلاج النَّاجع لحالتي، ومَنْ أخبرُ مِنِّي بما ينفعني، أو يضرُّني! قلب شفته، ظانًّا أنِّي لا أراه، لم أكترثْ لموقفه أو سخريته، حاول الظُّهور بمظهر الجادِّ في رغبته لمعرفة ذلك العلاج الذي يعرفه هذا الشَّرقي المُتعجرفُ، ويجهله المتخصِّصُ في جامعة راقية مثله، قلتُ، ياسيدي مشكلتي تنحصر في هذه القُبَّعات العشرين التي أمتلكها، ولا أخرج إلا وقد اعتمرتُ إحداها!
خرج من الغرفة مسرعا، وهو يردِّد القُبَّعة، القُبَّعة، القُبْ….. بينما كنتُ منشغلا بنزع قُبَّعتي ومتابعتها، وهي تهوي نحو ماء البحيرة التي تقطعها السُّفنُ والعَبَّاراتُ السِّياحيَّة، تهوي كطائر أسود من شبَّاك العِيادة في الطَّابق العشرين وسط استوكهولم!
إسكلستونا، السويد
2024
[i] الأديب السوري موسى رحوم عباس : روائي وكاتب سوري مقيم في السويد

لتكن العربي القديم نافذة للضوء والهواء النظيف، تحياتي وتقديري.