وَهمُ الخبير في المشهد السُّوريِّ: حين يظنُّ الجميع أنَّهم يعرفون كلَّ شيء
قراءةٌ في تأثير دانينغ- كروجر على واقعِ النقاشاتِ السوريةِ في عصر الإنترنت

براء الجمعة * – العربي القديم
تخيّلْ نفسك تجلسُ في مقهىً يعجُّ بالنقاشاتِ الحادّة. الكلُّ يُحلّلُ الأوضاعَ السياسيةَ والاقتصاديةَ وكأنّهُ خبيرٌ مُحنّك. لكن، هل سألتَ نفسك يوماً: ما هو حجمُ المعرفةِ الحقيقيُّ الذي يستندُ إليهِ هؤلاءِ المُتحدّثون؟ غالبًا ما نجدُ أنفسنا أمامَ وهمٍ كبيرٍ يُحيطُ بالكثيرين، وهمٍ يُعرفُ بـ “وهمِ المعرفةِ.
“نتوهم المعرفة والخبرة في مواضيع بالكاد نعرف عنها شيئًا، ويتضح لنا مستوى جهلنا حين نتعلم عنها فعلياً. كلّما قلّت معرفة الشخص، كانت إجاباته وتفسيراته بسيطة وسطحية، وبدرجة عالية من اليقينية.”
هذه الكلمات، التي تُجسّد جوهر ما يُعرف بـ “تأثير دانينغ-كروجر”، ليست مجرد ملاحظة عابرة، بل هي تشخيص دقيق لحالةٍ بشريةٍ مُتأصلة، تزداد وضوحاً في عصرنا الرقمي، وتُصبح أكثر إلحاحاً في سياقاتٍ مُعينة كواقعنا السوريّ المفتت.
“الكل خبير… حتى يبدأ بالتعلّم!” هذا الشعار الساخر يُلخّصُ بدقةٍ المفارقةَ التي نعيشها. في زوايا النقاشات اليومية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، نُشاهدُ مشهدًا مُتكرراً: الكلّ يُفتي في كلّ شيء، من السياسة والاقتصاد إلى الطب والفلسفة، وكأنّ كلّ فردٍ قد نال شهادةَ دكتوراة في جميعِ المجالات. نُصبحُ جميعاً خبراءَ استراتيجيينَ في الصباحِ، وأطباءَ نفسيينَ في الظهيرةِ، وعلماءَ اقتصادٍ في المساءِ، دونَ أن نُكلّفَ أنفسنا عناءَ البحثِ والتفكيرِ الناضج.
وهم المعرفة: حين نرى البحر مجرد بُركة
هذه الظاهرة، التي تُعرف بـ “تأثير دانينغ-كروجر”، نسبةً إلى العالمين النفسيين ديفيد دانينغ وجستين كروجر اللذين درساها بشكل مُفصّل، تُشيرُ إلى ميلِ الأشخاصِ ذوي المعرفةِ المحدودةِ في مجالٍ ما إلى المبالغةِ في تقديرِ قدراتِهم ومعرفتِهم في ذلك المجال. فهم يرونَ البحرَ مُجرّدَ بركةٍ بقعة ماء صغيرة، ولا يُدركونَ عُمقَهُ واتساعَهُ. في المقابل، يميلُ الأشخاصُ ذوو المعرفةِ العميقةِ إلى التقليلِ من شأنِ خبراتِهم، لأنّهم يُدركونَ مدى تعقيدِ الموضوعِ واتساعِ آفاقِ المعرفةِ فيه.
يُمكنُنا أن نرى تجلياتِ هذا الوهمِ في مواقفَ عديدةٍ في حياتِنا اليومية: شخصٌ يُجادلُ في قضايا سياسيةٍ بناءً على منشورٍ قرأهُ على فيسبوك، شابٌ يُصرُّ على رأيهِ في موضوعٍ طبيٍّ لأنّهُ شاهدَ فيديو قصيراً على يوتيوب، طالبٌ جامعيٌّ يظنُّ أنّهُ أتقنَ المادةَ بعدَ قراءةٍ سطحيةٍ للفصلِ الأولِ من الكتاب. في كلِّ هذهِ الحالات، نرى قناعاتٍ حاسمةً مبنيةً على فتاتٍ من المعرفة، وكأنّ صاحبَها قد أحاطَ بكلِّ جوانبِ الموضوع.
لماذا يحدث هذا؟ سيكولوجيا وَهْمِ المعرفة
يكمنُ وراءَ وَهْمِ المعرفةِ، أو ما يُعرف بـ “تأثير دانينغ-كروجر”، مجموعةٌ من العواملِ النفسيةِ والمعرفيةِ المُتشابكةِ التي تُفسّرُ هذهِ الظاهرةَ المُنتشرة. فبدلاً من أن يكونَ الجهلُ دافعًا للتعلّمِ، يتحوّلُ في بعضِ الأحيانِ إلى وَهْمٍ بالاكتفاءِ والاقتناعِ بمعرفةٍ سطحية. يُمكنُ تلخيصُ هذهِ العواملِ في الآتي:
- نقصُ الوعي بالجهل (Metacognitive Deficit): جوهر المشكلة
هذا هو حجرُ الزاويةِ في فهمِ تأثيرِ دانينغ-كروجر. فالشخصُ الذي يفتقرُ إلى المعرفةِ الحقيقيةِ في مجالٍ ما، لا يمتلكُ الأدواتِ المعرفيةَ اللازمةَ لتقييمِ مدى جهلِهِ. ببساطةٍ، هو لا يعرفُ “ما لا يعرفُهُ”. هذا النقصُ في الوعيِ بالعملياتِ المعرفيةِ الخاصةِ بالفردِ (Metacognition) يجعلهُ غيرَ قادرٍ على التمييزِ بينَ المعلوماتِ الصحيحةِ والخاطئةِ، وبينَ الفهمِ السطحيِّ والفهمِ العميقِ. يُعبّرُ عن هذهِ الحالةِ الشاعرُ الإنجليزيُّ ألكسندر بوب بقولِهِ: “القليلُ من المعرفةِ شيءٌ خطيرٌ.” فالشخصُ الذي يمتلكُ معلوماتٍ قليلةً قد يعتقدُ أنّهُ فهمَ الموضوعَ بشكلٍ كاملٍ، ممّا يجعلهُ أكثرَ عرضةً لاتخاذِ قراراتٍ خاطئةٍ أو إصدارِ أحكامٍ غيرِ دقيقة. على سبيل المثال، شخصٌ قرأَ مقالاً واحداً عن التغذيةِ قد يعتقدُ أنّهُ أصبحَ خبيراً في هذا المجال، ويبدأُ في تقديمِ نصائحَ غذائيةٍ للآخرين، دونَ أن يُدركَ مدى تعقيدِ علمِ التغذيةِ وتشابكِ العواملِ المُؤثّرةِ فيه.
- الثقةُ الزائفةُ (Illusory Superiority): وَهْمُ التفوّق
يُمكنُ أن تُؤدّي بعضُ النجاحاتِ البسيطةِ أو المعلوماتِ المُتناثرةِ التي يكتسبُها الشخصُ إلى شعورٍ زائفٍ بالثقةِ بالنفسِ، ممّا يُعزّزُ وَهْمَ المعرفةِ. هذا الشعورُ بالتفوّقِ الوهميِّ يجعلُ الشخصَ يعتقدُ أنّهُ أفضلُ من غيرِهِ في فهمِ الموضوعِ، حتى لو لم يكنْ لديهِ أساسٌ متينٌ لهذهِ الثقة. على سبيل المثال، طالبٌ حصلَ على درجةٍ جيدةٍ في اختبارٍ بسيطٍ في بدايةِ الفصلِ الدراسيِّ قد يعتقدُ أنّهُ أتقنَ المادةَ بشكلٍ كاملٍ، ممّا يجعلهُ يُهملُ الدراسةَ والمراجعةَ، وبالتالي يُعرّضُ نفسَهُ لخطرِ الفشلِ في الاختباراتِ اللاحقة. هذا الوهمُ بالثقةِ يُعيقُ أيضاً عمليةَ التعلّمِ، لأنّ الشخصَ لا يرى حاجةً إلى بذلِ المزيدِ من الجهدِ لاكتسابِ معرفةٍ أعمق.
- الخلطُ بينَ المعلومةِ والمعرفةِ (Information vs. Knowledge): فُقدانُ السياقِ والفهم
في عصرِ الإنترنت، أصبحنا مُحاطينَ بكمٍّ هائلٍ من المعلوماتِ المُتاحةِ للجميعِ، لكنّ المعلومةَ ليست هي المعرفة. المعلومةُ هي مُجرّدُ حقيقةٍ مُجرّدةٍ، بينما المعرفةُ هي فهمٌ عميقٌ لهذهِ الحقيقةِ وربطُها بسياقاتٍ أوسعَ، وتحليلُها وتقييمُها. يُشبهُ الأمرُ امتلاككَ لمجموعةٍ من الأحجارِ، لكنّ المعرفةَ هي القدرةُ على بناءِ بيتٍ متينٍ من هذهِ الأحجار. على سبيل المثال، معرفةُ أنّ “التدخينَ يُسبّبُ سرطانَ الرئةِ” هي معلومةٌ، بينما فهمُ الآلياتِ البيولوجيةِ التي تُؤدّي إلى هذا السرطانِ، ودراسةُ الإحصائياتِ والبحوثِ العلميةِ المُتعلّقةِ بهِ، هي المعرفة. الخلطُ بينَ المعلومةِ والمعرفةِ يُؤدّي إلى وَهْمِ الفهمِ، ويجعلُ الشخصَ يعتقدُ أنّهُ يمتلكُ معرفةً حقيقيةً في حينِ أنّهُ يمتلكُ فقط معلوماتٍ سطحيةً وغيرَ مُترابطة.
السياق السوري: تثاقفٌ سطحيٌّ أم ضياعٌ في متاهةِ المعلومات؟
في واقعِ السوريينَ اليوم، الذي أثقلتْهُ سنواتُ الأزماتِ المُتراكمةِ والتحدياتِ الجسام، تضخّمت ظاهرةُ وَهْمِ المعرفةِ بشكلٍ لافتٍ. فبفعلِ الانفتاحِ الكبيرِ على مصادرَ معلوماتٍ مُشوّشةٍ ومُتضاربةٍ، غزت الفضاءَ الرقميَّ، أصبحَ الجميعُ يُبدي رأيَهُ في كلِّ شيء، وكأنَّهُ يمتلكُ الحقيقةَ المطلقة. يُجادلُ البعضُ في السياسةِ بحدةٍ وانفعالٍ، وكأنّهم قادةُ رأيٍ أو خبراءُ استراتيجيون عالميون، يُحلّلونَ التحالفاتِ الدوليةَ والنزاعاتِ الإقليميةَ بجرأةٍ وثقةٍ، دونَ أن يُكلّفوا أنفسهم عناءَ البحثِ العميقِ أو الدراسةِ المُتأنّية. ويُناقشُ آخرون قضايا مُعقدةً في علمِ النفسِ أو الاقتصادِ بناءً على بضعةِ تغريداتٍ قرؤوها أو مقاطعَ فيديو شاهدُوها على يوتيوب، مُتجاهلينَ التعقيداتِ والتفاصيلَ الدقيقةَ التي تُحيطُ بهذهِ العلوم.
يُمكنُ القولُ إنّنا نعيشُ حالةً من “التثاقفِ السطحي”، حيثُ نكتسبُ قشوراً من المعرفةِ من مصادرَ مُتعددة، دونَ أن نُعمّقَ فهمَنا لأيِّ موضوعٍ بشكلٍ حقيقي. هذا التثاقفُ السطحيُّ، الذي يُغذّيهِ انتشارُ الأخبارِ الكاذبةِ والشائعاتِ المُضلّلةِ، يُؤدّي حتمًا إلى وَهْمِ المعرفةِ، ويجعلُنا نُصدّرُ أحكاماً قاطعةً بناءً على معلوماتٍ مُبتسرةٍ وغيرِ دقيقة. فكم من مرّةٍ رأينا نقاشاتٍ حادةً تنشبُ بينَ سوريينَ حولَ قضايا مصيرية، بناءً على تحليلاتٍ سطحيةٍ أو معلوماتٍ مُغلوطةٍ، ممّا يُساهمُ في تعميقِ الانقساماتِ وتأجيجِ الخلافات.
يتجلّى وَهْمُ المعرفةِ في أبسطِ تفاصيلِ حياتِنا اليومية، مُتّخذًا أشكالًا مُتعدّدةً تُعيقُ فهمَنا الحقيقيَّ للتحدياتِ التي نُواجهُها. فبدلًا من البحثِ عن تحليلاتٍ شاملةٍ وعميقةٍ، نلجأُ غالبًا إلى تبسيطِ الأمورِ واختزالِها في أسبابٍ قليلةٍ وسهلةِ التداول، ممّا يُؤدّي إلى تضليلِ الوعيِّ العامِّ وإعاقةِ إيجادِ حلولٍ فعّالة.
فعلى سبيلِ المثالِ، عندَ الحديثِ عن الارتفاعِ المُستمرِّ في أسعارِ الموادِ الغذائيةِ، يميلُ البعضُ إلى إرجاعِ الأمرِ بشكلٍ مُبسطٍ إلى “جشعِ التجارِ” أو “ارتفاعِ سعرِ صرفِ الدولارِ”، مُتجاهلينَ جملةً من العواملِ الاقتصاديةِ والمعيشيةِ الأخرى بالغةِ الأهمية، كارتفاعِ تكاليفِ الإنتاجِ والنقلِ، وتأثيرِ الحصارِ الاقتصاديِّ، وتدهورِ البنيةِ التحتيةِ، وانخفاضِ قيمةِ الليرةِ السوريةِ بشكلٍ مُزمن. هذا التبسيطُ يُحوّلُ المشكلةَ إلى صراعٍ وهميٍّ بينَ المُستهلكِ والتاجرِ، ويُغفلُ عن الحلولِ الجذريةِ التي تتطلّبُ معالجةَ المشاكلِ الهيكليةِ في الاقتصادِ الوطني.
وبالمثلِ، يُمكنُ ملاحظةُ هذا التبسيطِ في التعاملِ مع قضايا الصحةِ النفسيةِ، حيثُ يُقلّلُ البعضُ من أهميةِ هذهِ الجوانبِ الحيويةِ في حياةِ الإنسانِ، ويُفسّرونَ المشاكلَ النفسيةَ كالاكتئابِ والقلقِ بعباراتٍ مُبسّطةٍ وسطحيةٍ، مثل “ضعفِ الإيمانِ” أو “الدلعِ”، مُتجاهلينَ أنّ هذهِ المشاكلَ هي أمراضٌ حقيقيةٌ ذاتُ أبعادٍ بيولوجيةٍ ونفسيةٍ واجتماعيةٍ، تحتاجُ إلى تشخيصٍ دقيقٍ وعلاجٍ مُتخصّصٍ. هذا التبسيطُ لا يُؤدّي فقط إلى تجاهلِ معاناةِ الأفرادِ، بل يُمكنُ أن يُؤدّي أيضًا إلى تفاقمِ الوضعِ وتأخيرِ الحصولِ على المساعدةِ اللازمة.
هذا الوهمُ بالمعرفةِ لا يُساهمُ فقط في نشرِ المعلوماتِ الخاطئةِ، بل يُعيقُ أيضًا الحوارَ البنّاءَ والتفكيرَ النقديَّ، ويُؤدّي إلى تضييقِ آفاقِ الفهمِ وتكريسِ الجهلِ.
هل ما نعرفه كافٍ لنصدر حكماً؟ سؤالٌ يوقظ الوعي
هل يكفي ما نملكه من معلوماتٍ لإطلاقِ أحكامٍ قاطعةٍ على الأمور؟ هذا سؤالٌ جوهريٌّ ينبغي أن يُرافقَنا في كلِّ نقاشٍ وحوارٍ، بل في كلِّ تفكيرٍ وتدبُّر. إنَّ الإجابةَ عن هذا السؤالِ تُحدّدُ مسارَ تعاملِنا مع المعرفةِ، وتكشفُ عن مدى وعينا بحدودِ إدراكِنا. فكم من مرّةٍ بنينا قناعاتٍ راسخةً على أساسٍ هشٍّ من المعلوماتِ، ثمّ اكتشفنا لاحقًا زيفَ ما اعتقدنا؟
السؤالُ الذي يجبُ أن نطرحَهُ على أنفسنا دائمًا، وبصدقٍ مع الذاتِ، هو: هل ما نعرفهُ فعلًا كافٍ لنُصدرَ حكمًا؟ هل نحنُ مُستعدّونَ للاعترافِ بشجاعةٍ بأنّنا لا نعلمُ أحيانًا؟ هذا الاعترافُ ليسَ ضعفًا أو نقصًا، بل هو قمةُ الوعي والنضجِ الفكريّ. فكما قال الفيلسوفُ الحكيمُ سقراط، مُلخّصًا جوهرَ الحكمةِ في كلماتٍ قليلة: “كلُّ ما أعرفهُ هو أنّي لا أعرفُ شيئًا.”
هذا الاعترافُ العميقُ بالجهلِ، الذي يُنسبُ إلى سقراط، ليسَ دعوةً إلى الاستسلامِ للجهلِ أو التوقُّفِ عن البحثِ عن المعرفةِ، بل هو دعوةٌ إلى التواضعِ الفكريِّ وإدراكِ حدودِ العقلِ البشريِّ. هو بدايةُ المعرفةِ الحقيقيةِ، لأنّهُ يُحرّرُنا من وَهْمِ الإحاطةِ بكلِّ شيء، ويفتحُ لنا آفاقًا جديدةً للتعلّمِ والاستكشاف. هو بمثابةِ نقطةِ انطلاقٍ نحو فهمٍ أعمقَ وأشملَ للعالمِ من حولِنا.
المعرفة الحقيقية تبدأ بالتواضع
المعرفة الحقيقية، كشجرةٍ باسقةٍ، جذورها التواضع، وأغصانها التعلّم المستمر. فكلّما تعمّقنا في أيّ مجالٍ من مجالاتِ الحياة، انكشفَ لنا اتساعُ آفاقِهِ وعمقُ أغواره، وازددنا إدراكًا لضآلةِ ما نعرفُهُ مقارنةً بما نجهل. هذا الإدراكُ ليسَ مدعاةً لليأسِ أو الإحباطِ، بل هو حافزٌ قويٌّ يدفعُنا إلى مزيدٍ من البحثِ والتنقيبِ والاستزادةِ من العلم. فالأشخاصُ الأكثرُ علماً هم في الواقعِ الأكثرُ تواضعاً، لأنّهم يُدركونَ تماماً مدى تعقيدِ الأمورِ وتشابكِها، وأنّ المعرفةَ بحرٌ لا ساحلَ له.
هذا المعنى تجسّد في أقوالِ وحِكمِ علمائِنا وأُدبائِنا عبرَ التاريخ. فقد رُوي عن الإمامِ عليّ بن أبي طالبٍ (رضي الله عنه) قولُهُ: “ما أضمرَ أحدٌ شيئاً إلا ظهرَ في فلتاتِ لسانِهِ وصفحاتِ وجهِهِ.” وهذا يُشيرُ إلى أنَّ التواضعَ الحقيقيَّ ينبعُ من القلبِ، ويظهرُ في أقوالِ الإنسانِ وأفعالِهِ. كما قال أيضاً: “من كساهُ الحياءُ ثوبَهُ لم يفضحْهُ الناسُ.” فالحياءُ، وهو وجهٌ من أوجهِ التواضعِ، يَحفظُ الإنسانَ من الوقوعِ في وَهْمِ المعرفةِ والتكبُّرِ على الآخرين.
وفي الحديثِ النبويِّ الشريفِ: “مَن تواضعَ للهِ رفعَهُ.” وهذا يُبيّنُ أنَّ التواضعَ صفةٌ محمودةٌ عندَ اللهِ وعندَ الناسِ، وأنّها سببٌ للرفعةِ والسموِّ.
كما يُشبّهُ العالمُ الفيزيائيُّ إسحاق نيوتن، معرفتَهُ بالمحيطِ الشاسعِ، وما يعرفُهُ هو مُجرّدُ قطرةٍ في هذا المحيط. هذا التشبيهُ البليغُ يُعبّرُ عن مدى إدراكِ العُلماءِ لعُمقِ المعرفةِ واتساعِها، وأنّ مهما بلغَ الإنسانُ من العلمِ، فإنّهُ سيظلُّ مُحتاجاً إلى المزيد.
فالتواضعُ إذًا ليسَ غياباً للمعرفةِ، بل هو وعيٌ بحدودِها، وهو بدايةُ رحلةِ التعلّمِ الحقيقيّةِ. وهو ما يُحفّزُنا على البحثِ والسؤالِ والاستكشافِ، ويجعلُنا نُدركُ أنَّ المعرفةَ كنزٌ لا يَفنى، وأنّ السعيَ إليها هو غايةٌ في حدِّ ذاتِها.
من وهم اليقين إلى نور المعرفة:
قبل أن ندّعي الخبرة أو نُجاهر باليقين، دعونا نسأل أنفسنا: هل نفهم حقًا هذا الموضوع؟ أم أننا نكرر ما قرأناه أو سمعناه؟ الحقيقة أن “كلما قلّت المعرفة، زادت البساطة واليقينية”. هذا التبسيط المُضلّل يقودنا إلى وهم الراحة المعرفية، لكنه يحرمنا من متعة البحث والغوص في أعماق الفهم.
إن وهم المعرفة ليس مجرد خطأ معرفي، بل هو انعكاس لحالة وجودية نحاول فيها الهروب من قلق الجهل إلى راحة الوهم. لكن الحقيقة هي أن الحياة رحلة تعلم مستمرة، والاعتراف بجهلنا بداية النمو الحقيقي. فالتواضع أمام ما نجهل هو أساس التقدم، وهو ما يجعلنا نتوق إلى المغامرة في دروب الفهم. كما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: “قيمة كل امرئ ما يحسنه.” فلنُحسن طلب العلم ونسعى للمعرفة بشجاعة وانفتاح. دعونا نجعل من التعلم عملية مستمرة ترافقنا طوال حياتنا، تُثري وعينا وتُوسع آفاقنا. البحر بانتظارنا، فلنُبحر إليه بكل شغف وثقة، مستعدين لاكتشاف أنفسنا من خلال اكتشاف عُمقه. فلنُحوّل وهم الخبير إلى دافع للتعلّم والبحث والتفكير النقدي، ولنجعل من رحلة البحث عن المعرفة مغامرة شيقة تُثري حياتنا وتُوسّع آفاق وعينا، بدلًا من الاكتفاء برؤية “البركة” الصغيرة، لنسعى إلى استكشاف “البحر” بأسراره وكنوزه.
__________________________
*مختص في الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي
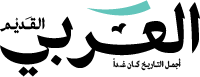
منشور رائع ومفيد وواقعي. كلام من ذهب بوركت أستاذ براء على هذه المقاله الرائعه