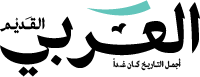ثورة تدجين القمح والخروج من عنق الزُّجاجة
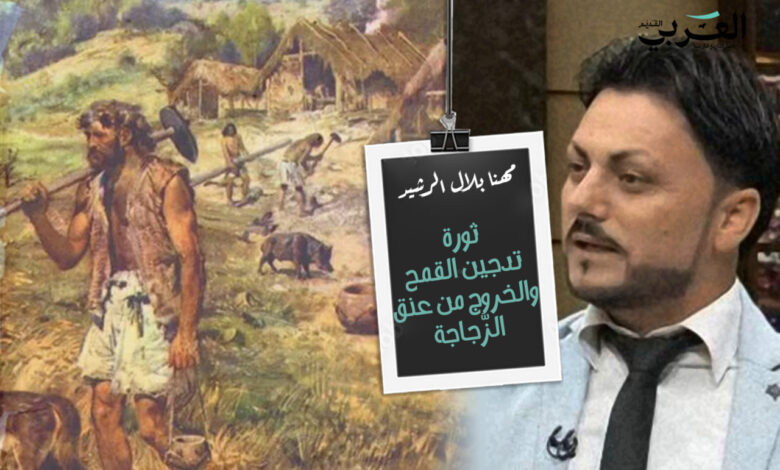
مهنَّا بلال الرَّشيد
يشير مصطلح عنق الزُّجاجة إلى مرحلة حَرِجة من المراحل التَّاريخيَّة، الَّتي عاشتها البشريَّة، وكانت فيها مهدَّدة بالانقراض؛ وذلك للانخفاض الشَّديد في عدد السُّكَّان على سطح الأرض بسبب الحروب والقحط والجفاف الشَّديدين، فبعد تَعارُف البشر أو تزاوج أعراق متعدِّدة من (النِّياندرتال) و(الهومو إيريكتوس) ظهر أو جدُّنا الإنسان العاقل نتيجة لهذا التَّزاوج قبل (35000) سنة من وقتنا الرَّاهن، وبدأت مرحلة جديدة ضارية جدًّا من مراحل الصِّراع على المجالات الحيويَّة الخصبة أو الغنيَّة بمياه الينابيع والأنهار، وكان (النِّياندرتال) و(الهومو إيريكتوس) أوَّل ضحايا هذا الصِّراع بعد تعارف الأعراق المتباعدة أو تزاوجها؛ فقد تخلَّصت الأجيال الجديدة من أبناء الإنسان العاقل من أجدادها وآبائها، ويمكننا من الآن ولاحقًا أن نعبِّر عن (الإنسان العاقل) أو (الهومو سابينيز) بمصطلح (إنسان الكلام)؛ والحقُّ أنَّ تطوُّر اللُّغة من خلال تطوُّر منطقة بروكا لدى إنسان الكلام مكَّنت أفراد الأجيال الجديدة من التَّفكير في المستقبل والتَّخطيط له وتنسيق العمل ونصب المكائد لخصومهم الحيويِّين من أجدادهم وأبناء عمومتهم من قدماء (النِّياندرتال) و(الهومو إيريكتوس)، الَّذين انقرضوا في زمن نشوء قابل جديدة من إنسان الكلام؛ وذلك لعجزهم عن مجاراة إنسان الكلام في القدرة على التَّخطيط للمستقبل والتَّفكير فيه وتنسيق الأعمال التَّعاونيَّة ضدَّ الآخرين من خلال اللُّغة التَّواصليَّة الجديدة.
مع نشوء قبائل جديدة من (إنسان الكلام) دخلت البشريَّة مرحلة مبكِّرة من مراحل عنق الزُّجاجة، ونقول: مراحل عنق الزُّجاجة في صيغة الجمع؛ لأنَّ هذه المرحلة الحرجة تكرَّرت مرَّات عدَّة عبر التَّاريخ، وكان تزامن انقراض النِّيادنرتال والهومو إيريكتوس مع نشوء قبائل إنسان الكلام واحدة من مراحلها المبكِّرة؛ لأنَّ أعداد الجيل الجديد من (إنسان الكلام) كانت قليلة، وقد شارفت البشريَّة الجديدة على الانقراض إن لم تستطع تأمين طعامها وشرابها برغم قلَّة أعدادها في ظلَّ القحط الشَّديد؛ ولأنَّ (الحاجة أم الاختراع) قانون جوهريٌّ من قوانين التَّاريخ والاجتماع والعلوم الإنسانيَّة كلِّها؛ اخترع البشر القوارب، وتعلَّموا صيد الأسماك، واخترعوا السِّيوف والرِّماح والقِسيَّ والنِّبال والسِّهام؛ ليصطادوا بها الطُّيور والأرانب وغزلان البرِّيَّة السَّريعة، وإن كانت هذه المخترعات قد قدَّمت حلولًا مرحليَّة جيِّدة؛ حفظت النَّوع البشريَّ من الانقراض إلَّا إنَّها تسبَّبت-على المدى البعيد-في انقراض بعض أنواع الطِّيور والحيوانات في ظلِّ القحط والجفاف والصَّيد الجائر، الَّذي قضى على كثير من صِغارها في مواسم التَّكاثر بسبب جوع البشر وزيادة عدد السُّكَّان المضطَّردة في سنوات القحط والجفاف وقلَّة الثَّمار والخضروات.
كيف خرجت الثَّورة الزِّراعيَّة النِّيوليثيَّة من خاصرة الأرض في تلال كوبكلي تبَّه (Göbekli Tepe)؟ وكيف خرجت البشريَّة من عُنق الزُّجاجة؟
لا، بل كيف خرج البشر من خاصرة الأرض في تلال كوبكلي تبَّه (Göbekli Tepe)؟ كيف نجوا من موت محتوم في ظلِّ القحط والجفاف والجوع الشَّديد؟ وكيف خرجت البشريَّة من عُنق الزُّجاجة؟ظلَّ إنسان الكلام بدويًّا صائدًا وجامعًا حوالي (25000) سنة بعد ثورة التَّعارف وانقراض خصومه الحيويِّين من النِّياندرتال والهومو إيريكتوس، وكان يحلُّ في السُّهول الخصيبة في مواسم المطر؛ ليصيد حيواناتها، ويجمع ثمارها، ويرحل منها عندما يحلُّ فيها الجفاف، وينزل في سهول خصيبة أخرى، لكنَّ مناخ الأرض مرَّ بتحوُّلات كبرى؛ فقد اختفت قارَّة كبيرة مثل قارَّة أطلانتس، والتقى نهرا دجلة والفرات عند شطِّ العرب، وصارا نهرًا واحدًا بعد أن كانا يصبَّان في الخليج العربيِّ كنهرين منفصلين، وكانت سنوات القحط والجفاف الطَّويلة والمتلاحقة واحدة من أبرز سمات هذه المرحلة التَّاريخيَّة التَّي نتحدَّث عنها.
استوطن البشر على ضفاف النِّيل وضفاف نهري دجلة والفرات في سهول بلاد ما بين النَّهرين؛ نظرًا لوجود الماء والمرعى والحيوانات والثِّمار؛ لكنَّ القحط والجفاف والصَّيد الجائر وزيادة عدد السُّكَّان أجبرا الإنسان في آخر هذه المرحلة؛ أي حوالي (10000-9500) قبل الميلاد أن يبحث عن أصغر الأشواك والبذور الشَّاردة بينها في سهول بلاد ما بين النَّهرين وعلى تلالها؛ ليتغذَّى عليها حين صارت حياته مهدَّدة بالانقراض بسبب الجوع والعطش، وحين كانت بعض الجماعات البشريَّة تبحث عن بذور شاردة بين الصُّخور وأشواك العُلَّيق عثر أحدهم على بقعة صغيرة من قمح البرِّيَّة أُحاديِّ الحبَّة غير المهجَّن أو غير المُدجَّن؛ فأكل منه ما يسدُّ جوعه، وحفر لحفنة القمح المتبقِّية، ودفنها تحت التُّراب؛ ليعود إليها، ويأكلها عند جوعه في المرَّة القادمة، ثمَّ التحق بأفراد جماعته البشريَّة يبحث معهم عن ثمرة هنا أو طريدة هناك؛ فابتعدت الجماعة قليلًا، وانتشر أفرادها في سهول (حرَّان-أورفة) وتلال كوبكلي تبَّه-تلّ السُّرَّة (Göbekli Tepe) جنوب شرق تركيا؛ وخلال سَبرِ هذه المنطقة والتَّجوُّل فيها والنَّوم في مغاورها جادت السَّماء ببعض الأمطار؛ وظهرت بعض النَّباتات والبقوليَّات، الَّتي تغذَّت عليها الجماعات البشريَّة، وحافظت على جِنسنا من الانقراض، وعند انقضاء فصل الرَّبيع وحلول صيف جديد جفَّت المياه، ورجع إنسان الكلام في كوبكلي تبَّه (Göbekli Tepe) إلى حفنة قمحه؛ فوجدها حقلًا صغيرًا من سنابل القمح أحاديِّ الحبَّة؛ وهنا اهتدى إلى الزِّراعة من خلال تقليد الطَّبيعة ومحاكاتها مجدَّدًا، بطريقة تشبه تقليد اكتشاف النَّار من خلال احتكاك أغصان الأشجار اليابسة وضرب حجارة الصَّوَّان، أو بنفس محاكاة الظِّلال في المغاور، عندما راح يرسم برماد النَّار صورًا تشبه ظلَّه على جدران الكهف؛ ومن هنا نكتشف كم نحن مدينون للتَّقليد والتِّكرار في نشوء الحِرَفِ الأولى! كم نحن مدينون للمحاكاة ذاتها بوصفها أقدم نظريَّة تفسِّر نشوء الحرف والفنون والنَّظريَّات الفنِّيَّة الأخرى!
تعليق فيلولوجيٌّ:
تقدِّم علوم الدَّلالة وعلم الفيلولوجيا أو (فقه اللُّغات القديمة المقارن) تأويلات تاريخيَّة مذهلة، يستنجد بها الباحثون عن المعنى في كثير من الأحيان، على نحو استعانتي بهذه العلوم لأعرف أنَّ كلمة (Tepe) تعني (التَّلّ) في اللُّغة التركيَّة، وتدلُّ كلمة (Göbekli) على السُّرَّة في اللُّغة التُّركيَّة ذاتها، فأيُّ دلالة مذهلة على الخروج من عنق الزُّجاجة أو الولادة القيصريَّة المتعسِّرة من خاصرة الأرض أو خاصرة هذه التِّلال تحمله هذه العبارة (Göbekli Tepe) في اللُّغة التُّركيَّة؟! أيُّ ولادة أنقذت الإنسان وحفظت هذا النَّوع البشريَّ بعد أن كانت البشريَّة كلُّها مهدَّدة بالانقراض بسبب الجفاف واستفحال الجوع والعطش؟!
عُنق الزُّجاجة الآخر لدى مجاهدي الفيسبوك:
لم تكن الثَّورة الزِّراعيَّة النِّيوليثيَّة أوَّل مرحلة من مراحل عنق الزُّجاجة؛ فقد سبقتها مرحلة خطيرة من مراحل هذا المصطلح التَّاريخيِّ، حين قضينا نحن-العقلاء من إنسان الكلام كما نزعم-على أجدادنا من (النِّياندرتال) و(الهومو إيريكتوس) طمعًا بخيرات المجال الحيويِّ في سنوات القحط والجفاف، ولن تكون هذه الثَّورة الزِّراعيَّة النِّيوليثيَّة آخر مرحلة من مراحل عنق الزُّجاجة؛ فبعد أن خرجت البشريَّة من عنق الزُّجاجة في تلك المرحلة الخطيرة جدًّا ستنفتح مجدَّدًا أبواب التَّقدُّم والمدنيَّة، وستنفتح معها أبواب جهنَّم أو أبواب العنف الحضاريِّ الموازي على مصاريعها كلِّها، ستنشب الحروب المدمِّرة، وتُدَقُّ طبولها بين آونة وأخرى، ولن تضع الحرب أوزارها إلَّا في هُدَنٍ مؤقَّتة أشبه بمراحل استعداد لحروب ضارية جديدة بحسب الفيلسوف الألمانيّ إيمانويل كانط (1724-1804)؛ فأيُّ تغيُّرات جذريَّة خطيرة على مستوى المجتمعات البشريَّة حملتها هذه الثَّورة الزِّراعيَّة النِّيوليثيَّة؟ وكيف سيطال تأثيرها كلَّ فرد من أفراد هذه المجتمعات؟ كيف سيظهر مفهوم الأسرة أو العائلة؟ وكيف ستتطوَّر الشَّرائع الوضعيَّة والقوانين البشريَّة خدمة للمجتمعات الزِّراعيَّة الأولى والمدنيَّة القادمة؟ كيف ستظهر وتتطوَّر الأديان خدمة لهذه المفاهيم والتَّطوُّرات الجديدة؟ كيف سوف يُوَظِّف الدِّين والتَّديُّن في الصِّراعات الأيديولوجيَّة خلال أكثر من عشرة آلاف سنة قادمة من تاريخ البشريَّة؟ وأيُّهما أسبق الدِّين أم الأيديولوجيا؟ وهل الدِّين يُغذِّي الصِّراع الأيديولوجيَّ أو الأيديولوجيا تُزكي الصِّراعات الدِّينيَّة وتُضرم نيرانها، وتزيد أوارها؟ بالتَّأكيد هذه أسئلة مهمَّة سنحاول الإجابة على كثير منها في المقالات القادمة؛ ولكن، وقبل الختام، بقي عليَّ أن أثني على كثير من مجاهدي الفيسبوك من مُناصري أهلنا الأبرياء العُزَّل في غزَّة، لا سيَّما أولئك الَّذين اهتدوا إلى منشور خوارزميٍّ رهيب، نسخوه على صفحاتهم، وتمرَّدوا من خلاله على قوانين مؤسِّسي شركة الفيسبوك، تمرَّدوا على الحظر المفروض عليهم وعلى منشوراتهم، وانطلقوا للرِّباط في ساحات المدن الآمنة البعيدة غزَّة مرَّة، وفي ساحات الفيسبوك والنَّشر في المواقع الإلكترونيَّة ومنصَّات التِّيكتوك مرَّات أخرى، ونسوا أنَّ الفيسبوك والواتساب وشبكة الإنترنت كلَّها، ومواقع التَّواصل الإلكترونيِّ ومنصَّاتها وتطبيقاتها هي تحت هيمنة أعدائهم الَّذين يُجاهدون ضدَّهم (بالكلام فقط)، وأنا-ههنا-لا أقول: إنَّ المهيمنين على اتِّصالات الإنترنت في وقتنا الرَّاهن قد اخترعوه من الفراغ أو من العدم أو من ذكائهم الشَّخصيِّ المحض، لا أقول ذلك أبدًا؛ لأنَّهم طوَّروا بعضًا من منجزات حضارتنا المشرقيَّة العظيمة؛ فكانت شبكة الإنترنت، وليس عندي أدنى شكَّ بأنَّ الاستيلاء على رُقم إيبلا ومدوَّنات مصر والعراق ومخطوطات الأندلس وتطوير أنظمة التَّدوين والتَّشفير في تلك الرُّقم والمدوَّنات والمخطوطات قد أدَّى إلى تراكم معرفيٍّ كبير، قاد تطويره فيما بعد إلى انفجار ثورة معرفيَّة رقميَّة عملاقة، نعاني منها الأمرَّين في وقتنا الرَّاهن، وكم كان عالم الفيزياء الفرنسيُّ بيير كوري (1859-1906) الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء سنة 1903 محقًّا حين قال: تمكَّنَّا من تقسيم الذَّرَّة بالاستعانة بثلاثين كتابًا بقيت لنا من الحضارة الأندلسيَّة….ولو لم تُحرق كتب المسلمين لكُنَّا اليوم نتجوَّل بين المجرَّات.
ولن أنسى أن أعدكم بعنوان مثير للمقال القادم، سوف أحاول فيه الإجابة على سؤال مثير آخر يقول: لماذا انتشرت التِّلال الكثيرة بجوار كوبكلي تبَّه (Göbekli Tepe)؟ ولماذا امتدَّت هذه التِّلال لتغطِّي العالم القديم في بلاد الشَّام والرَّافدين والجزيرة العربيَّة والأناضول ومصر الفرعونيَّة والمغرب العربيَّ؟