التعليم الجامعي الخاص: إشكاليات ومقترحات (نحو مؤشر سوري للتعليم العالي)
مقترحات نضعها بين يدي وزارة التعليم، بناء على ما شهدناه من إشكاليات قائمة في التعليم الجامعي الخاص

د. عبد القادر نعناع [1] – العربي القديم
يحتاج التعليم الجامعي إلى كثير من المراجعات في المرحلة الحالية، سواء في شقه الحكومي أو الخاص، لما يعانيه من حالة ترهل أو فساد أو انخفاض كفاءة المخرجات التعليمية، وسوى ذلك من أزمات ربما يمكن اعتبارها أزمات بنيوية موروثة، تحتاج إلى برنامج معالجة طويل الأمد. ويسلط هذا المقال الضوء على أبرز إشكاليات التعليم الجامعي الخاص، رغبة في تقديم رؤية أو مقترحات تساهم في خطة وزارة التعليم العالي للنهوض بالتعليم الجامعي. وعليه فإننا عوضاً عن الاكتفاء بالتطرق للإشكاليات القائمة، نحاول الخروج منها عبر اقتراح خلق “مؤشر التعليم الجامعي السوري”، حيث نقدم عشر مفردات في هذا المؤشر، يمكن إضافتها إلى مؤشرات أخرى، بناء على تجربة، خبرنا فيها بعض هذه الإشكاليات التي نحاول معالجتها في هذا المقال (مؤشرات فرعية).
بداية، شاعت في سنوات الثورة شهادات ثانوية لم يتم التدقيق في صحتها ومصدرها، استطاع أصحابها التسجيل في بعض الجامعات الخاصة، والحصول على شهادة جامعية. ويبدو أن بعض أصحاب هذه الشهادات تسربوا إلى وظائف لم يكونوا مؤهلين لها. ونقترح اشتراط معادلة الشهادات الصادرة من الجماعات الخاصة لتطابق الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية، على شرط أن تبدأ المعادلة من التأكد من شهادة الثانوية العامة. وقد تبدو هذه المهمة شاقة، لكنها ضرورية لإعادة ضبط المشهد العلمي السوري. ويبدو أن الأمر أكثر إشكالية في مرحلة الدراسات العليا، والتي شهدت بدورها ذات الإشكالية، لحصول البعض على درجات علمية عليا دون مؤهلات كافية، أو وفق الإشكاليات اللاحقة. (مؤشر السلامة القانونية)
أما العنصر الثاني، فيصب في ذات السياق، حيث أن بعض الكوادر التعليمية حصلت بدورها على شهادات جامعية (إجازة، ماجستير، دكتوراه)، إما بناء على شهادات ثانوية غير صحيحة، أو من جامعات غير معترف بها/غير معتمدة، عدا عن شيوع بعض الشهادات العلمية في كثير من الاختصاصات طيلة السنوات الماضية. لذا يبدو من الضروري التأكد من مؤهلات المدرسين في الجامعات الخاصة، والتأكد من صحة شهاداتهم الجامعية (دكاترة ومعيدين)، وأنها صادرة من مؤسسات تعليمية معترف بها. (مؤشر السلامة القانونية)
وحيث أن الطلبة السوريين تعرضوا في سنوات الثورة لضغوط في الجامعات العربية والأجنبية التي كانوا يدرسون فيها، واضطروا أحياناً للانقطاع والعودة (أكثر من المدة التي تنص عليها لوائح وزارة التعليم العالية)، وهو نتيجة تأخر صدور التأشيرات اللازمة لذلك (بسبب الجنسية السورية)، فإننا نقترح على الوزارة مراجعة سياسة التعديل، بما يتفق مع عنصري: السلامة الأكاديمية والظرف السوري الاستثنائي، وذلك من خلال وضع آلية معادلة تتناسب مع هذا الوضع، مع الحفاظ على اشتراط “اعتماد الجامعات العربية الأجنبية”.
أما العنصر الثالث: وهو اختصاص أساتذة الجامعات، حيث يفترض تطابق اختصاص الأساتذة الجامعين مع اختصاص الفرع/الكلية/المقررات، إلا أن بعض الكليات تشهد غياباً شبه تام لأساتذة يحملون ذات الاختصاص (كأن يغيب عن كلية العلوم السياسية دكاترة العلوم السياسية)، عدا عن ضرورة أن يكون عدد أصحاب الاختصاص كافياً لافتتاح هذه الكلية. وسبب ذلك، أن أصحاب الشهادات غير المعتمدة أو أن الكفاءات التي لم تجد فرصة للتعليم في اختصاصاها، سطت على اختصاصات أخرى، ما أدى إلى تراجع حاد في قيمة المخرجات العلمية. (مؤشر عدد الأساتذة المختصين نسبة إلى الطلاب في الاختصاص).
وهذا يترافق مع الاشتراط الرابع، وهو تقييم المناهج العلمية التي تقوم هذه الجامعات بتدريسها، وحيث أن بعض المدرسين غير مؤهلين لهذه العملية، فقد اعتمدوا إما على ما يجدونه مطروحاً في الإنترنت ودون مراجعة علمية له (غير قادرين عليها)، أو أنهم حافظوا على عناوين المقررات وحرّفوا مضمونها بما يتوافق مع إمكانياتهم المحدودة (كأن تحول مادة التنمية السياسية إلى مقرر ديني مع الاحتفاظ بتسمية المقرر مثلاً)، وتظهر الإشكالية خصوصاً عند تكليف حملة الإجازة أو الشهادات العليا المزورة بتدريس هذه المقررات، مع غياب رقابة أعلى داخل الكلية/الجامعة. (مؤشر جودة المقررات العلمية)
وفي ذات السياق نضع الاشتراط الخامس، وهو أن تكون نسبة التوافق في عنوان المقررات مرتفعة بين قطاعي التعليم الحكومي والخاص، وهو شرط أساسي للمعادلة، وذلك يضمن أن الجامعات الخاصة متقاربة في سياساتها التعليمية مع خطة وزارة التعليم العالي، في حين أن لها حرية اختيار مضمون المقرر. ثم أن تكون ساعات هذه المقررات مقبولة وفق نظام التعليم، ففيما تقدم بعض الجامعات مقررات في 45 ساعة فصلية، فإن أخرى قد لا تتجاوز العشرين ساعة في الفصل، وهو ما يخلق بوناً كبيراً في مستوى خريجي الجامعات، لكن مع فرص وظيفية متساوية. (مؤشر كفاءة المقررات العلمية)
ولتقييم مخرجات العملية التعليمية سادساً، لابد من مراقبة الامتحانات أو عينات منها، للتأكد من سلامتها وشمولها ونزاهتها، سواءً أكانت فيزيائية أم افتراضية. ومراجعة علامة الحد الأدنى للنجاح، وعدد المقررات المسموح حملها إلى السنوات اللاحقة. (مؤشر السلامة الامتحانية)
ولضمان جودة العملية التعليمية سابعاً، يحتاج الأساتذة العاملون في القطاع الخاص، إلى ضمان حقوقهم، عبر اشتراط وجود عقود عمل (مؤقتة أو فصلية أو سنوية)، واشتراط حد أدنى من الأجور، وهو ما يغيب عن بعض الجامعات الخاصة. عدا عن ضرورة وضع قوانين ناظمة لعمليات المعادلة والترفع العلمي الخاصة بالأساتذة ومن خلال الجامعات التي يعملون فيها. على أن يتم مراجعة هذه العقود من قبل فرق التقييم لدى الوزارة، والتأكد من عدد الساعات التي يكلف بها الأساتذة في عموم الجامعات، حيث أن بعض الأساتذة قد يكلف بساعات تتراوح بين 100-300 ساعة شهرياً، عبر العمل في عدة جامعات، ولا يبدو ذلك واقعياً، وهو إما نتيجة افتتاح كليات دون وجود كوادر كافية ما يدفع للاعتماد على ذات الكوادر في كل الجامعات، أو نتيجة عمليات محاصصة متبادلة للساعات التعليمية. (مؤشر الحقوق المهنية)
وفيما يحصل قلة من الأساتذة على دخل مرتفع بناء على العنصر السابق، فإن كثيراً من الأساتذة تنخفض أجورهم إلى حدود دنيا لا تتلاءم مع طبيعة المهمة التعليمية، فيما تبدو الحجة الأكثر رواجاً هو انخفاض رسوم التسجيل الجامعي، ما يدفع الجامعات إلى خفض أجور الكوادر التعليمية. وبالأساس، تعود سياسة عملية تخفيض الرسوم إلى المنافسة المتزايدة بين الجامعات الخاصة في ذات المناطق الجغرافية. ما يعني أن الاشتراط الثامن مرتبط بالتوزع الجغرافي للجامعات ووضع حد أدنى للرسوم الجامعية، حتى يمكن ضمان كفاءة المخرجات العلمية. وعوضاً عن الانتشار الأفقي للجامعات في ذات المناطق، نقترح التنوع العامودي، بمعنى التخصص الدقيق للجماعات في فروع علمية بعينها، عوضاً عن تكرار ذات الكليات في نطاق جغرافي لا يسمح بذلك، وربط هذا التنوع العامودي بحاجة البلاد من اختصاصات (مثلاً: الطاقة البديلة، التنمية السكانية، تخطيط المدن، الإدارة الذكية، الدراسات المستقبلية)، أي ربط البرامج التعليمية بسوق العمل الوطني والدولي. (مؤشر كفاءة التعليم)
وحيث أننا وفق ذلك نقترح فكرة الجامعات المختصة، عوضاً عن الجامعات الشاملة، فإن هذا يدفعنا تاسعاً إلى اشتراط وجود مخرجات بحثية إلى جانب المخرجات العلمية، من خلال اشتراط وجود مجلة علمية محكمة متخصصة (وفق اختصاص الجامعة) يتم تقييمها والاعتراف بها من قبل الوزارة، واشتراط عدد محدد من المؤتمرات العلمية التي تقدمها الجامعة في اختصاصها، وما يتصل بذلك من مخرجات لازم لرفع الكفاءة العلمية، من مثيل: عدد المؤلفات التي تصدرها الجامعة سنوياً. (مؤشر البحث العلمي)
ويرتبط بذلك عاشراً، كفاءة البنية التحتية للجامعات، من مرافق وطرقات ومختبرات ومساحات خضراء. ويشمل عنصر الكفاءة: كفاءة التشغيل، والكفاءة البيئية. بما يضمن استدامة الجامعة والعملية التعليمية. وخصوصاً أن بعض الجامعات لا يتجاوز مبنى سكنياً صغيراً لا يكاد يتسع للطلاب المسجلين في الجامعة. (مؤشر كفاءة البنى التحتية).
هذه الاشتراطات/المؤشرات العشرة السابقة، إنما هي مقترحات نضعها بين يدي وزارة التعليم، بناء على ما شهدناه من إشكاليات قائمة في التعليم الجامعي الخاص. لكنها بالتأكيد غير كافية وحدها لبناء مؤشر سنوي عام للتعليم الجامعي السوري، فهناك الكثير من المؤشرات الفرعية التي يمكن العمل عليها أيضاً، لتعزيز المؤشر العام، من مثيل:
- مؤشر فاعلية الإرشاد الأكاديمي والدعم النفسي للطلاب: وخصوصاً أن الطلاب السوريين في كافة المناطق، بحاجة إلى دعم نفسي بعد ما مروا به في السنوات الماضية.
- مؤشر المشاركة الطلابية في صنع القرار الجامعي: حيث يعزز هذا التوجه العام لسورية الجديدة، في ترسيخ المشاركة السياسية وتحمل المجتمع لمسؤولية المشاركة في إدارة الدولة وإعادة الإعمار.
- مؤشر استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم والتقييم.
- مؤشر الانفتاح على التعاون الدولي والبرامج المشتركة، واتفاقيات الشراكة المحلية والدولية: وهذا ما يعزز عملية الانفتاح العلمي السوري على الأوساط العلمية العربية والأجنبية، ويقلص الفجوة العلمية.
- مؤشر تشجيع الريادة والابتكار وريادة الأعمال في الأوساط الطلابية: وهو مؤشر ضروري للتخلص من التعليم التقليدي، وجعل العملية التعليمية أكثر إنتاجية.
- مؤشر الالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة الإدارية والأكاديمية وحماية البيئة.
- مؤشر أثر الجامعة في خدمة المجتمع المحلي: وذلك لتحميل المؤسسات الأكاديمية جزءاً من مسؤولية إعادة بناء الدولة/المجتمع.
[1] أستاذ جامعي سوري متخصص في العلاقات الدولية والعلوم السياسية، وعميد كلية علوم سياسية سابق، وباحث متخصص في شؤون الشرق الأوسط والشؤون الدولية.
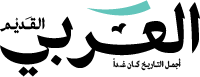
مشكورا دكتور نعناع علة هذه المؤشرات لرفع مستوى التعليم العالي
أضيف عمل آخر للوزارة أن تقوم بفحص شهادات الأساتذة في كافة الجامعات السورية ، لأن تزوير الشهادات انتشر بشكل مرعب خاصة سنوات الثورة ، ظهرت مكاتب متخصصة بتزوير الوثائق والشهادات الجامعية . وأيضا التدقيق بشهادات الأساتذة خريجي رومانيا خاصة وجميع شهادات البعثات التعليمية لتلك الدول . أعرف ناس راجو بعثة لرومانيا مجموعهم بالبكالوريا 110 ومادون ، كان من المظليين والشبيبة وغيرهم بلا معدل قبول حتى بجامعات سورية .