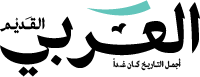أم المدن سرمين: متحف إدلب الحي ومكتبتها المكتظة بالهجران
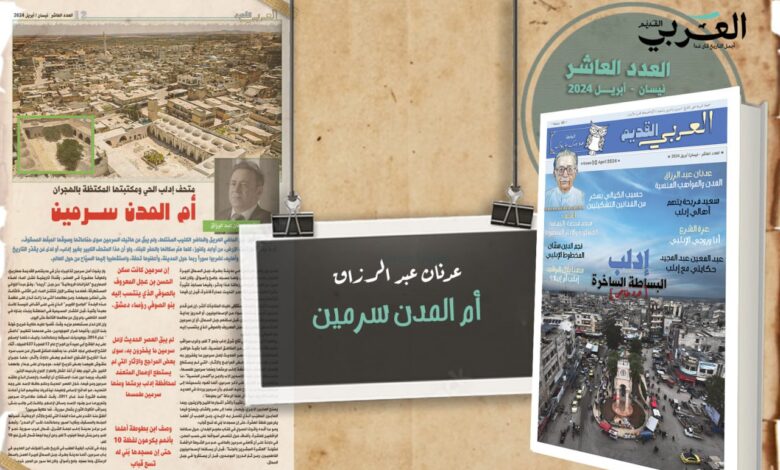
عدنان عبد الرزاق – العربي القديم
بون سحيق بين الماضي العريق والحاضر الكئيب المختلط، ولم يبقَ من هاتيك السرمين سوى حمّاماتها وسوقها المبلّط المسقوف، أو ما يخرج من تحت الأرض، من أوابد وكنوز، كلما همّ سكانها بالحفر للبناء. ولو أن هذا المتحف الكبير بغير إدلب، أو لدى مَن يقدّر التاريخ وأهليه، لضربوا سوراً ربما حول المدينة، وأعلنوها تحفة، واستقطبوا إليها السيّاح من حول العالم.
فسرمين وفق المراجع: هي مدينة بطرف جبل السماق كبيرة العمل، واسعة الرستاق، ولها مسجد جامع وأسواق. وكان لها سورٌ من الحجر خرب في زماننا هذا ودثر، وفيها مساجدُ كثيرةٌ داثرة كانت معمورة بالحجر النحيت عمارة فاخرة، قيل إن فيها ثلاثمائة وستين مسجداً”.
وحينما تتبحّر بالبحث، ستتالى عليك المفاجآت أكثر، إن عن قدم سرمين أو من سكنها، سواء من الإسماعيليين، أو الدروز بداية وصولهم للشام من اليمن، قبل سكنهم جبل السماق، أو إن سرمين كانت سكن الحسن بن عجل المعروف بالصوفي الذي ينتسب إليه بنو الصوفي رؤساء دمشق.
وبالعودة إلى سرمين التي تقع شرق إدلب بنحو 7 كلم، وغرب سراقب بالمسافة نفسها، فهي من المناطق المنسية، كما بقية حواضر المحافظة، ولم يبقِ العصر الحديث لأهل سرمين ما يفخرون به لقدم بلدهم، سوى بعض المراجع والآثار، التي لم يستطع الإهمال المتعمّد، لمحافظة إدلب برمتها ومنها سرمين، وتسميتها خلال حقبة الأسدين، الأب والابن ب”المدن المنسية”، ما يدفعهم ومنذ الإتيان على ذكر سرمين، أنها تعود بتسميتها إلى بن ليفر بن سام بن نوح عليه السلام، وأن سرمين وردت في العديد من كتب التاريخ، حيث قال عنها الرحالة “ابن بطوطة”: «إن سرمين ذات بساتين كثيرة وأكثر أشجارها التين والزيتون، وبها يُصنع الصابون الآجري، ويُصدّر منها إلى مصر والشام، ويُصنع فيها الصابون المطيّب الذي تغسل به الأيدي، ومن العجب أن أهلها يكرهون لفظة العشرة، حتى إن مسجدها بُني له تسع قباب»، وهو ما أكّده ياقوت الحموي في كتاب معجم البلدان، حول سكانها الرافضين للعشرة، وأضاف حول تخصص أسواقها على حسب المهن، في دلالة على أن قاطني سرمين بالماضي، هم من الشيعة الرافضة لمقولة “العشرة المبشرين بالجنة”، قبل أن يسكنها الإسماعيليون الفاطميون، ومن ثمّ الدروز الموحدون، قبل أن يستقروا في جبل السماق .
ولا يفوت أهل سرمين تذكيرك بأن في مدينتهم القديمة صهاريج، وكهوفاً محفورة في الصخر، وقناة تاريخية لنقل الماء لهذه الصهاريج “الخزانات الرومانية” من جبل “أريحا”، وفق مبدأ الأواني المستطرقة، فعندما يمتلئ الأول تنتقل الماء إلى الثاني، فالثالث حتى تمتلئ جميعها، ومن معالمها التي ما زالت تدل على عظمة هذه البلدة “الجامع الكبير” الذي بُني على أنقاض كنيسة كانت معبداً وثنياً، قبل انتشار المسيحية في المنطقة وجُدّد بناؤه في العهد الفاطمي، ولم يزل من معالمها القائمة حتى اليوم .
وإن كان لدى مستمعهم مزيد وقت، قصّوا عليه حكاية ضريح خولة بنت الأزور، وأخيها ضرار الموجودين، حتى هدمهما تنظيم “داعش ” عام 2014، ويعيدونك لسوقها وحماماتها، وكيف دخلها الإسلام على يد الفاتح أبي عبيدة بن الجراح عام 17 للهجرة 637 للميلاد، أثناء الفتح الإسلامي لبلاد الشام .
ما يدفعك كمتلقٍ للسؤال عن سبب سرد هذا التاريخ الشفوي المدعّم ببعض دلالات وآثار، منها حجران منقوش عليهما بعض تاريخ البلد، موجودان على جدار جامعها الكبير حتى اليوم، بعد أن أخذ الشكل والطراز الأموي بترميمه الأخير.
لتعرف، وربما دون عناء الاستنتاج، أن الإقصاء والإهمال الذي عانته سرمين ومن فيها، خلال العصر الحديث وحكم حافظ الأسد على وجه التحديد، هو الدافع الأساس لأهليها، ليذكروك بماضيهم الذي أعادت بعضه الثورة منذ عام 2011، وقت شغلت مظاهرات سرمين وتحريرها من جنود الأسد وسائل الإعلام، وكانت إلى جانب بنش، وسراقب الثالوث الثوري بشمال سورية.. فما حكاية سرمين؟
أطلق منذ القدم على هذه البلدة التي تعج بالآثار الرومانية، كسوقها المبلط والمسقوف وبقايا السور وحماماتها، لقب “أم المدن”، وتبعد عن مركز مدينة إدلب لجهة الشرق، شمال غرب سورية، نحو 7 كلم، وعن بنش لجهة الجنوب 5 كلم، وعن أريحا لجهة شمال شرق نحو 10 كلم.
وجاء في كتاب، (بغية الطلب في تاريخ حلب) للمؤلف ابن العديم، في باب سرمين، أنها مدينة بطرف جبل السماق كبيرة العمل واسعة الرستاق، ولها مسجد جامع وأسواق. وكان لها سور من الحجر خرب في زماننا هذا ودثر، وبها مساجد كثيرة داثرة كانت معمورة بالحجر النحيت عمارة فاخرة، قيل إن بها ثلاثمائة وستين مسجداً، ليس بها الآن مسجد يُصلى فيه إلا المسجد الجامع، وأكثرها الآن إسماعيلية، ولهم بها دار دعوة. وكان يسكن بها الحسن بن عجل المعروف بالصوفي الذي ينتسب إليه بنو الصوفي رؤساء دمشق، وكان جد أبي الحسن علي بن مقلد بن منقذ صاحب شيزر لأمه، ولما قوي أمر الإسماعيلية بسرمين تحول إلى حلب فسكنها، وداره بحلب هي الدار التي وقفها شيخنا قاضي القضاة أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم مدرسة لأصحاب الشافعي، تجاه المدرسة النورية، وخرج منها فضلاء وشعراء.
وذكرها أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب في كتاب البلدان في تسمية كور جند قنسرين والعواصم فقال: كورة سرمين وأهلها من قيس. وكان بقربها في جبل بني عليه حصن منيع يقال له كفر لاثا، وكان الفرنج قد استولوا عليه وعلى سرمين في سنة ست وسبعين وأربعمائة.
وذكر الباحث السوري، فائز قوصرة في كتابه (الرحالة في محافظة إدلب)، إن مدينة إدلب الحالية كانت قرية تتبع سرمين في ما مضى، وبدأت أهمية إدلب الحالية بالظهور، بعد أن اهتم بها الصدر الأعظم أحمد باشا الكوبرلي (1583-1661)، وعين قائداً للحامية فيها اليوزباشي حمود الدليمي، وفوضه في تنفيذ خطته لتطوير إدلب، فجعل مواردها وقفاً على الحرمين الشريفين، وأعفاها من الرسوم والضرائب، وأقام فيها مباني ما زالت قائمة إلى اليوم، فقصدها الناس من جسر الشغور، وسرمين والقرى المجاورة، فاتسعت وازدهرت على حساب إدلب الكبرى التي طوي ذكرها. وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر غدت إدلب تتبع جسر الشغور، ثم أُتبعت بأريحا، ثم صارت مركز قضاء عام 1812م، ثم مركز محافظة في عام 1960م
وقال بعض الرحالة، كالفرنسي كورانسيز الذي زار سرمين عام 1809 للميلاد: إن أصل مسجدها الكبير كنيسة، وعرفنا أنه في أصله دير بموجب الحوليات السابقة، وخاصةً الكتابة في الجدار الشرقي، في الباحة بعد المدخل .
كما قال فيها الآثاري الفرنسي، فان برشم، الذي زارها عام1895 للميلاد في كتابه “رحلة في سورية”: “سرمين المنسية هي مدينة صغيرة كمدينة معرة النعمان، امتلكت يوماً ساعة ازدهارها، وهي الآن في انحدار.. الجامع الكبير مبنيّ على الطراز الكلاسيكي فناؤه مستطيل ومحدد بأروقة ذات محاريب”.
ووصفها الرحالان، جون أدولف وايسامبرت إيميل، عام 1861 بقولهما: “سرمين Sermein: بلدة قديمة، ولكنها اليوم تكاد تكون مهجورة، نجد فيها الكثير من الصهاريج، ويحيط بها كهوف محفورة في الصخر يستخدمها السكان، لكن الأميز فيها وجود قاعات فيها العواميد الضخمة المنحوتة”.
ولم يبقَ لسرمين من كل آثارها اليوم، سوى الجامع الكبير، مساحته 2500م2 (50×50م) الباحة 50×35م والحرم 50×15م، في أصله معبد، ثم كنيسة يستدل عليها، من خلال حجر بازلتي موجود حتى الآن، على الجدار الشمالي من الباحة الخارجية، والحجر مستطيل الحجم 80×62سم نُقش عليه نحت نافر لإطارين على شكل مستطيل، ضمن قرص في داخله صليب متآكل، ويبدو أنه جرن معمودية، قد استخدم هنا في البناء الخارجي، وبجانبه رسم لشخص، قد يكون لأحد نسّاك الدير. ويرجّح باحثون أنه موقع لدير سرمين المذكور في الوثائق السريانية في متحف لندن باسم دير “بسرمين قيراتا”.
وكل ماعدا هذا المسجد، محته السياسة الاشتراكية لنظام الأسد، ليأتي بعدهم تنظيم الدولة “داعش”، ليجهز على ما فاض، من قبور ومنحوتات، ويوقف عمل الحمّامَين الروميين اللذين كانا يعملان، ويستقبلان الأهالي والسياح، حتى مطلع الثورة عام 2011، ربما لأن في ذلك تحريماً بشرع داعش…أو ربما لأن الاحتفاظ بالآثار واستحمام الرجال، مكروه على الأقل .
يعود أهالي سرمين اليوم، بعد أن فتحوا بيوتهم لمهجري ريفي دمشق وحمص، ممن طالتهم سياسة النظام السوري بالتغيير الديموغرافي، يعودون لبعض الوثائق وشهادات كبار السن، ليتغنوا بماضي بلدتهم سرمين التي قتلها صنّاع حاضرهم، قبل الثورة وبعدها.
__________________________________________
من مواد العدد العاشر من (العربي القديم) الخاص بإدلب، نيسان / أبريل 2024