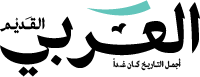اضطراب الكرب وصداه المسافر عبر الأجيال!
ينشأ نتيجة تراكم الصدمات النفسيَّة، وتكريس الشعور بالأسى والحرمان العائد إلى فترات الطفولة
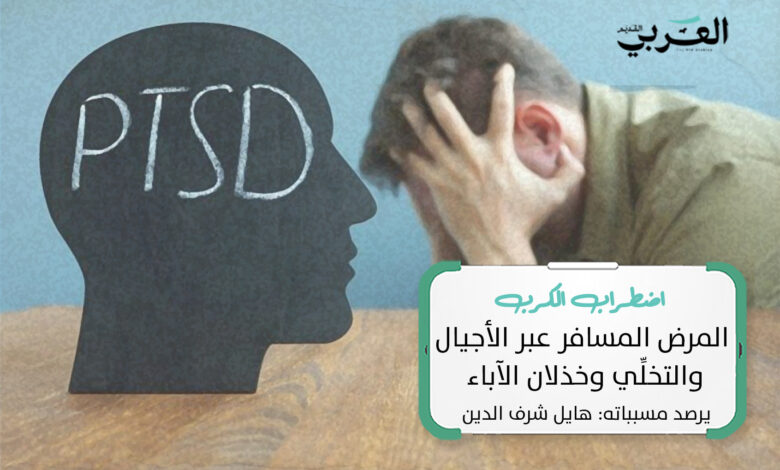
هايل شرف الدين – العربي القديم
يأتي اضطراب الكرب على شكل دفعات من مشاعر الضيق العاطفيّ والجسديّ والكوابيس الليليَّة. يحصل هذا النوع من الاضطرابات بعد حدوث مشكلة كبيرة مثل: مشاهدة المرء جريمة قتل، أو المشاركة في خوض حرب، أو رؤية كارثة طبيعيَّة، أو حادث أليم.
على سبيل المثال: شابٌ مراهق وأثناء مشاهدته لجريمة قتل واقعيَّة على شاشة جواله، شعرَ بحالة من الرعب الشديد لدرجة دخوله في حالةٍ من التماهي مع ما يراه، والقيام بتقليد لاإراديّ لحركات وردَّات فعل الشخص الواقع تحت عقاب الإعدام وتقمُّص حالته للحظات. وقد أضحى هذا المشهد، مع مرور الوقت، ضيف ذهنه الدائم الذي يأبى المغادرة.
وبالمحصِّلة تسببت له ذكرى هذا المشهد إعاقة على مستوى السلوك الاجتماعي، حيث بات يتحاشى رؤية الناس وزيارة الأماكن تجنُّباً لوجود أي قاسم مشترك يعيد إلى ذهنه ذلك المشهد المروّع الذي رآه. لينتهي به المطاف في عيادة الطبيب النفسيّ.
إلى ذلك يمكن لاضطراب الكرب أن ينشأ نتيجة تراكم مجموعة من الصدمات النفسيَّة، وتكريس الشعور بالأسى والحرمان العائد إلى فترات الطفولة كالتخلِّي والخذلان الحاصل من مقدم الرعاية كالأب مثلاً. أو بعد البلوغ من مصدر الحب كالزوجة.
تعتبر الاستجابة النفسيَّة للضغوط والمشاكل أمر طبيعيّ وذلك عندما تكون على شكل ردَّات فعل نفسيَّة وسلوكيَّة تحاول في مجملها مجاراة واحتواء الأحداث ذات الأثر الشديد على الذهن… لكن هذا النوع من الاضطرابات يكون عمليَّاً فوق قدرة المرء على احتماله والتعامل معه.
حيث يتراوح اضطراب الكرب من اضطراب التوتُّر الحاد، والذي عمره الزمنيّ لا يزيد عن ثلاثة شهور إذا ما تمّت متابعته ومعالجته، إلى اضطراب ما بعد الصدمة غير المُعقَّد، مروراً باضطراب ما بعد الصدمة الانفصاليّ، أي المُرفَق بأعراض مَرَضيَّة قريبة من اضطراب الهوية التفارقيّ والفُصام، وانتهاءً بالاضطراب الأشدّ خطورةً وهو: اضطراب ما بعد الصدمة المُعقَّد. وهو معقَّد لكون أعراضه تتداخل وتشترك مع أمراض ذُهانيَّة أخرى كاضطراب الشخصيَّة الحديَّة، واضطراب ثنائيّ القطب.
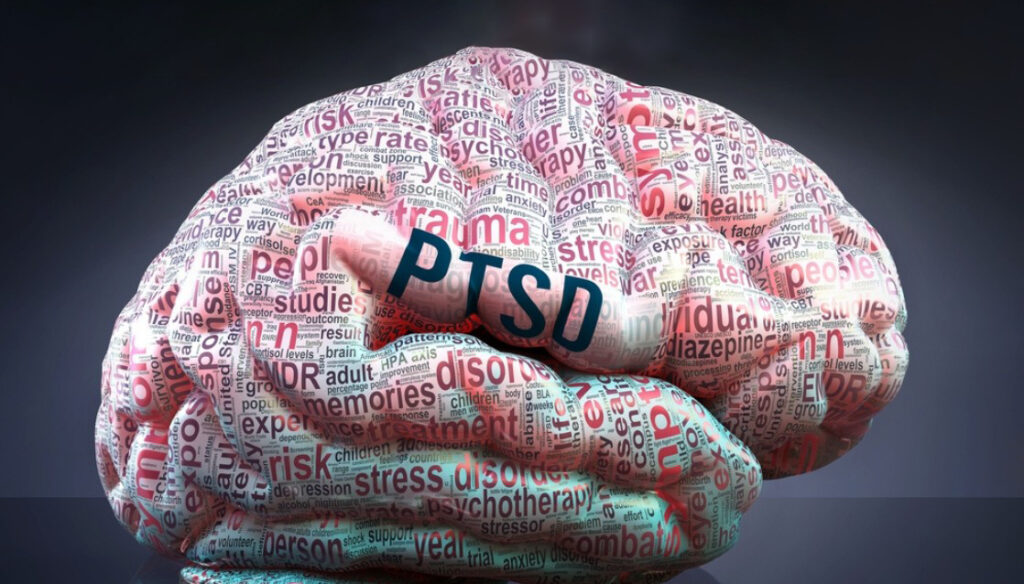
اضطراب الكرب أو الاضطراب التالي للصدمة يرمز له علمياً بـ: (PTSD)
لعلاج هذا النوع من الاضطرابات لا بد من تظافر مجموعة من تقنيات العلاج: كالعلاج الدوائيّ، والعلاج المعرفيّ، والعلاج النفسيّ. ومن أهم طرائق العلاج النفسيَّة هنا:
العلاج بالتعرُّض أي بتعريض المريض بشكل مخفَّف وتدريجيّ للسبب الذي أدى إلى حصول هذه الاضطراب، وعلى مراحل بغية تذليل السبب المؤدي إلى الإشكال الذهنيّ، وتمييع الحالة المتصلِّبة فيه.
كما وتعدّ مشاركة مثل هكذا مشكلة مع شخص موثوق وذو كفاءة عالية أمر ضروريّ للخروج من المشكلة وصداها المُكرَّر في الذهن، عن طريق البوح له بجميع خبايا كواليس المشكلة التي تقبع في الظلّ.
هذا فيما يخصّ الاضطراب على المستوى الفرديّ، لكن ماذا بخصوص هذا الاضطراب على المستوى الجماعيّ، وماذا عن صداهُ المسافر والمتكرر عبر الأجيال؟!
حيث نلحظ نوع محدد من الرُهاب يعاني منه مجتمع بأكمله ولا يعاني منه مجتمع آخر!
مع التنويه إلى أن لهذا المجتمع أو لهذه الأسرة الكبيرة ذاكرة أليمة نتيجة حادثة حصلت لها سابقاً وحفرت عميقاً في ذاكرتها، فجاء الرّهاب متجانساً مع الأثر الذي تركته.
والأمر الغريب هنا هو: في أنَّ من شهدوا الواقعة هم أموات اليوم!
فكيف يعيش الرُهاب المتعلّق بها أفراد آخرون ولدوا بعد هذه الواقعة بكثير؟!
تبدو المسألة أكبر بكثير من مجرد تبنّي الحالة أو تقصُّد تذكرها!!
إن صدقت رؤية سيغموند فرويد حول “اللاوعي السُلاليّ” أي الإقرار بانتقال الحالة الانفعاليَّة من جيل لآخر بتوارثٍ بيولوجيّ، قد تقدم لنا تفسيراً مُقنعاً لتأثُّر مجتمع بأكمله بتجربة مؤلمة أو كارثة حصلت في زمنٍ قديم، ولا يزال أفراد هذه الجماعة يعيشون الواقعة “انفعاليَّاً” كما ولو أنها حصلت اليوم.
أو ظهور مشاعر القلق غير المبرَّر والخوف لدى مجتمعات كانت قد شهدت في زمن ما كارثة طبيعيَّة مروّعة لكن من خلال جيل سابق لم يتبقى منه أحد. وقد تمَّ توارث هذا القلق لا شعوريَّاً من جيلٍ إلى جيلٍ آخر!
وليس المقصود هنا قيام جماعة معيَّنة بممارسة تقليد ما أو طقس جماعيّ، والتباكي على الأطلال أو ما شابه ذلك، لا بل في عَيش هذه الحالة وهذا القلق فعليَّاً.