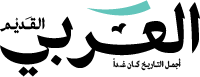مقامات أمريكية | قلة الذوق وسيادة القبح والبشاعة
قلة الذوق ليست عارضاً على النظام، وليست جزئية جانبية من تكوينه، هي في الواقع من صلب كيانه
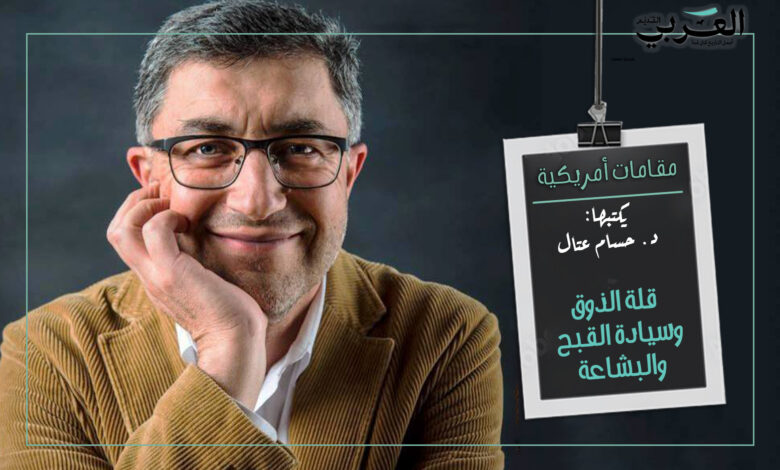
د. حسام عتال – العربي القديم
كنت مستلقياً على الصوفا في غرفة الجلوس، خريف عام ١٩٧٨ أقرأ عدد (تان تان) الأخير، عندما سمعت صوت المفتاح في قفل الباب. كانت أمي قد عادت مبكرة. ألقت حقيبتها على الأرض تم ارتمت على الكرسي القريب من الصوبا، زفرت بعمق وقالت: “قليلين أدب!”
بقدر ما هو مؤلم أن أتوقف عن قراءة تان تان (لأن ريك هوشيه كان بوضع حرج وقتها)، وجدت أنه عليَّ كابن حنون، أن أرتكس بشكل ما لما قالته أمي. أمي قلّما تنتقد أو تسب، وعبارة “قليلين الأدب” لها معنى أبعد من ظاهرها في قاموسها الخاص، فسألتها دون أن أرفع رأسي عن المجلة: “خير ماما، شو صار؟”
“ابن الكلب!” أجابت.
الأمر جلل، لأنه في ميزان لغة أمي، هذه المسبة تقارب “ابن القحبة” أو “أخو الشرموطة” عند بقية الناس، أو حتى أسوأ. فطويت المجلة جانباً واعتدلت في جلستي، منحنياً باتجاه أمي: “ماذا حصل ماما، أخبريني؟”
“المعرض.. معرض الرسم…”
كنت قد واكبت أمي في العام المنصرم وهي تحّضر لهذا المعرض: ذهبت معها للسوق لشراء الكانڤاس، وانتقاء ألوان الغواش، وفرشايات الرسم؛ راقبتها وهي ترسم لوحة بعد أخرى وأنا أحضّر لها الشاي، واستمع لذكرياتها عن أيام طفولتها عندما كانت تراقب والدها وهو يرسم، بينما هي تقرأ له جريدة اليوم، يُصلح لها لفظ الكلمات القويم، ويبين لها أسرار بناء المقالات القوية، وكيف تختلف في وسائل كتابتها عن المقالات الهزيلة” وبذلك جعل منها كاتبة ممتازة مثله، ورسامة جيدة، وإن لم تبلغ مقامه في الرسم.
“ولماذا ألغَيْتِ المعرض؟” سالتُ أمي.
“بسبب ابن الكلبة…” استخدمتْ أمي هذه المرة صفة أشد، بتأنيث الحيوان.
“من؟”
” حافظ الأسد.”
صَمَتُّ محتاراً… ما علاقة الرئيس بمعرض أمي؟ أيضا خفّفت من سرعة نقاط مازوت الصوبا، الغرفة بدت أحر مما ينبغي أو تكون.
أحستْ أمي بحيرتي فأضافت: “عندما وصلت صباحاً للمعرض وجدت أن لوحة الإعلان، أمام مركز الفنون، قد أزيلت واستبدلت بلوحة أخرى.”
“لماذا؟”
“اللوحة الأصلية كانت تحمل اسمي، أنا صاحبة المعرض.”
“و…..”
“والثانية تقول (برعاية الرئيس حافظ الأسد، قائد الفن والفنانين)”
“ومن بدّل الإعلان؟”
“قيادة الاتحاد النسائي.”
“يعني حافظ الأسد هو الرسام؟”
“هيك الظاهر… ابن الكلبة.” اصرّتْ على وصفها. كان الذي بدّل اللوحة لم يتكلف عناء وضع اسمها.
كنت قد سمعت من أمي عن خلافاتها مع قيادة فرع الاتحاد النسائي في حمص. أمي كانت نشيطة ولديها أفكار مبتكرة، وكانت تملك ثقافة واسعة، لكن زميلاتها في قيادة الفرع كنَّ يهتمنَّ بالمكاسب الصغيرة لا أكثر، ويغطين عن قصورهن الثقافي بما كانت تسميه أمي “مسح جوخ وتطبيل فاضي”. لكن رغم ذلك لم أكن أتخيل أن تصل بهم الوقاحة لمستوى إزالة اسم أمي عن معرضها.
“وبعدين؟”
“بعدين… مزقت الإعلان وشلت كل اللوحات عن الحيطان وتركت لهم استقالتي من الفرع على الطاولة.”
أردت أن أطيّب خاطرها قليلاً فقلت: “كان لازم تكتبي السبب – من أجل دور الاتحاد النسائي في الحفاظ على المصلحة العليا للوطن والمواطنين.” لكني لم أفلح في انتزاع ابتسامة من وجهها فظلت واجمة تحدق في الحائط وكأنها تستطيع رؤية ما هو خلف الجدران. لم استغرب عندما علمت لاحقاً أنها بالفعل كانت قد وضعت سبب الاستقالة: “قلة الذوق.”
قلة الذوق نادراً ما تُذكر عندما يعدّد الناس مناقب النظام الذي أرساه الأسد وابنه في سوريا. في العادة عندما ينتقد شخصاً ما النظام، يبدأ بذكر إجرام النظام، ثم وحشيته، ثم عنفه السادي، ثم فساده، ويستشهد بالاعتقالات التعسفية والاستهتار بالحقوق، والركود الاقتصادي، والتضخم الوهمي في الوظائف والمحسوبيات والرشوة، وتصنيع المخدرات، والاتجار بها، وهلم جرا… لكن في الحقيقة، قلة الذوق ليست عارضاً على النظام، وليست جزئية جانبية من تكوينه، هي في الواقع من صلب كيانه.
بسبب رغبة النظام في إبقاء الوضع الراهن في سوريا، استخدام الفن كمنصّة للتعبير السياسي، وفرض أشكالاً من الضغط الفكري على الفنانين للعمل ضمن أنماط محددة وسرديات معينة. هذا أدى إلى كبح التعبير الأصيل، وتقزيم في فهم العلاقات الثقافية المتنوعة المتجذرة محلياً منذ قرون. بالنتيجة كان ذلك حرباً على الجمال والتناسق والجاذبية البصرية: ففي العمارة، انقلبت المباني لكتل إسمنتية لا تمت بصلة لا للقديم ولا للحديث، ولا تتفق وتتناسب مع الثقافة الوطنية والمحلية (مجمع يلبغا في دمشق كمثال)، فباتت أشبه منها بالسجون وأبراج المراقبه عنها من بيوت السكن. وأصبحت النصب التذكارية للحروب والانتصارات والمنجزات مجرد مسابقات في البشاعة، ناهيك عن الوقاحة الفكرية والكذب والرياء. أما لوحات تمجيد القادة وأصنامهم فيستغرب الناظر من عدم تناسقها فكأنها نسخة مشوهه عن من يفترض أن تمثله أو تمجده، فيغدو دميماً بأنف معقوف أو فم مائل أو بحَوَل في العينين. وامتد التشويه حتى شمل أبسط التفاصيل: هل تذكرون شعار دورة ألعاب البحر المتوسط الرياضية، ذلك الطائر الذي يفترض أنه نورس لكنه يبدو وكأنه بطة من كتاب تعليمي لصغار الأطفال؟

شعار دورة ألعاب البحر المتوسط الرياضية
وكما هو متوقع، أُصيبت الفنون التشكيلية بأسوأ الأمرّين، فبدات أعمال الفنانين بالتشابه والتناغم، فاقدة كل روح وابتكار، فمعظم الفنانين باتوا يبدؤون أعمالهم بلوحة الحارة الدمشقية القديمة التقليدية، وكأنها طريقة في التعميد يمر بها كل فنان، فتظنهم قد تجمهروا في زاوية واحدة في تلك الحارة، أعناقهم مشرأبة، محاولين نقل المنظر إلى سطوح لوحاتهم… الحيطان الطينية، والنوافذ الضيقة، وأسلاك الكهرباء، والدراجات، وربما رجل بشروال عريض. ثم ينتقلون لمواضيع الفلاح والعامل والمرأة مستخدمين تقنيات الواقعية الاشتراكية، ليرسمون أو ينحتون أو يكتبون دون أي تفرد أو خصوصية. وهكذا حُرم الفنان من دوره الفعلي كقوة تحدي وصانع للتغيير، واُختزل بدلاً من ذلك في دور الدعاية للقائد، والساعي لإرضاء أصحاب السلطة والنفوذ.
في كتابه الذي يحمل عنوان “البروباغاندا” كتب إدواردز برنيز عن دور المنظومة الدعائية في تقييد خيارات المتلقي عبر تكوين ذهنية ثنائية الأبعاد: أسود-أبيض، صحيح-خاطئ… وكيف يتم تسييس الأعمال الفنية، وتدجين الفنان، مما يجعل الجمهور محاصراً ضمن فهم ثنائي (مع أو ضد)، ويحرم الفنان من سرديته الخاصة بعد أن يتبنى سردية السلطة. بسبب هذا الإجحاف استقصيت قصة سوريا بشكل فعلي وأصبحت مقيَّدة بمواقف محددة وجاهزة سابقاً. هكذا وجد الفنان المبدع نفسه، كما حصل مع أمي، منفصلاً عاطفياً ونفسياً واجتماعياً ومفاهيمياً وسياسياً وفلسفياً، عن محيطه وعن ارتباطه بالواقع المحيط به، فتدمرت بذلك التعريفات السائدة عن الجمال والصدق في التعبير وفي تقديم الأعمال، وزال كل ما هو حق إنساني جوهري بحرية التعبير عن الذات، وسادت البشاعة والقبح والتشويه، وأصبح الواقع “قليل ذوق” كما وصفته أمي في غرفة الجلوس، ذات يوم خريفي عام ١٩٧٨.