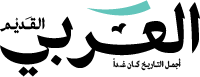آل الأطرش ودورهم السياسي في تاريخ سورية
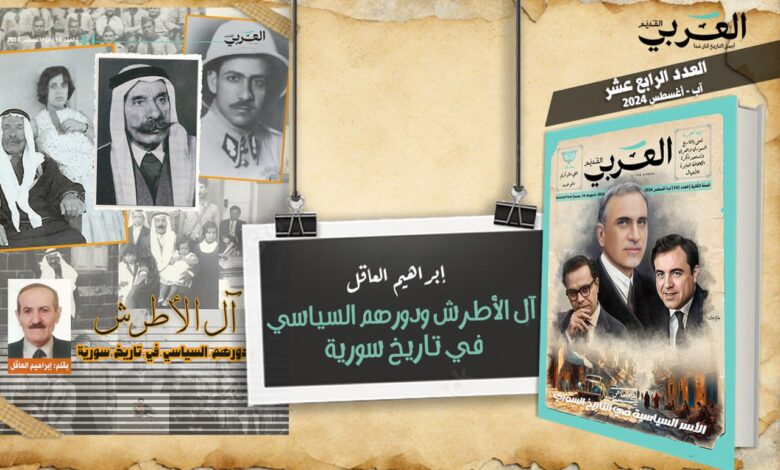
إبراهيم العاقل – العربي القديم
في عام ١١١٠ كان الفرنجة الصليبيون قد احتلوا بيروت من الأمراء التنوخيين، وهذا دفع بطغتكين حاكم دمشق السلجوقي إلى الطلب من القبائل العربية، ومنها قبيلة ربيعة التي يتزعمها المعنيون في شمال سورية الانتقال إلى الجبال المطلة على ساحل الشام، لدعم التنوخيين في قتالهم الصليبيين. وكان من بين هؤلاء آل عبد الغفار سلف آل الأطرش، وهم مجموعة من العائلات ذوي القربى المتماسكة كعشيرة قوية، قبل إسماعيل الأصم الذي عُرف بالأطرش، وكان هذا الرجل عميد تلك العشيرة التي سكنت قرية بقعسم من إقليم البلان على السفح الشرقي من جبل الشيخ المطل على فلسطين وسهل حوران بعيداً عن سطوة الشهابيين.
كانت تلك العشيرة في ما مضى تسكن في برمانا، قبل نزوحها من جبل لبنان، بسبب العداوة مع الشهابيين الذين تسللوا إلى الإمارة المعنية بتواطؤ من جانب العثمانيين، الذين برموا بثورات المعنيين الدروز، ونزوعهم إلى الاستقلال عن إدارتهم الاستبدادية. وكان هؤلاء يشكلون حلفاً مع آل معن الذين اتخذوا من قرية الريمة قرب بقعسم سكناً لهم، بعيداً عن ديار أجدادهم في جبل الشوف، وهم يعتبرون الشهابيين مغتصبين للإمارة المعنية، هذه رواية المعمرين من أولئك القوم.
اللجوء إلى جبل حوران
نحو عام ١٨٢٠ جاء من يحذرهم، أن الأمير بشير الشهابي يعد قواته لينتقم منهم، وبالفعل فقد حزموا أمرهم على اللجوء إلى جبل حوران، بعيداً عن سطوة ذلك الرجل الحاقد على المعنيين، ومن لفّ لفهم، بل وعلى الدروز عموماً؛ خاصة أنه قد تحول عن مذهب السُّنة إلى المسيحية على المذهب الماروني.
على الطريق إلى جبل حوران عبر سهل حوران، تعرض المرتحلون إلى عدوان من قبيلة ولد علي المدعومة من العثمانيين وبشير الشهابي، فقُتل عدد من رجالهم في منطقة، تُدعى مغر الطرشان، وهي لم تزل مثبتة على خريطة الطوبوغرافيا العسكرية باسم مذبح الدروز. بعد فترة من الترحال في عدة قرى طلب إليهم الشيخ الحمداني أن يسكنوا في قرية القريا.
كانت القريا في الطرف الجنوبي من جبل حوران في مواجهة الغزوات البدوية، وكان عليها أن تقوم بدور خط الدفاع عن التحضّر، وأن تدفع ضريبة الدم في مجتمع لا سلطة حكومية تحميه.
في هذا المجتمع الناشئ برزت شخصية إسماعيل الأطرش الثاني كرجل مجتمع وسياسة، ورجل حرب في الوقت نفسه. كانت بلدة بصرى الحورانية السنية التي تبعد عن القريا نحو ستة كيلومترات باتجاه الجنوب الغربي، تدفع ضريبة الخوّة لزعماء البدو القادمين من الصحراء، فقدم وفد من وجهائها إلى إسماعيل، وطلبوا منه مساعدتهم في رفع الخوّة عنهم، وبالفعل فقد سار برجاله ليلاً وفاجؤوا الغزاة، فمن قاوم قتلوه، ومن سلّم أطلقوا سراحه، ومهّد هذا لعلاقة طيبة بين القريتين في تلك الفترة من زمن عجز الدولة العثمانية عن حماية الحواضر.
وفي عام 1842 قاد إسماعيل نحو ألف وخمسمئة من الدروز وحلفائهم من القبائل العربية، ونزل إلى لبنان بهدف الإفراج عن زعماء الدروز الذين اعتقلهم متصرف الجبل العثماني في جبل لبنان، كما أعاد الكرة عام ١٨٦٠ بناء على طلب صديقه سعيد جنبلاط، فأنجد دروز لبنان في مواجهة فرنسا، ومشروع المارونية السياسية لطرد الدروز من لبنان، في الوقت الذي كان فيه مسيحيو حوران في حماية الدروز لم يمسّهم أذى.
ومما زاد مكانته اشتراكه في حرب اللجاة كقائد في قوات للخيالة ١٨٣٧ و ١٨٣٨، وحرب الساري عسكر ضد القوات العثمانية عام ١٨٥٢، حيث كانت القريا مركز انطلاق قوات الدروز الثائرة، وهو الذي كان يدير عملياتها الحربية، وقد وصفه الرحالة البريطاني بورتر، بأنه أشجع رجل في شعب شجاع، (راجع تاريخ الموحدين السياسي في المشرق العربي للدكتورين عباس أبو صالح، وسامي مكارم)، ص ٢٩١ وبورتر ص ١٩١.
وعقد إسماعيل صداقة مع فيصل الشعلان أمير قبيلة الرولا، وهي من كبريات القبائل العربية، ومع قبائل السردية، وبني صخر في بوادي شمال شبه جزيرة العرب، ومع قبيلة السلوط في اللجاة، وبرز كأقوى منافس لشيخ مشايخ الدروز، وأكد الحمدان في مقره السويداء.
انتزاع السويداء من آل حمدان
كل هذا النشاط أقلق العثمانيين، فعمل والي الشام العثماني بالتعاون مع قائمقام بصرى، فدبروا له مكيدة ودسوا له السم في القهوة على إثر زيارته لبصرى، وقيل إن ذلك تم بالتواطؤ مع الشيخ الحمداني عام ١٨٦٩، كان إسماعيل قد انتزع قرية عرى الغنية من آل الحمدان قبل وفاته، فدُفن فيها كما كان قد وزّع أولاده وأبناء عمه شيوخاً على قرى المقرن القبلي من الجبل، وأوصى ابنه إبراهيم أن ينتزع السويداء من آل الحمدان الذين عجزوا عن التنسيق مع مستجدات الأحداث في الجبل، بخلاف الحنكة السياسية التي تمتّع بها إسماعيل وخلفاؤه من بعده.
وهذا الذي حصل، إذ دخلها بدعم أقربائه، وأبرزهم آل العبدالله والمعاز، وبشرط أهل السويداء، بأن يحل على ملكية آل الحمدان ولا يتعداها.
من الراجح أن إزاحة الحمدانيين من السويداء، تمت نحو عام ١٨٧٤، وأن العثمانيين سلّموا بذلك بحكم الأمر الواقع، وهم الذين كانوا قد اعترفوا لوالده إسماعيل، بأن يكون مديراً لجبل الدروز، ولكنهم تراجعوا عن ذلك عام ١٨٦٩، قبيل وفاته في العام ذاته، (راجع انتفاضات جبل الدروز بريجيت شيبلر ص ٩٨).
على إثر دخوله السويداء، أصبح إبراهيم بن إسماعيل الأطرش الشيخ الأول في الجبل وقائمقام سنة ١٨٨٢، وفي تلك الفترة ظهر خلاف الأخوين إبراهيم الموالي للعثمانيين، وشبلي “يتبع الخط الاستقلالي”، (شيبلر ص ١٠٦)، وقدم إبراهيم تنازلات للعثمانيين، منها السماح ببناء قلعة في المزرعة، وقلعة قرب عرى، وهذا أغاظ أخاه شبلي الذي أخذ يعمل ضده متهماً إياه بالعثمنة.
تقول شيبلر ص ١٠٩: “تمثلت في شبلي فضائل الدروز الذكورية، مثل الشجاعة والفروسية”، وعلى العموم كان شبلي يمثل اتجاهاً استقلالياً معادياً للعثمانيين.
كان إبراهيم خشناً في علاقته بالعامة، وقد قرر طرد آل المعاز، أقربائه من السويداء، لكن أهل السويداء وقفوا ضده، وقالوا له هؤلاء أبناء عمك، وقد ناصروك على آل الحمدان، ولا يحق لك ترحيلهم، وهذا ثبّت آل المعاز في السويداء، رغم ميولهم إلى العامية. وقد اقتتل رجال شبلي ورجال إبراهيم. جرح إبراهيم على إثر ذلك ومات بسببه.
شبلي الأطرش: اعتقال وحكم إعدام وعفو وتكريم
اعتقل العثمانيون شبلي في قرية شقا، ولكن الدروز ثاروا وحاصروا قلعة المزرعة، وقتلوا عشرة عثمانيين، وتمكنوا من تحريره من الاعتقال، وبسبب موقعه الاجتماعي سُمّي القائمقام عام ١٨٩٤.
ولكن العثمانيين الساعين إلى فرض سيطرتهم المطلقة على الجبل، أعدوا حملة من ثلاثين ألف رجل بقيادة أدهم باشا، وفتوى من (العلماء) في دمشق، أجازت قتال ونهب ممتلكات الدروز، وفي دمشق عُلّقت المشاعل ابتهاجاً بالحدث، وسيق شبلي والمئات من وجهاء الدروز عبر شوارع دمشق، وأهينوا من قبل عامة المدينة بفظاظة، وتم نفيهم في ما بعد إلى الأناضول، وجزر بحر إيجة.
تفاقمت نقمة الدروز ضد العثمانيين، وحاصروا قلعة السويداء، وكان المشير ممدوح باشا محاصراً فيها على رأس ٢٥٠٠٠ رجل، يحاصرهم عشرة آلاف درزي مسلح، وقد حصلت معارك دامية شتاء ١٨٩٥، وقد دفع هذا القنصل البريطاني لتوجيه نداء يدعو فيه الدول لتدخل إنساني.
وفي دمشق عمّت شائعات أن الدروز على أبواب دمشق، فعم الهلع، وقام الوالي بتوزيع السلاح لحراسة مداخل المدينة. كان قتال الدروز قتال المحافظة على البقاء، وقد قتلت ٣٠ سيدة في المواجهات الحربية، وبعد توسط من الأمير اللبناني الدرزي مصطفى أرسلان، وافق الباب العالي على تشكيل لجنة تحقيق في شكاوى الدروز، ولم يقبل التقاء هذه اللجنة سوى عشرة شيوخ من بني الأطرش، أما الآخرون الشباب، فقد تواروا بعيداً مع أسلحتهم، بينما سيق المئات من الرجال والنساء والأطفال إلى المنافي.
في عام ١٩٠٠ صدر عفو عام، واستقبل شبلي الأطرش وشبلي عزام وحسين جربوع ومحمد نصار في القصر السلطاني.
شبلي الأطرش استقبله السلطان أكثر من ساعة بمبادرة تكريم، وبقي طوال ثلاث سنوات قبل وفاته ينال راتباً شهرياً قدره ٣٠ ليرة، كما سُمح له أن يتصل بالسلطان بالتلغراف مباشرة، إذا ما لمس سوء معاملة من مسؤولين عثمانيين.
يحيى الأطرش: من رودوس إلى مصر وسوريا
بعد وفاة شبلي عام ١٩٠٥، تولى مشيخة مشايخ الدروز أخوه يحيى، وعلى إثر خلافات محلية على حقوق العرب بين القريا وبصرى، واعتداء رجال من بصرى على مسافرين دروز، وما تبع ذلك من ثارات، ادعى زوراً على إثرها سعد الدين المقداد مبعوث بصرى إلى مجلس النواب العثماني في إسطنبول طالباً حماية أعراض النساء، وحماية الدين وحماية المستضعفين، وإنه يجب إرسال حملة تأديب ضد الدروز”، وكان رجال تركيا الفتاة الذين خلعوا عبد الحميد مهتمين بوجود قوة كبيرة في سورية، فتوافقوا مع أهداف سعد الدين، وتعاطف معهم محمد كرد علي صاحب صحيفة (المقتبس) بمقالات دينية تكفر الدروز، ولم تفلح الوساطات، ولتجنب الحرب سلم الشيخ يحيى الأطرش نفسه إلى سامي باشا، ولكن القائد العثماني اعتبره معتقلاً، فتأزمت المواجهات، وكانت أصعب المعارك قرب قنوات، وتم جمع الأسلحة.
كان الأمان الكاذب الذي أعلنه سامي باشا خدعة كبيرة، وجمعت أسلحة حمولة ثمانين جملاً، وسُيّرت قافلة نصر عبر شوارع دمشق، ونُهبت ممتلكات الدروز، وأكثر من ألف رأس من أبقار حراثة الأرض انتقاماً، وسيق أكثر من ألف وثلائمئة شاب للتجنيد والقتال في جبهات الحرب في البلقان، وحُكم بالإعدام على عدد من زعماء الدروز، بينهم ذوقان الأطرش والد سلطان، ومزيد عامر، ويحيى عامر، وحمد المغوش، وهزاع الحلبي، ومحمد القلعاني، وقفطان عزام، وسيق يحيى الأطرش إلى المنفى في رودس.
إزاء عنف حملة سامي باشا المكونة من ٣٠٠٠٠ ألف جندي على الجبل، بدأت تستيقظ ضمائر المثقفين العرب، وأخذوا يبتعدون عن حركة تركيا الفتاة، كما أخذ بعضهم ينظرون إلى الدروز كثوار ضد التكبر التركي أو الحكم العثماني ككل.
أمّا يحيى الأطرش المنفي في رودس، فقد تحرر من السجن بعد أن احتل الطليان جزيرة رودس عام ١٩١٢، وسافر إلى مصر ولم يُسلّم للعثمانيين، وعاد بعدها إلى سورية بعد صدور عفو عنه، وتوفي عام ١٩١٤، وكان حينها مطلوباً للمحاكمة من قبل جمال باشا، الذي أرسل قوة لجلبه إلى دمشق، وصدف وصول القوة إلى مقره في قرية عرى يوم وفاته.
زعامة سلطان باشا الأطرش
عاد سلطان من الجندية عام ١٩١٢، فوجد أن العثمانيين قد أعدموا والده، وأن أهل بصرى قد استولوا على ستة آلاف دونم من أراضي القريا، بتأثير حملة سامي باشا على الجبل، وفي السعي لاسترداد الأرض حصل اشتباك وإطلاق رصاص من قبل سلطان على مدير ناحية خربا، ومعه أربعة عشر خيّالاً من الدرك العثماني، فاعتصم سلطان في خربة حزحز المجاورة، وتدخل على إثر ذلك رشيد طليع متصرف درعا مع الوالي العثماني في دمشق، والأمير علي عبد القادر الجزائري، والشيخ حسين طربيه، وتمت التسوية مع وجهاء بصرى وأعيدت الأرض للقريا.
كما كانت الحملات العثمانية المتتابعة على الجبل، وإعدامات سامي باشا قد خلقت حالة من الكراهية للعثمانيين لا رجعة عنها، ومنذ عام ١٩١٤ أخذت الاتصالات السرية سبيلها من قبل شخصيات دمشقية معروفة، منهم نسيب وفوزي البكري وغيرهم مع سلطان الأطرش، وحسين الأطرش شيخ قرية عنز، ومع شخصيات ذات تأثير في دار السويداء، وقدم شيوخ الجبل مكاناً آمناً لآلاف الجائعين والفارين من الجيش العثماني، وتقدمت القضية العربية خاصة بعد ظهور النوايا العنصرية لجماعة الاتحاد والترقي العنصرية الطورانية النزعة.
تعاون سلطان باشا مع العروبيين السنّة الذين انشقوا عن الدولة العثمانية، ومع الهاشميين على أمل الوصول إلى دولة عربية لا يحكمها الأعاجم، طالما حلم به الدروز المضطهدون تاريخياً من الأتراك السلاجقة، والأيوبيين، والمماليك والعثمانيين. وعند نشوب الثورة العربية، “مشى سلطان برجاله، يده اليمنى حمد بك البربور لافتتاح بصرى أسكي شام”، (راجع د. حسن أمين البعيني، سلطان باشا الأطرش والثورة السورية الكبرى ص ٧٥)، وبعدها وصل إلى بلدة الشيخ مسكين، وتعقّب بقوات الثورة فلول الجيش العثماني المنهزم باتجاه الكسوة، حيث خط الدفاع العثماني الحصين، هناك هربت جمال وخيول الجيش العربي الذي يقوده الشريف ناصر، ونوري الشعلان أمير قبيلة الرولا، لكن مجاهدي الجبل الذين يقودهم سلطان التفوا على مواقع الأتراك، وأبطلوا عمل مدفعيتهم، وقاتلوهم بالسلاح الأبيض وأسروا القائد العثماني رضا باشا الركابي وأسروا ٨٠٠ أسير، بينهم ضباط المان ونمساويون، وكسبوا مدافع ورشاشات، ودخلوا دمشق متحدّين إرادة الجنرال البريطاني اللنبي، الذي كان يرغب بالدخول إلى عاصمة الأمويين أولاً ليظهر كمحرر للعرب، وهذا ما دعا لورنس رجل الاستخبارات البريطاني المرافق لفيصل، وعودة أبو تايه، أن يكتب: “إن الدور الذي لعبه الدروز كان خسيساً”، (شيبلر ص ١٧٠).
بعد تحرير دمشق اعتذر سلطان عن قبول أي منصب حكومي، لكنه بقي مستشاراً للملك فيصل، وتم طي الخلاف بين الأطارشة الذين كانوا موالين لتركيا والمعارضين لها، وعُيّن سليم الأطرش شيخ عِرى متصرفاً على الجبل، ونسيب الأطرش شيخ صلخد عضواً في مجلس الشورى، وقرّب فيصل عبد الغفار شيخ السويداء، وخصص له مرتباً شهرياً، قدره ٣٠ جنيهاً ذهباً، وعاد سلطان باشا إلى القريا زاهداً بمناصب الدولة.
وعندما زحف غورو إلى دمشق عام ١٩٢٠، انطلق سلطان باشا بحملة من الدروز، وصلت إلى مشارف بصر الحرير، عندها جاء من يبلغه إن المعركة انتهت، وإن غورو دخل دمشق، وإن فيصل خرج من العاصمة باتجاه فلسطين، فأرسل ثلاثة من أعيان رجاله، هم حمد البربور، وصياح الأطرش، وفرحان العبد الله لإقناع فيصل باللجوء إلى السويداء، ومنها تُعلَن الثورة على الفرنسيين، وقابلوه في ميناء حيفا، لكن فيصلاً رفض العرض ومضى باتجاه أوروبا.
في ذلك العام، وفد إلى السويداء قادة حزب الاستقلال العربي رشيد طليع، وعبد الرحمن الشهبندر، ونزيه المؤيد العظم وآخرون، وأقاموا فترة في بيت المجاهد علي عبيد، واجتمعوا مع سلطان وزعماء من الجبل، وأقسموا على التحضير للثورة، فقامت فرنسا بالتهديد بضرب السويداء بالطيران، وقد انتقل الضيوف بعدها إلى الأردن.
وكان سلطان قد رفض مسألة تقسيم سورية إلى دول طائفية، وفي عام ١٩٢٢ لجأ الثائر أدهم خنجر من جبل عامل جنوب لبنان إلى القريا، وكان متهماً باغتيال الجنرال غورو، ولسوء حظه أن سلطان كان خارج القرية، فاعتقله الفرنسيون ونقلوه من فورهم إلى السويداء، ولما وصل سلطان إلى القريا تابع إلى السويداء مع عدد من الثوار، منهم إخوته علي، ومصطفى وزيد وحمد البربور، وشكيب وهاب وآخرون، ولم تفلح المساعي باسترداد الضيف الدخيل، وكانت فرنسا قد أرسلت ثلاث مصفحات من درعا، لدعم قواتها في السويداء، فاشتبك سلطان معها وقفز من على ظهر فرسه إلى إحداها، بينما اشتبك رجاله مع المصفحتين الأخريين، وكانت النتيجة قتل الضابط بوكسان وثلاثة من السدنة، وأسر أربعة عناصر وتعطيل مصفحة، وأسر الثانية وهروب الثالثة.
وعندها قام الفرنسيون بنقل الثائر أدهم خنجر إلى دمشق، حيث تم إعدامه، أما سلطان وعدد من الثوار فقد لجؤوا إلى الأردن، وقد قام الطيران الحربي بقصف القريا، وحوط، وبكّا، وأم الرمان، والعفينة.
بعد عشرة شهور، صدر عفو فرنسي عن سلطان باشا، واستقبله الأهالي في السويداء بحفاوة كرمز للشرف المهان، وقد علا شأنه، عندما رفض تسلّم ألف ليرة ذهبية، عرضها عليه الكولونيل كاترو تعويضاً عن داره المهدمة قائلاً: “إن داراً تعجز عن حماية ضيفها ليست جديرة أن تظل قائمة”.
هيأت الظروف للثورة في ٢١ تموز عام ١٩٢٥، وفي معركة الكفر بقيادة سلطان باشا، أجهز الثوار على حملة القائد نورمان، وعددها ١٧٢ عنصراً مجهزاً بأحدث أسلحة ذلك العصر، بخلاف أسلحة الثوار من البنادق والسيوف والفؤوس والعصي.
وقد أُبيدت القوة الفرنسية وقائدها نورمان، باستثناء خمسة أو ستة عناصر لجؤوا إلى دار شيخ القرية أسعد مرشد، بينما خسر الثوار أربعة وخمسين شهيداً، بينهم مصطفى أخو سلطان.
دامت المعركة أقل من أربعين دقيقة، وكانت بغالبيتها بالسلاح الأبيض، مما عطّل فعالية الأسلحة الحديثة، وقد احتمى الفرنسيون الموجودون في السويداء بنتيجتها بالقلعة التي حاصرها الثوار، وقد رفض سلطان قطع الماء عنها لوجود النساء والأطفال فيها.
بعد عشرة أيام، أرسل الفرنسيون حملة ضخمة مزودة بالطيران والمدفعية، بقيادة الجنرال ميشو إلى موقع المزرعة، بهدف احتلال السويداء، والانتقام لمعركة الكفر، فأبادها الثوار بقيادة سلطان باشا، وكان الاشتباك وجهاً لوجه قد عطل دور الطيران، والمدفعية والرشاشات، وقد شبهها المجاهد عبد الرحمن الشهبندر بنصر اليرموك، وغنم الثوار في تلك المعركة أسلحة، مكنتهم من متابعة القتال في معارك لاحقة، وخسر الفرنسيون آلافاً من جنودهم وضباطهم.
وفي ١٧ أيلول، كانت معركة المسيفرة التي جرت على أرض سهل حوران، بعيداً عن ساحة الجبل، وكانت مغامرة لم يوافق عليها سلطان باشا للسبب ذاته، وقد خسر فيها الفرنسيون ٩٠٠ قتيل، وتمكن الثوار من خرق الأسلاك الشائكة، والوصول إلى قلب القرية المحصّنة، وخسروا ٤٥٠ شهيداً، لكنهم اضطروا للانسحاب منها بسبب بُعد ميدان القتال عن أرضهم.
ومع هذه المعارك المشرّفة، فقد انخرطت عموم سورية، ومعظم لبنان في معارك الثورة، واكتسبت الثورة طابعاً سورياً عاماً، واعتُبر سلطان باشا الأطرش قائداً عاماً للثورة السورية الكبرى.
سنوات المنفى
في عام ١٩٢٧ تحالفت بريطانيا وفرنسا على خنق الثورة، ومنع وصول إمدادات السلاح والذخيرة التي كان يشتريها الثوار عبر الأردن من فلسطين، ومنعوا وصول التبرعات التي كانت تصل من المغتربين السوريين من المَهاجر، واضطر الثوار السوريون واللبنانيون إلى الانتقال لواحة الأزرق التي كانت من ممتلكات الجبل أصلاً، ومنعت بريطانيا التي تسيطر على الأردن عنهم حتى مياه الشرب، ومات بعض الأطفال من العطش وخيّرتهم بين العودة إلى سورية، أو الانتقال إلى بلد آخر لا حدود له مع سورية، وكان سلطان باشا والثوار قد قرروا عدم العودة إلى سورية مادام العلم الفرنسي مرفوعاً فيها.
وعرض الإنكليز على سلطان باشا التخلي عن الثورة، مقابل راتب مجزٍ مدى الحياة وبيت لائق في القدس، فرفض العرض قائلاً: “نحن قمنا بالثورة من أجل وطننا ولن نقبل بدلاً عن ذلك”.
وبعد وساطة مع السعودية بواسطة المجاهد شكري القوتلي، وافق الملك عبد العزيز آل سعود على استقبال لجوء الثوار إلى وادي السرحان في الصحراء السعودية.
واستمر الثوار في المنفى الصحراوي في ظروف عيش قاسية مدة عشر سنوات، وكانوا ينسقون مع الوطنيين السوريين من معارضي الاحتلال الفرنسي في الداخل السوري، ويعقدون المؤتمرات في الصحراء، إلى أن اضطرت فرنسا بسبب تغير الظروف الدولية إلى الاعتراف باستقلال سورية ولبنان بموجب معاهدة ١٩٣٦، فعاد بعدها سلطان باشا والثوار عام ١٩٣٧، واستُقبلوا في دمشق استقبالاً حافلاً، بعد أن أدرك الجمهور الدمشقي أن أولئك الثوار الدروز ليسوا أشقياء، كما كان ينعتهم العثمانيون، أما سلطان باشا، فعاد إلى بيته ليعمل في أرضه في القريا رافضاً تولي أي منصب حكومي.
نشاط سلطان باشا بعد الجلاء والوحدة والانفصال
قال لهم قولته المشهورة: “نحن صنعنا لكم الاستقلال، أما أنتم فحافظوا عليه”.
وفي عام ١٩٤٥ على إثر قصف الفرنسيين لدمشق في ٢٩ أيار ١٩٤٥، أيد سلطان باشا انقلاب السويداء على الفرنسيين، الذي قام به الأمير حسن الأطرش محافظ السويداء، والشخصيات الوطنية والعسكرية من أهالي الجبل ضد الفرنسيين، وتم نقلهم بدون أذية مع أسرهم إلى دمشق، وهددوا الفرنسيين بحملة من الثوار إلى دمشق إن لم يوقفوا القصف…. وبطرد الفرنسيين من السويداء، تم جلاء الاحتلال عنها قبل جلائهم عن عموم سورية بنحو سنة.
لكن سلطان باشا اضطر في عام ١٩٥٤، إلى أن يعارض جنوح الرئيس أديب الشيشكلي إلى الدكتاتورية، ويتوافق مع زعماء سورية في مؤتمر حمص ضد استبداده، وقد تسبب ذلك بتجريد حملة عسكرية ظالمة على السويداء، ارتُكبت فيها مجازر بحق المواطنين في السويداء، والعديد من قراها بهدف اعتقاله، ولكن سلطان لجأ إلى الأردن، وطلب من الدروز عدم إطلاق النار على الجيش قائلاً: “هؤلاء أبناؤنا”.
ولم يلبث الجيش السوري أن انتفض على الشيشكلي الذي غادر البلاد، ورجع سلطان باشا ومرافقوه إلى سورية، واستُقبلوا استقبالاً شعبياً وعربياً كمحررين من حكم الدكتاتور.
وبرزت الحياة الديمقراطية في سورية فترة أربع سنوات، تنفس فيها الناس الحرية عموماً في ظل تنمية بطيئة لم تصل إلى الريف، ثم جاءت فترة الوحدة ثلاث سنوات ١٩٥٨- ١٩٦١ على آمال عربية وحدوية بزعامة جمال عبد الناصر، لكن إلغاء الأحزاب، وتعطيل الديموقراطية والحياة السياسية، واستبداد عبد الحميد السرّاج، وتسيُّب واستهتار المشير عامر، ومعاداة الغرب للوحدة، ومرور ثلاث سنوات جفاف متتابعة، أفقرت الأرياف السورية، وأبعدت الناس عن السلطة، مما قاد إلى الانفصال عام ١٩٦١، وكان سلطان باشا قد أيد الانفصال، بسبب مظالم عبد الحميد السراج الذي أُطلقت يده في الإقليم الشمالي (سورية)، وكان الضابط فوزي الشعيبي مدير مباحث السويداء قد ارتكب أخطاء فادحة وموبقات، أغضبت سلطان باشا في حينها.
وفي مقابلة لي مع الأستاذ الأزهري ذياب راوند صيف ٢٠٢٢، وهو أحد أبرز قادة الناصريين في السويداء، أكد لي أن السراج كان يعمل سراً لمصلحته ضد دولة الوحدة، ولم يعمّر عهد الانفصال رغم العودة إلى الحياة البرلمانية التي لم يُسمح لها أن تثبت فعاليتها، بسبب تذمر الأرياف السورية المُفقَرة منذ العهد العثماني، بالإضافة إلى تحدي الوجود الإسرائيلي في فلسطين.
منصور سلطان الأطرش
كان انقلاب ٨ آذار ١٩٦٣ رد فعل على مشكلات اجتماعية ووطنية وسياسية مزمنة، وكان معظم صانعيه عسكريين ناصريين، وبعثيين من أبناء الريف، وشغل منصب رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة البعثي منصور سلطان الأطرش، ولكن العسكر البعثي انقلب على الناصريين بمذبحة مشينة في ١٨ تموز ١٩٦٣، ومن ثم استفرد العسكر البعثي بالسلطة، وأخذ حزب البعث يتصدع، بعد أن برز دور صلاح جديد، وحافظ أسد على إثر انقلاب ٢٣ شباط ١٩٦٦،
وجنحت السلطة باتجاه توريط العلويين المضطهدين تاريخياً بالسلطة، وتم إقصاء قادة البعث المؤسسين وملاحقتهم، وبعد انقلاب ١٦ تشرين الثاني ١٩٧٠ استفرد حافظ أسد بالسلطة، وبطش برفاقة العسكريين والمدنيين، وصنع حزباً بعثياً من المخبرين الأمنيين على مقاسه، وعُطّلت الحياة السياسية تماماً لصالح الدكتاتور، وحصل التصدع السوري المريع، سلطة أمنية قمعية ذات لون طائفي علوي، وشعب ناقم طامح للانتفاضة، يشكل الإخوان المسلمون قوة سياسية أكثر بروزاً في أوساطه؛ لأن الدكتاتور قمع اليسار، فقتل من قتل وسجن آخرين وشرّد من شرد.
وفي مقابلة شخصية لي مع منصور سلطان الأطرش عام ٢٠٠٦ قلت له:
إن مجتمع السويداء بمن فيهم أقاربك عاتبون عليك لانك لا تلعب دورا سياسيا مؤثراً؟! هنا عدل جلسته وقال بحدّة: “ليك ابراهيم؛ حافظ أسد عرض علي أكثر من مرة وزارة؛ لكني اعتذرت… هؤلاء يريدونني بلا قرار؛ وهذا لا يناسبني”.
تهميش آل الأطرش
أما أسرة آل الاطرش، فقد نالها التهميش كسائر مجتمع السويداء، وعمل حافظ أسد على اصطفاء بعضهم ممن لا فعالية سياسية لهم كأعضاء صوريين في مجلس الشعب أو الوزارة، مثل فندي وهلال وعبد الله الأطرش على ماله من فعالية اجتماعية.
ومع نهوض ثورة الكرامة السورية عام ٢٠١١ شاركت السويداء بمسيرة الشموع واعتصام المحامين، وتم قمع السويداء بعنف سلطوي شديد.
ويؤخذ على قادة ثورة ٢٠١١، أنهم لم ينسّقوا مع وطنيي السويداء، كما جرى قبل نحو مئة عام زمن الثورة السورية الكبرى.
لقد كانت محركات تلك الثورة، والعديد من قادتها ذات طبيعة سنية تحمل ريباً وعدم ثقة، بما يكفي تجاه السويداء، مع أن مثقفي السويداء ونخبها شاركوا بنشاط في إعلان دمشق قبل نشوب الثورة.
ومع تعثر مسار ثورة ٢٠١١، ووقوع العديد من قادتها في مطبات الفساد والانحراف، هبّ حراك السويداء السلمي في ١٧ آب ٢٠٢٣، ولم يزل مستمراً منذ عام كامل، وبشكل لا رجعة عنه (طلاق دروز نهائي)، منادياً بتنفيذ القرار الأممي ٢٢٥٤، وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة، والخلاص السوري العام من سلطة الفساد والاستبداد الأسدية الفئوية.
ومن المؤسف غياب مشاركة شخصيات اجتماعية ذات فعالية مميزة من آل الاطرش في انتفاضة السويداء السلمية رغم التأييد الفعال لها من قبل شيخي عقل الطائفة وهما سماحة الرئيس الروحي الشيخ حكمت الهجري وسماحة شيخ العقل حمود الحناوي.
المصادر والمراجع
- (جبل العرب: صفحات من تاريخ الموحدين الدروز ١٦٨٥- ١٩٢٧) تأليف الدكتور حسن أمين البعيني
- (سلطان باشا الأطرش والثورة السورية الكبرى) تأليف الدكتور حسن أمين البعيني.
- (تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق العربي) تأليف الدكتور عباس أبو صالح بالاشتراك مع الدكتور سامي مكارم.
- (بنو معروف في التاريخ) تأليف سعيد الصغير.
- (انتفاضات جبل الدروز- حوران: من العهد العثماني إلى دولة الاستقلال ١٨٥٠-١٩٤٩) دراسة أنثروبولوجية – تاريخية ، تأليف الباحثة الألمانية بريجيت شيبلر.
- (صراع بين الحرية والاستبداد) تأليف فارس قاسم الحناوي.
_________________________________________
من مقالات العدد الرابع عشر من (العربي القديم) الخاص بالأسر السياسية في التاريخ السوري – آب / أغسطس 2024