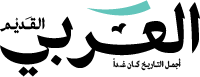دلالات وقضايا | تقسيم العمل والفنِّ والجريمة

د. مهنا بلال الرشيد- العربي القديم
مرَّ ما يقرب من ثلاثة آلاف سنة على نظريَّة المحاكاة الأفلاطونيَّة المنسوبة لفيلسون اليونان أفلاطون (427-347 ق.م)، وما زال تفسير نشأة الفنون البشريَّة على أساس نظريَّة أفلاطون هذه يلقى قبولًا لدى كثير من منظِّري الفنِّ في وقتنا الرَّاهن؛ وذلك لأنَّها واحدة من أقدم نظريَّات التَّأويل الفنِّيِّ إن لم تكن أقدمها على الإطلاق، وبرغم ازدهار فنون القول والكتابة والرَّسم والنَّحت والتَّصوير والعمارة والموسيقا المشرقيَّة في كلٍّ من مصر والعراق وإيبلا قبل أفلاطون بألفي سنة تقريبًا لم يحظ منظِّرو الفنِّ المشرقيِّين بشهرة أفلاطون أو شهرة نظريَّته في المحاكاة على وجه التَّحديد؛ وذلك لقبول المتلقِّي بهذا التَّأويل قياسًا على تجربته الشَّخصيَّة؛ فكلُّ واحد منَّا تعلَّم لغته، واكتسب كثيرًا من مهاراته في الحياة من خلال المحاكاة؛ أي تعلَّم اللُّغة بتقليد أصوات أمِّه وأبيه، وبتقليد سلوك الأبوين اكتسب كثيرًا من المعارف والخبرات من ناحية أولى، ولأنَّ الأضواء من ناحية ثانية لم تُسلَّط بشكل كافٍ على نظريَّات المشرقيِّين الفنِّيَّة حتَّى الآن، أو لأنَّ آراءهم المبثوثة في ألواح الإيبلاويِّين والسُّومريِّين والبابليِّين والآشوريِّين وبرديَّات الفراعنة المصريِّين لم تأخذ حقَّها من الدَّراسة كما أخذته مدوَّنات أفلاطون وتلميذه أرسطو (384-322 ق.م) منذ ذلك الحين حتَّى وقتنا الرَّاهن. ولا نريد الخوض في مَن نظَّر في الفنون أوَّلًا: المشرقيُّون أم الغربيَّون؟ بقدر ما نريد الوقوف على علاقة الإبداع بكلٍّ من الحرِّيَّة والأصالة والمحاكاة والطِّريقة الَّتي يصبح فيها الفنُّ شَرَكًا من أشراك العبوديَّة بدلًا من تحرير الإنسان وتمجيد الحرِّيَّة والقيم الإنسانيَّة النَّبيلة.
ثغرات في نظريَّة المحاكاة
قدَّم أفلاطون تفسيرًا مبدئيًّا مقبولًا في زمنه لتفسير ظهور النَّصِّ الفنِّيِّ على أساس المحاكاة أو التَّقليد؛ لكنَّه-ومن أجل انسجام تفسيره هذا-احتاج إلى نظريَّة المُثُل أو عالم المُثُل، الَّذي يحاكيه الفنَّانون، أو يقلِّدونه، عندما يبدعون، أو يستمدُّون منه موضوعاتهم الفنِّيَّة، وبفكرة عالم المُثُل هذه سدَّ أفلاطون ثغرة من ثغرات تنظيره في الفنِّ وبحثه عن تأويلاته، لكنَّه-وبرغم ذلك-لم يعطِ حرِّيَّة المبدع مع شروط الانسجام بين الموهبة والأصالة والإبداع وفرادة الفكرة ما تستحقُّ يستحقُّه من حديث عنها بجوار المحاكاة، علاوة على اتِّهامه الموهبة البشريَّة ضمنًا بعجزها عن الإبداع الأصيل دون وجود نماذج طبيعيَّة أو مثاليَّة تحاكيها أو تقلِّدها أو تنسج على منوالها. كما أكَّد أفلاطون أنَّ المحاكاة شرط الفنِّ الأوَّل، واعتبر أنَّ تفاوت جمال النُّصوص الفنِّيَّة يرجع إلى تفاوت قدرات أصحابها في محاكاة مواضيعهم الموجودة في عالم المُثُل، وليس إلى نقص الانسجام والتَّناسب بين شروط الفنِّ الأخرى؛ وبهذا الانحياز للمحاكاة يكون أفلاطون قد قسَّم شروط الفنِّ، أو فكَّك وحدتها العضويَّة، واستفاد من بعضها الأوَّل دون بعضها الآخر؛ وبهذا التَّقسيم أفقد المتاجرون بالفنِّ بعد أفلاطون النُّصوص الفنِّيَّة نزعتها الإنسانيَّة، وحوَّلوها من حوامل قيم ومبادئ إنسانيَّة إلى سِلَع تُعرض في الأسواق، وتُباع وتُشترى، وأحيانًا سَلَّع تُجَّار الفنِّ الفنَّان ذاته، وتوجَّه الفنُّ القائم على المحاكاة نحو إشباع غرائز بعض المتلقِّين حينًا، ولبَّى أهواء المتطرِّفين وحاجات السُّوق الخاضعة للعرض والطَّلب تحت شعار: (الجمهور عاوز كده) أحيانًا أخرى؛ وبهذه الطَّريقة نافست النُّصوص التِّجاريَّة بوصفها عملًا فنِّيَّا رديئًا نصوص الفنِّ الشَّامخة بوصفها عملات أصيلة، وطردتها؛ لأنَّ أصحاب الفنِّ التِّجاريِّ الرَّخيص وجنودهم من العبيد الرَّاضين بالتَّسليع مقابل الأموال تقدُّموا على رُسل الفنَّ الأصيل وأحراره من أصحاب المبادئ؛ فقدَّموا منتجًا رخيصًا من حيث التَّكلفة المادِّيَّة والخلوِّ من القيم الإنسانيَّة النَّبيلة، وينهض هذا النَّوع من الأعمال في غالب الأحيان على العُري أو السَّخافة والتَّفاهة بدعوى أنَّ هذه الأفكار المطروحة مواضيع اجتماعيَّة راهنة.
تقسيم العمل والفنِّ والجريمة
تمكَّن أصحاب الفنِّ التِّجاريِّ السَّخيف أو الهابط من تسليع الفنِّ بسبب ثغرة تقسيم وحدة الفنِّ العضويَّة أو تقسيم شروط الفنِّ وتغليب بعضها مثل المحاكاة على حساب بعضها الآخر مثل حرِّيَّة الفنَّان وأصالة الفكرة وإبداعيَّة معالجتها. وتشبه فكرةُ تقسيم شروط الفنِّ في مقالنا هذا فكرةَ تقسيم العمل عند كارل ماركس (1818-1883.م)، وقد أدَّت بعض تطبيقات فكرة تقسيم العمل الماركسيَّة إلى سيطرة الرَّأسماليَّة سيطرة فظَّة على سوق العمل والإنتاج والعلاقات الاجتماعيَّة ذاتها، وغيِّبت الجانب الإنسانيَّ بعدما حوَّلت معظم العلاقات الاجتماعيَّة من علاقات قيم ومبادئ إلى علاقات نفعيَّة بين العمَّال وأصحاب المعامل ورؤوس الأموال، وإن أنتج تقسيم العمل عبوديَّة وعلاقات اجتماعيَّة آنيَّة قائمة على المصلحة أو تبادل المصالح فإنَّ تقسيم الفنِّ أنتج عبوديَّة ثقافيَّة طويلة الأمد؛ تصبح فيها النُّصوص التِّجاريَّة الرَّخيصة مع مرور الأيَّام واقعًا يصعب تخطِّه أو تجاوزه؛ ولهذا يشبه تاريخ الفنُّ سلسلة رياضيَّة يقود أيُّ خلل في مرحلة من مراحلها إلى أخطاء فادحة في المستقبل؛ ومن هنا يجب الحرص على تاريخ الفنِّ في مراحله كلِّها، لا سيَّما المرحلة الرَّاهنة، ويجب حمايتها من تسلُّق الانتهازيِّين والنَّفعيِّيين وأصحاب الفنِّ التِّجاريِّ الهابط من الأذناب والأذيال، وفي هذه المرحلة الحسَّاسة من تاريخ سوريا بعد تحريرها من عصابة المجرم المخلوع بشَّار الأسد يجب المحافظة على أصالة الفنِّ والثَّقافة وحماية الموهوبين المبدعين والأحرار المتمرِّدين على الظُّلم من أصحاب الفنِّ الأصيل، ولا بدَّ من إبعاد أذناب المرحلة السَّابقة وذيولها ورؤوسها؛ فقادة المرحلة السَّابقة متسلِّقون بلا أخلاق أو مبادئ، وذيولها وأذنابها عبيد خانعون، وكلُّهم فاسدون ومفسدون.
ولكي يُحْكِم المستبدُّون سيطرتهم على المجتمع وسوق العمل، ويتحكَّموا بأشكال العلاقات الاجتماعيَّة ذاتها، ويحوِّلوها إلى ما يشبه عبوديَّة العامل الفقير لدى صاحب رأس المال والعمل طبَّقوا فكرة تقسيم العمل على كلٍّ من الفنِّ والجريمة برغم الاختلاف الكبير بين الفنِّ والجريمة؛ فقسَّموا شروط الفنِّ، ثمَّ قسَّموا أدوات الجريمة ومراحلها، وحوَّلوا الفنِّ إلى أداة لتشويه الحقيقة والتَّستُّر على الجريمة، ومثالًا على ذلك؛ يقول بعض المكوِّعين السُّوريِّين في وقتنا الرَّاهن: إنَّه كان مجنَّدٌ إجباريٌّ عند المجرم المخلوع بشَّار الأسد، وإنَّه لم يقتل أيَّ مواطن سوريٍّ؛ لأنَّه كان يعمل في معمل لصناعة البارود والبراميل المتفجِّرة بعيدًا عن المدينة، ويقول الآخر: إنَّه كان مذخِّرًا لكنَّه لم يطلق الرَّصاص أو لم يلقِ البراميل، ويرى الطِّيَّار أنَّه غير مسؤول عن القتل؛ لأنَّه كان يقود المروحيَّة، ولم يلقِ بيديه أيَّ برميل أو قذيفة، ويأتي الأستاذ الجامعيُّ الشَّبِّيح؛ ليتحدَّث أمام طلَّابه في الجامعة كلَّ مرَّة عن ضرورة الحفاظ على وحدة الوطن والخوف منآلات الثَّورة والحفاظ على هويَّة الوطن وحمايتها وحماية النِّظام من الثُّوَّار (الإرهابيِّين) بحسب وصفه قبل التَّكويع، ثمَّ يأتي عمل دراميٌّ يقول الممثِّل فيه: إنَّ قوَّات المجرم المخلوع بشَّار الأسد طهَّرت مدينة مثل حلب من الإرهاب وجعلتها آمنة أخيرًا وبلا قذائف، وتهدف جوقة المجرمين الَّذين تقاسموا هذه الأدوار، وقسَّموا العمل والفنَّ والجريمة بهذه الطِّريقة إلى التَّنصُّل من تبعات جرائمهم؛ ليضيع دم السُّوريِّين الأبرياء بين هذه القبائل من قطعان الشَّبِّيحة والصَّامتين والمكوِّعين والمنظِّرين البعثيِّين.
فنون أصيلة للأحرار ونصوص تجاريَّة للعبيد
غلَّب أفلاطون شرط المحاكاة على غيره من شروط الفنِّ الأخرى، وربَّما لم يعطِ شرطَ حرِّيَّة الفنَّان المطلقة المحروسة برقابة واجبه الأخلاقيِّ حقَّها من الحديث؛ لأنَّه كان يعدُّها من بديهات الفنِّ قديمًا بخلاف ما عليه واقعنا المأساويُّ في وقتنا الرَّاهن. وكذلك لم يركِّز أفلاطون على شرط المحافظة على نِسب متوازنة من شروط الفنِّ الأخرى في بنية أيِّ نصٍّ فنِّيٍّ؛ ومن هنا استغلَّ المتسلِّقون هذه الثَّغرة في تنظير أفلاطون في العصور اللَّاحقة؛ فأنتجوا نصوصًا فنِّيَّة مشوَّهة؛ تعتني بشرط المحاكاة دون غيره؛ وكلُّ نصٍّ ينحاز لشرط المحاكاة بالمطلق دون تحقيق التَّوازن والانسجام بين شروط الفنِّ الأخرى يصبح تقليدًا أعمى، أو تكرارًا ممجوجًا، وما أكثر النُّصوص الشِّعريَّة، الَّتي تقلِّد النُّصوص الشَّامخة، أو يحاول أصحابها النَّسجَ على منوالها دون أن تلامس مشاعر الأحرار! وعندما تنجح أغنية، أو يتميِّز عمل دراميٌّ تكثر النُّصوص الَّتي تقلِّده، أو تتَّكئ عليه، أو تجترَّ شهرته في وقتنا الرَّاهن؛ فيتخلَّى المقلِّد عن الحرِّيَّة والأصالة والابتكار والفرادة، ويقع في شَرَكِ التِّكرار والتَّقليد من أجل الشَّهرة أو المكاسب المادِّيَّة، وفي غالب الأحيان يرتفع الكسب المادِّيِّ لدى بعض نجوم الشُّبَّاك بمقدار ما يتخلَّى هذا أو تلك عن الحرِّيَّة والأصالة من أجل الكسب المادِّيُّ المقرون بتمرير رسائل العبوديَّة الرَّديئة لدى أصحاب الفنِّ التِّجاريِّ الهابط، وبهذه الطِّريقة يُسلَّع الفنُّ وبعض الفنَّانين والفنَّانات، وتفقد نصوص الفنِّ التِّجاريِّ رسالتها وقيمتها، وفي غالب الأحيان يبحث المستبدُّون-مثل ماهر الأسد سابقًا-عن أصدقاء فنَّانين من أصحاب هذا الاستعداد للتَّخلِّي عن شروط الفنِّ الأصيل أو للتَّهريج تحت عنوان الكوميديا مقابل الكسب المادِّيِّ؛ فتصبح نصوصهم وأدوارهم رسائل وأدوات لتكريس العبوديَّة وشركًا من أشراكها أيضًا.
هل تصبح الرَّداءة تراثًا؟
يهتمُّ المقلِّدون بالكسب المادِّيِّ أوَّلًا وبالشُّهرة وإن كانت شهرة زائفة بسبب مناصرة المستبدِّ ثانيًا أكثر من اهتمامهم بالتَّمرُّد الإبداعيِّ على سلبيَّات الواقع لتطهيرها بطريقة إظهار مصير الفساد المأساويِّ أو التَّراجيديِّ أو بطريقة السُّخرية الكوميديَّة من العيوب الاجتماعيَّة للتَّتفير منها؛ ولهذا السَّبب يتَّجه الفنُّ نحو الرَّداءة، وكلَّما كثرت النُّصوص الرَّديئة كرِّست نفسها، وشجَّعت الآخرين على استسهال الفنِّ التِّجاريِّ بقليدها أو الإنتاج على منوالها؛ وبذلك يسهل على غير الموهوبين أو غير الفريدين مثل نجدت أنزور أن يقتحموا عوالم الفنِّ؛ وبرغم نجاح أصحاب هذه النُّصوص في مهمَّة تضييع وقت المتلقِّي؛ إلَّا أنَّ هذه النُّصوص لا تصبح تراثًا، ولا يمكن لها أن تغدو تراثًا؛ لأنَّها تُنسى بعد تلقِّيها الأوَّل دون أن تترك في المتلقِّي أيَّ أثر إيجابيٍّ. ترتبط الموهبة بالحرِّيَّة والتَّمرُّد والأصالة ارتباطًا وثيقًا؛ ولهذا يفضِّل الفنَّان الموهوب الأصيل المتمرِّد الانزواء في عالم إبداعه الخاصِّ، ويفضِّل الابتعاد عن الأضواء إذا ما طلب منه المستبدِّون سدَّ الفراغ أو تقديم بعض الرُّؤى والأفكار والآراء والتَّصوُّرات، الَّتي لا يؤمن بها، ويدرك تمامًا أنَّ الأثر الإيجابيَّ لا يصنعه أحدٌ غير الموهوبين. في حين يفضِّل أنصاف الموهوبين والأذيال والأذناب والمقلِّدون الظُّهور ومزاحمة المبدع الحقيقيِّ-برغم افتقارهم إلى أدوات المنافسة الشَّريفة-مقابل الفُتات المنثور على موائد المستبدِّين، ويتخلُّون عن شرط الحرِّيَّة، وهم بالأحرى لا يملكون هذه الحرِّيَّة، أو لا يعرفونها؛ لأنَّ درجة الحرِّيَّة في أيِّ نصٍّ متميِّز تتناسب طردًا مع درجة موهبة صاحبه ومع أصالة فكرته أيضًا.
عودة إلى المحاكاة ونماذج من مخاطر تقسيم الفنِّ
يمكن للوحات الرَّسم والتَّشكيل والنَّحت المتميِّزة والأبنية المعماريَّة الجميلة أن تحاكي نماذج موجودة قبلها في الطَّبيعة أو في عالم المُثُل أو في أذهان مبدعيها؛ لكن أين هي النَّماذج الفنِّيَّة البدئيَّة أو الأوَّليَّة-بحسب نورثروب فراي (1912-1991.م)-الَّتي قلَّدها أصحاب الفنون القوليَّة؛ فلا قصائد جاهليَّة شامخة قبل المعلَّقات لدى العرب الجاهليِّين؟ وأين هي النَّماذج الفنِّيَّة البِدئيَّة أو الأوَّليَّة، الَّتي قلَّدها بيتهوفن (1770-1827.) أو اطَّلع عليها قبل إبداع سيمفونيَّاته؟ وإن كانت هذه النَّماذج موجودة في الطَّبيعة حقًّا، وإن اقتصر عمل الفنَّان المبدع على محاكاتها أو تقليدها فهذا دليل على قصور الإبداع البشريِّ وتراجُعِ شروط الأصالة والحرِّيَّة والتَّمرُّد والإبداع والابتكار والتَّجديد على حساب شرط المحاكاة أو التَّقليد؛ ناهيك عن أضرار المحاكاة ذاتها؛ تلك الَّتي لم تُفرِغ نصوص الفنِّ المعاصرة من أصالتها وألَقِها وفرادة شكلها ومضمونها، ولم تُسقطها في حيِّز التَّقليد والتِّكرار الممجوج وحسب، بل جعلت الفنون شَرَكًا من أشراك العبوديَّة، ووضعت بين نخبة الفنَّانين الأحرار الأصلاء الموهوبين المتمرِّدين مجموعات كبيرة من المقلِّدين، وصار هؤلاء (الفنَّانون) من المقلِّدين وأنصاف الموهوبين أدوات المستبدِّين؛ ونظرًا لتراجع شروط الفنِّ الأخرى أمام شرط المحاكاة؛ كتراجع الحرِّية والفرادة والأصالة والابتكار والإبداع والتَّجديد والتَّمرُّد والحساسيَّة العالية في نقد الواقع المتردِّي والتَّمرُّد عليه بتقزيمه أو بهجائه أو السُّخريَّة الفنِّيَّة منه كرَّس بعض الفنَّانين وبعض الفنون المعاصرة العبوديَّة، وسوَّغ هؤلاء الخنوعَ للمستبدِّ بدلًا من محاربة الطُّغيان ومواجهة الاستبداد والعبوديَّة بالفنِّ؛ فصار فنُّ الخطابة ردحًا؛ وصار خطيب الجمعة في زمن المجرم حافظ الأسد وابنه المجرم المخلوع بشَّار الأسد مطبِّلًا ردَّاحًا مدَّاحًا؛ وقد فعل فنُّ الخطابة أفعاله المشرِّفة في عصورنا الذَّهبيَّة؛ كخُطب سحبان بن وائل وقسِّ بن ساعدة الإياديِّ وخطبة أبي بكر الصِّدِّيق-رضي الله عنه-بعد وفاة الرَّسول الكريم محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم.
ولم تكتسح هذه التَّحوُّلات المبنيَّة على أساس من تقسيم الفنِّ خطب المشاهير من خطباء المنابر المعاصرين وحسب، بل أخذ الرَّدح والمدح مساحة لا بأس بها من إبداع شاعر متميِّز مثل محمَّد مهدي الجواهريِّ (1899-1997.م)؛ الَّذي سقط في مدح طاغية مجرم مثل حافظ الأسد ظنًّا منه أنَّ الأخلاق والمبادئ تتجزَّأ وأنَّ قوانين الفنَّ مثل العمل تتقسَّم؛ فقال الجواهريُّ في مديح طاغية مثل المجرم حافظ الأسد:
سلامًا أيُّها الأسد ! سلمتَ ويسلم البلدُ
وتسلم أمَّة فخرت بأنَّك فخر من تلد
وليت الجواهريَّ اكتفى بالمحاكاة ذاتها بدلًا من أن يتحوَّل إلى ردَّاح ومدَّاح يتخلَّى عن تمرُّده وحرِّيَّته وأصالة إبداعه في نصوصه لصالح مديح طاغية من الطُّغاة! أي ليته قلَّد سلفه زهير بن أبي سُلمى حين فنَّد واقع الحرب المرير! ليته تمرَّد على واقعه كما فعل زهير بن أبي سُملى حين تعالى على ميوله الشَّخصيَّة لواحدة من قبيلتي: عبس أو ذبيان، ورفض الحرب بعيدًا عم موقفه الطَّائفيِّ أو العشائريِّ؛ فقال في نقد الحرب:
متى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتضرَ إذا ضرِّيتموها فتضرمِ
فتعركُّمُ عرْكَ الرَّحى بثفالها وتلقح كشافًا ثمَّ تحمل فتتئمِ
فتُنتج لكم غلمانَ أشأمَ كلُّهمُ كأحمر عادٍ ثمَّ ترضع فتفطمِ
فتغلِل لكم ما لا تغلُّ لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم
وليتنا-صديق القارئ-أنا وأنت وفنَّانينا وكتَّابنا وشعراءنا المعاصرين نتعلَّم من التَّاريخ! ليتنا نحذر من بعض التَّطبيقات السَّلبيَّة لمخاطر تقسيم العمل وتقسم الفنِّ وتقسيم الجريمة وجملة ما أشرنا إليه في هذا المقال!